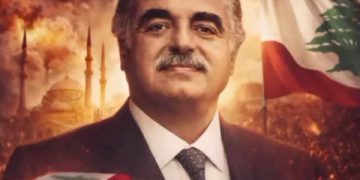المقدمة بقلم رئيس التحرير
في عالم الأدب والثقافة، تبرز شخصيات تظل علامة فارقة في مسارها الإبداعي، وواحدة من هؤلاء الشخصيات التي استحقت أن تبرز في ساحة الأدب اللبناني والعربي هي الدكتورة ليندا حجازي. فبجانب مسيرتها الأكاديمية التي نالت فيها درجات علمية عالية، استطاعت أن تترك بصمتها في مجال النقد الأدبي والأدب الرقمي، إضافة إلى إبداعاتها الشخصية التي تتوزع بين الشعر والقصة والبحث. من خلال هذا الحوار، نغوص في عمق تجربة الدكتورة ليندا ونستكشف أفكارها وآراءها حول الأدب والتعليم والإبداع.
وإلى نص الحوار مع الأستاذة ليندا محمد حجازي
بداية، نودّ أن نتعرّف على مسيرتك1•
الأكاديمية والأدبية. كيف كانت البداية في هذا المجال؟
البدايات لا تُروى دائمًا بسهولة، خاصّة حين تكون محاطةً بالأسئلة.
دخلتُ الأدب من باب الحاجة لا الترف، ومن شعورٍ داخلي بأنّ الكلمات أكثر أمانًا من العالم. في الجامعة اللبنانيّة، وجدت نفسي أدرس الأدب العربيّ كي أفهم اللّغة الّتي كوّنتني. ومن هناك، انطلقت الرحلة: من الشعر إلى النقد، ومن الورقة إلى الشاشة، حيث الأدب الرقميّ بات ساحةً جديدة للتعبير.
- ما الذي ألهمك في دراستك للأدب العربي؟ وهل هناك من شخصية أدبية معينة أثرت في مسيرتك؟
الأدب العربيّ ألهمني لأنّه لغة النفس حين تعجز عن الكلام، وهو ذاكرة الشعوب وهمس الأمكنة. لا أستطيع أن أختصر الإلهام في شخص واحد، لكن السيّاب في غربته، والمتنبي في شموخه، ومحمود درويش في تناقضه، كلّهم مرّوا بي في لحظة من اللّحظات وتركوا أثرًا.
في كلّ محطة من رحلتي، كان هناك من فتح لي نافذة على الأدب من زاوية مختلفة: الدكتور ميخائيل مسعود جعلني أعي جمال الانتماء إلى الأرض والريف، وغرس فيّ حسًّا رومانسيًّا خاصًّا بالهوية والحنين. الدكتور جوزف لبّس علّمني كيف أرى النصّ كائنًا حيًّا، كيف أُمسكه بالمنهج وأتتبّعه بالفكر، وهو من منحني أدواتي النقديّة الأولى. أمّا الدكتور حمد حاجي، فكان اكتشافي له بمثابة تحدٍّ نقديّ وإنسانيّ، تعلّمت من خلال شعره كيف يُكتب الألم جمالًا، وكيف تُقرأ القصيدة بعيون القلب والعقل معًا.
لهؤلاء جميعًا أفضال لا تُنسى، لكنني اخترت أن أمشي بعدهم بطريقتي، ولست ظلًّا لأحد. - لقد تخصصت في العديد من الأبحاث الأكاديمية في مجال الأدب الرقمي، ما هو التحدي الأكبر الذي واجهته في هذا المجال؟
أصعب ما في الأدب الرقميّ هو إقناع الآخرين بأنّه أدبٌ، وليس هامشًا، أو نقيضًا للأصالة بل امتدادٌ لها. كثيرون يرونه عابرًا أو خفيفًا، بينما هو يحتاج أدوات جديدة ووعيًا مزدوجًا: أدبيّ وتقنيّ. - كيف ترين دور الأدب الرقمي في إثراء المحتوى العربي وتوسيع آفاق المعرفة؟
الأدب الرقميّ هو الوسيلة الأذكى لمقاومة التهميش الثقافيّ في عصر الصورة والسرعة. إنه يوسّع حدود الأدب خارج الجغرافيا والطبقات، ويمنح الهوامش فرصة الكلام. - كيف يتمكن الأدب الرقميّ من الحفاظ على هوية الأدب العربي التقليدي في ظل تأثيرات التكنولوجيا الحديثة؟
الهويّة ليست جامدة، بل تتجدّد. الأدب الرقميّ لا يُهدد الهويّة بل يُحدّث أدوات التعبير عنها، شرط أن نُحسن استخدامه ونظلّ أوفياء لروح اللغة. - ما هي رؤيتك لتطور النقد الأدبي في السنوات الأخيرة؟ وهل تعتقدين أنه أضحى أكثر تخصصًا في العصر الحديث؟
النقد الأدبيّ اليوم يشهد نوعًا من التشظّي والتعدّد، إذ بات يتقاطع مع علوم أخرى كالأنثروبولوجيا والجغرافيا والذكاء الاصطناعيّ. هذا التخصّص منح النقد دقّةً وعمقًا، لكنه في الوقت نفسه أخرجه أحيانًا من دائرة المتلقّي العام، فصار نخبويًّا أكثر ممّا ينبغي. أعتقد أن التحدّي اليوم هو في الحفاظ على هذا التخصّص، من دون التفريط بجماليّة اللّغة وسهولة التوصيل. - هناك كتابات نقدية تناولت مفهوم “الأدب الرقمي”، كيف يمكننا فهم العلاقة بين الأدب التقليدي والعصر الرقمي؟
الأدب الرقميّ ليس نقيضًا للأدب التقليديّ، إنّما هو امتدادٌ له في وسيط مختلف. العلاقة بينهما علاقة تفاعل وتحوّل، لا قطيعة. فما زال النصّ الأدبي يحتفظ بروحه، لكنّ وسائط التلقّي تغيّرت، وأدوات التعبير تطوّرت. نحن الآن أمام نصوص تكتب نفسها عبر الصوت والصورة والحركة، بينما جوهر الأدب ما زال قائمًا: الفكرة، والموقف، واللّغة. - هل تعتقدين أن الكتابة الأدبية قد تأثرت بتطور الذكاء الاصطناعي؟ وهل لهذا التأثير جانبه الإيجابي؟
نعم، تأثّرت من حيث الشّكل والسرعة والانتشار. الذكاء الاصطناعيّ صار أداة مساعدة للكاتب، لكنّه لا يُنتج أدبًا حقيقيًّا لأنّه يفتقد إلى الوعي، والاحساس، والنيّة، والتجربة الإنسانيّة.
الجانب الإيجابي في هذا التطوّر هو أنّه حرّك الأسئلة الكبرى: ما الأدب؟ من الكاتب؟ وماذا يعني الإبداع؟ وهذه الأسئلة وحدها كافية لتجعلنا نكتب بقلق جميل. - في رسالتك للماستر، تناولت موضوع الجغرافيا الأدبية. كيف ترين تأثير المكان والزمان على الأدب العربي؟
المكان والزمان ليسا مجرّد إطارين خارجيّين للنص، إنّما هما جزءٌ من نسيجه الداخليّ. في الأدب العربيّ، كثيرًا ما يكون المكان حنينًا، أو منفى، أو ساحة صراع، والزمان ذاكرة أو فجوة أو لحظة مقاومة.
الجغرافيا الأدبية كشفت لي كيف أنّ الأرض تكتب، وأن النصّ أحيانًا ليس إلا صدى لصوتها. - برأيك، هل يجب على الأدب أن يعكس الواقع أم أن له حرية التصور والابتكار في خيالاته؟
الأدب ليس مرآةً للواقع فقط، بل هو نافذة عليه، وأحيانًا يسبقه بخياله. له أن يعكس وأن يتخيّل، أن يصف وأن يبتكر. فالأدب الذي يكتفي بالتوثيق قد يتحوّل إلى سجلّ، أما الأدب الذي يحلّق في الخيال من دون جذر فهو مُعرّض للذوبان. القوة في الجمع بين الاثنين: أن نكتب الواقع كما نشعر به، وليس كما هو فقط. - من خلال عملك مع الطلبة، هل تجدين أن هناك جيلًا جديدًا قادرًا على الإبداع الأدبي بمقاييس جديدة؟
نعم، هناك جيل يكتب من زوايا غير مألوفة، يعبّر بلغته الخاصة، ويكسر الكثير من القوالب الجاهزة. قد لا يلتزمون دائمًا بالشكل الكلاسيكيّ، لكنّهم يحملون شغفًا حقيقيًّا. فالتحدّي هو في احتضان هذه المواهب وتوجيهها دون أن نكسرها.
إنّ الإبداع لا يُقلَّد ولا يُورَّث، إنّما يُكتشف ويُصقل، بالوعي والتجربة.. - في رأيك، ما هي القيم الأدبية التي يجب أن يسعى الأدباء إلى ترسيخها في المجتمعات العربية؟
الصدق الجماليّ، والحريّة المسؤولة، واحترام الاختلاف. نحن بحاجة إلى أدب لا يجمّل القبح ولا يروّج للخيبة، بل يضيء مساحات المسكوت عنه. القيم الأدبيّة ليست شعارات، بل أفعال تُبنى داخل النص وخارجه: في الموقف، في اللّغة، وفي النزاهة مع الذات. - هل تفضلين الكتابة الأدبية على الكتابة النقدية أم أن لكِ مساحة في كل منهما؟
لكلّ منهما طقسه ومزاجه. الكتابة الأدبية تمنحني حرية الحلم، أما النقد فيمنحني يقظة العقل. أكتب حين أتعب من التحليل، وأحلّل حين أفيض عن الكتابة.
في الحالتين، لا أخرج من اللّغة، ولا تنتهي علاقتي بالنص. - كيف تجدين التوازن بين مسؤولياتك كأكاديمية وكتابة الإبداع الأدبي؟
هو توازن دقيق ويوميّ، كأنّني أمشي على حبل مشدود بين العقل والوجدان. الأكاديميّة تسرق الوقت، والإبداع لا يحب العجلة. أحيانًا أترك الورقة لأن تصحيح الأوراق ينتظرني، وأحيانًا أهرب من التصحيح لأكتب جملةً لا تحتمل التأجيل. لكنّني لا أترك الكتابة، حتى وإن كتبتها في قلبي أولًا. - حدثينا عن تجربتك في تدريس اللغة العربية للطلاب، وكيف يمكن تطوير المناهج الدراسية لتواكب العصر؟
تدريس العربيّة يشبه السير في حديقة ذات طبقات: في كلِّ مستوًى نكتشفُ شيئًا جديدًا. أحب أن أقرّب الطلاب من النصوص لليس بوصفها واجبًا، إنّما حياة. أمّا المناهج، فهي بحاجة إلى تحديث عميق لا يقوم فقط على إدخال التكنولوجيا، بل على تغيير نظرتنا إلى اللّغة: أن نعلّمها كونها و سيلة فهم وخلق، وليست خوفاً وعقابًا. - ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأدب العربي في تعزيز الوعي الثقافي والسياسي في العالم العربي؟
الأدب العربيّ هو مرآة شعوبنا وتاريخنا، وهو حامل لآلامنا وآمالنا. يمكن للأدبّ أن يكون نافذة لوعي جماعيّ عميق، يكشف عن واقعنا ويقترح رؤى التغيير. من خلال الأدب، نستطيع إعادة صياغة مفاهيمنا الثقافيّة والسياسيّة، وفتح آفاق جديدة للحوار، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.
في زمن الاستقطاب والتحدّيات، يصبح الأدب مصدرًا مهمًا للفكر النقديّ والمقاومة السلمية. - هل تعتبرين الأدب وسيلة لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن يساهم الأدب في ذلك؟
نعم، الأدب قادرٌ على دفع التغيير الاجتماعيّ والسياسيّ، لكنْ ليس بالمعنى المباشر أو الشعاراتيّ. فالأدب يقود التغيير من خلال تحريك الوجدان وتحفيز الأسئلة، من خلال قصصٍ تعكسُ الواقعَ وتفتح النقاش حول المظالم والتحديات. الأدباء لا يقدّمون حلولًا جاهزة، لكنّهم ينيرون دروبًا للتفكير والنقد. الأدب يشجّع على إعادة النّظر في البديهيّات، ويساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتسامحًا. - ما الذي يشجعك على الاستمرار في الكتابة رغم التحديات التي قد تواجهينها كأدبية عربية؟
لست أكتب لأنّني قويّة، بل لأنّني أضعف من أن أواجه الحياة من دون ورقة. أكتب حين يختنق الكلام في حنجرتي، وحين لا يعود الضوء ذات معنًى إلّا إذا مرّ من بين السطور.
الكتابة عندي ليست مشروعًا، إنّما حالة، شبهةٍ، نجاة مؤقتة من الغرق الكامل.
هي اللّغة السريّة بيني وبين ذاتي، الرسائل التي لا أرسلها، والدموع التي لا تسيل.
التحديات؟ لا أعرفها إلا حين أنظر خلفي، لأكتشف أنّني مررت بها وأنا أكتب، لا غير.
ما يشجعني؟ فكرة صغيرة: أنّ كلمة صادقة، نُسجت من خوفي وهوَسي وحلمي، قد تلامس قلبًا آخر في لحظة ما، وتجعله يشعر بأنّه ليس وحده في هذا الكون الموحش.
الكتابة هي طريقتي في الاعتراف، وفي الاختباء، في الوقت ذاته. إنها الفخّ الجميل الذي أضع قلبي فيه، طوعًا، كلّ مرة. - كيف تصفين العلاقة بين الأدب والتعلّم؟ وهل تعتقدين أن الكتابة يمكن أن تساهم في تحسين أساليب التعليم؟
الأدب والتعلّم وجهان لعملة واحدة، كلاهما يسعى إلى بناء الإنسان. الأدب يعلّمنا التفكير خارج الحدود، بينما التعلّم يعطينا الأدوات لفهم العالم من حولنا. الكتابة يمكن أن تساهم في تحسين أساليب التعليم من خلال جعل المحتوى أكثر جذبًا، وإضفاء طابعٍ شخصيّ على العملية التعليمية. من خلال الأدب، يمكننا ربط الدروس بتجارب الإنسان الحقيقيّة، ما يجعلها أكثر حيويّة وواقعيّة. - ما هو الكتاب أو العمل الأدبي الذي ترك لديك أثراً كبيراً؟
لا أستطيع تحديد كتاب واحد فقط، لكنْ إذا كان لا بدّ من اختيار، لقلت “في انتظار البرابرة” لجوهاند ناي. إنّه عمل يعكس التوتّر بين الإنسان والآخر، وبين ما هو داخليّ وما هو خارجيّ. يشدّني ذلك التمرّد العميق على الأنظمة المترسّخة، والحاجة الماسّة إلى الحرية، والّتي تتجسّد ببراعة من خلال الشخصيّات والأحداث. كما أنّ الشعر العربيّ الحديث، وبالأخصّ ما كتبه محمود درويش، له أثر كبير في تكوين مفهومي الشخصيّ عن المقاومة.
لكنّني أكون جاحدة إذا لم أكتب عن أدب ميخائيل نعيمة، ذلك الذي إن أنكرته كأنّني أنكرت الأرز في رئتي، وكأنّ نسيم صنين لم يمرّ يومًا على وجداني. نعيمة لم يكتب فقط، بل نفخ في اللّغة روحًا جبليّة، جعلني أشعر أن الأدب يمكن أن يكون صلاةً، ومناجاةً، ووقفة تأمّل تحت شجرة في منتصف العمر. - كيف تقومين بتقييم النصوص الإبداعية؟ وهل هناك معايير خاصة بكِ أثناء القراءة أو النقد؟
أنا لا أقيّم النصّ فورًا، بل أتركه يقيّمني أولًا. إذا لم يغيّر شيئًا في نبضي، أو يوقظ في داخلي سؤالًا جديدًا، فإنّني أضعه برفقٍ جانبًا، كأنّني أنحّي زائرًا لم يأتِ من عمق الحاجة.
لا أؤمن بالمعايير الصارمة، بل بالانزياحات، باللحظة التي يفلت فيها النصّ من لغته ويصير طيفًا، دهشة، وانكسارًا جميلاً في المعنى.
أراقب بنية النصّ، موسيقاه الداخليّة، حدسه، كيف يتعامل مع الصمت كما مع الكلام، كيف يُغوي قارئه دون أن يستعرض.
أما القراءة النقديّة عندي فهي نوع من الإصغاء الطويل؛ أنا لا أبحث عن عيوب النصّ، وإنّما عن روحه. وحين أكتب عنه، أكتب كما لو أنني أرسم ظلال شيء أحببته، أو خفت منه، أو كاد أن يشبهني. - هل لديك اهتمامات أدبية خارج نطاق الأدب العربي؟ وكيف تواكبين الأدب العالمي؟
نعم، ثمّة شيء يشبه الشغف الصامت يربطني بالأدب العالميّ، كأنّني أقرأ فيه مرآة بعيدة لأسئلتي القريبة. أحب أن أطلّ على العالم من نوافذ أدبيّة مختلفة، لأتوسّع، لأختبر كيف يتكلّم الوجع بلغات أخرى.
أعمال دوستويفسكي، مثلاً، حفرت في داخلي فكرة أن الإنسان هو كائن داخليّ، مليء بالتشقق. أما كافكا، فكان بمثابة صدمة، جعلني أفهم كيف يمكن أن يصبح الواقع أكثر عبثيّة من الحلم.
أتابع الأدب العالميّ عبر الترجمات، والدراسات النقديّة، وأحيانًا عبر الأصوات التي تلتقط نصوصًا هامشيّة لكنها قادرة على إحداث التحوّل.
ليس الهدف فقط أن أقرأ أدبًا عالميًّا، ولكن كي أضع الأدب العربيّ في حوار دائم معه؛ لأن الأدب، في جوهره، هو مشروع تواصل إنسانيّ، عابر للحدود، واللّغات، وحتى الزمن. - كيف تنظرين إلى الشعر العربي في الوقت الراهن؟ وهل تعتقدين أنه ما زال يحتفظ بجاذبيته في عصرنا الحديث؟
الشعر العربيّ، رغم كل ما يُقال عن تراجعه، ما زال حيًّا… لكنّه لم يعد يلبس العباءات القديمة. تغيّرت موسيقاه، تغيّرت قضاياه، لكنّ جوهره ما زال كما هو: دهشة اللغة حين تلامس الروح.
قد لا يلهب الجماهير كما في السابق، لكنّه ما زال قادرًا على خلق لحظة صفاء نادرة في عالم صاخب.
أراه الآن أكثر تحرّرًا، أكثر جرأة، وأحيانًا أكثر تشظّيًا، لكنه أيضًا أكثر صدقًا. صار ينزل من المنابر ليجلس قرب القارئ، يهمس له حينًا، ويصرخ به حينًا آخر.
ولأنه فقد هالته القديمة، صار علينا أن نبحث عنه بعين المحب، لا بعين المؤرخ.
نعم، الشعر ما زال يحتفظ بجاذبيّته، لكنّها جاذبية لا تُرى إلا لمن يعرف كيف يُنصت. - هل هناك نوع من الأدب تعتقدين أنه يجب أن يتطور أو يعاد النظر فيه في الأدب العربي المعاصر؟
أعتقد أن الأدب العربيّ بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأشكال التقليديّة، ليس من حيث الأسس أو الأسلوب، إنّما من حيث الإمكانيّات الكامنة في تطويعها مع مستجدّات العصر. لا سيّما في مجال الأدب القصصيّ والرواية التي تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع القضايا الراهنة. أدبنا لا يزال يتّسم أحيانًا بالاحتشاد بالمفاهيم والموروثات الكلاسيكيّة من دون أن يعكس بشكل كامل التنوّع والتناقضات التي يواجهها المجتمع العربيّ اليوم.
من المهم أن نفتح باب التجريب بشكل أوسع، ونتخطّى الأساليب القديمة، ونترك الأدب أن يعبّر عن العصر الحاليّ، بحالاته المتعدّدة، بآلامه وأفراحه، بحروبه وسلامه، في أبعاده الرقميّة والذهنيّة والاجتماعيّة.
التجربة الأدبيّة في العالم العربيّ اليوم بحاجة إلى التحرّر من قيود الماضي بشكل واعٍ، مع الاحتفاظ بالموروث الثقافيّ العظيم الذي يميّزنا. لهذا أرى أن الأدب العربيّ المعاصر بحاجة إلى أن يُفكّك المفاهيم التقليديّة ويلتحم مع الواقع والتحدّيات الجديدة. - في ختام هذا الحوار، ما رأيك بالملتقيات الأدبية لا سيما ملتقى الشعراء العرب، ومجلة “أزهار الحرف”، والشاعر ناصر رمضان عبد الحميد؟
لقد كانت الملتقيات الأدبيّة دائمًا فضاءً خصبًا للتبادل الفكريّ والثقافيّ، وأعتبر انضمامي إلى ملتقى الشعراء العرب خطوة جوهريّة في إثراء تجربتي الأكاديميّة والشعريّة، فالملتقى لا يُعدّ مساحة للتعارف الأدبيّ وحسب، إنّما هو مدّ جسور بيننا وبين أفكار وأصوات مبدعة تساهم في تحفيز التفكير والنقد المستمر.
أمّا مجلة “أزهار الحرف”، فهي منبر شعريّ نقدي يعكس بذور الأدب العربي الناضجة، حيث قدّمت لي فرصة رائعة للنشر، ولم تقتصر المجلّة على تقديم صفحات لأعمالنا، بل كانت بمثابة مرآة أدبيّة تعكس ذواتنا وأصواتنا الأدبيّة بأمانة. كانت المجلّة وما زالت في نظري منصّة تعزز التنوّع والتجدّد في الساحة الأدبيّة.
والشاعر الكبير ناصر رمضان عبد الحميد، هو مثال النبل والكرم الأدبيّ، حيث منحني فرصة نشر أعمالي في مجلته القيّمة، ممّا ساعدني في الوصول إلى جمهور أوسع. فهو داعمٌ حقيقيٌّ للمبدعين، يشجّع على الإبداع ويساهم في إبراز الأصوات الأدبيّة الجديدة بكل تواضع ورقيّ.
في مجمل القول، إن هذه المنابر الأدبية، بمجموعها، تمثّل نقطة التقاء حيويّة تشجّع على الإبداع، وتحتفي بالأصوات الجديدة في الأدب، مما يسهم في خلق بيئة تُنمّي الفكر وتثري الثقافة. ونحن في النهاية، أبناء هذه الأرض الأدبيّة التي تجمعنا وتُثمر بها أقلامنا.