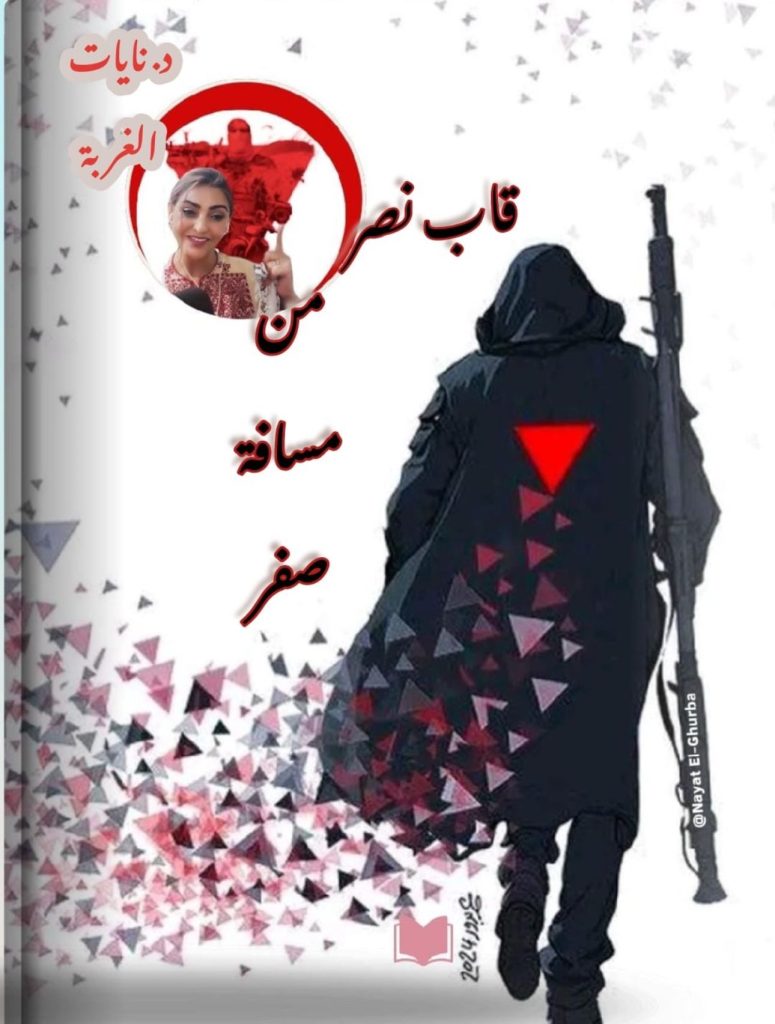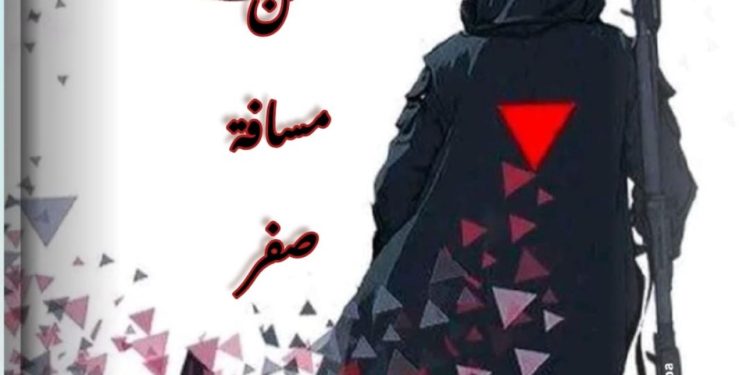بين التفكيك والتجديد: قراءة تحليلية معاصرة لكتاب “قاب نصر من مسافة صف”.
بين التفكيك والتجديد: قراءة تحليلية معاصرة لكتاب “قاب نصر من مسافة صف”.
للشاعرة: د. نايات الغربة – سفيرة السلام والثقافة العربية
بقلم: وفاء داري – كاتبة وباحثة من فلسطين
في مشهد أدبي معاصر يسعى دومًا إلى تجاوز القوالب التقليدية وتجاوز حدود اللغة والمألوف، يظهر كتاب قاب نصر من مسافة صفر كأحد التجارب الأدبية الجريئة التي تحمل بصمة فكرية نقدية فريدة. تقدم الدكتورة نايات الغربة في هذا العمل، المكوَّن من 103 صفحة، قراءة معمقة تستكشف آفاق التفكيك والابتكار اللغوي بأسلوب يمزج بين الشعر والنقد الفلسفي المعاصر، مما يعكس روح الحداثة والحوار الحضاري الذي يميز هذا العمل. يُعد الكتاب بمثابة دعوة للتأمل في مفاهيم النصر والوجود، وانطلاقًا من هذا الإطار، تأتي القراءة التحليلية لتكشف عن الطبقات المتعددة في النص وتسلط الضوء على تحديات وإمكانيات التجديد الأدبي في زمن يتطلع فيه الأدب إلى إعادة تعريف ذاته. يمكن تصنيف الكتاب ضمن “الأدب التجريبي المعاصر” أو الشعر الحر (النثري والمرسل) “. يتميز العمل بالانزياحات عن الشكل التقليدي للقصيدة العربية، حيث يخلط بين الإيقاع المتقطع والصور المجازية المكثفة، مع تركيز على الخطاب الثوري والوطنـي. النصوص تحمل طابعً(ملحميًا) يعكس معاناة الشعب الفلسطيني وصموده اذ ينتمي الى (الأدب المقاوم) الذي يركز على الصراع ضد الاحتلال. كما يتضمن الكتاب نصوصاً وخواطر وقصائد ذات طابع أدبي متعدد الأبعاد؛ حيث يظهر فيه الأسلوب الشعري: باستخدام الصور الشعرية والرموز التعبيرية في بعض المواضع، مما يشير إلى توجه شعري حداثي. كذلك بروز الأسلوب النقدي والفلسفي: إذ يتلاقى فيه الأسلوب الشعري الحر مع أبعاد نقدية ومعرفية وفلسفية عميقة، حيث تداخل في الأفكار والنقد البنّاء، يتضح ذلك من خلال المناقشات التي تلامس الوجود والهوية والزمن والمكان، مما يوحي بأن النصوص تتجاوز مجرد الجمالية الشعرية إلى بحث أعمق في معاني الوجود.
دلالة عنوان الكتاب: “قاب نصر من مسافة صفر”
يمكن تفسير العنوان على أنه تأكيد على إمكانية تحقيق الانتصار أو الوصول إلى الحقائق الوجودية دون الحاجة للمسافات التي تفصل الإنسان عن ذاته أو عن الحقيقة. رمزية كلمة “قاب” قد تشير إلى رمز النصر أو العلامة الدالة على تحقيق إنجازٍ ما، وقد تحمل أيضاً دلالات من المفاهيم القتالية أو الفلسفية المتعلقة بالمواجهة. أما عبارة “من مسافة صفر” تبرز مفهوم القرب المطلق، وكأن النصر لا يحتاج إلى جهد أو بعد، بل هو في متناول اليد؛ أو ربما إشارة إلى حالة من التفرد والتجرد من الوساطات التقليدية للوصول إلى جوهر النصر. كما يظهر في العنوان استخدام تركيب لغوي مبتكر وغير تقليدي، مما يشير إلى توجه الكاتب نحو تجديد اللغة وتحريرها من القوالب المعتادة.
الأسلوب الأدبي والإنزياح اللغوي والصور الشعرية
استخدام الرموز التعبيرية والوجوه التعبيرية في النص (كما ظهر في بعض القصائد) يعكس محاولة الربط بين اللغة المكتوبة والرموز الحديثة. كذلك استخدام الاستعارات المركبة: تنتشر الاستعارات التي تحمل دلالات متعددة، حيث تتداخل عناصر الطبيعة مع مفاهيم الصراع والانتصار. وأيضًا استخدام التباين البصري واللفظي: يستخدم الكاتب تبايناً بين الصور القوية والعبارات الناعمة لإضفاء حيوية على النص. كما اعتمد الكتاب على عدة أساليب أدبيةاخرى ومنها:
• الأسلوب الحر التجريبي: يعتمد على كسر الأنماط التقليدية وإعادة بناء النص بأسلوب يحاكي التجديد والتجريب في الأدب.
• النقد الفلسفي: يتخلل النص طابعاً نقدياً فلسفياً يتحدى الأفكار السائدة ويطرح رؤى جديدة حول مفاهيم النصر والوجود.
• التداخل بين الأشكال: يمزج بين الشعر والنثر والرمزية مما يجعله متعدد الأبعاد من حيث الأسلوب والمضمون.
• التجريبية والحداثة: يميل النص إلى كسر الأشكال التقليدية في الشعر والنثر، مع اعتماد أسلوب شعري حر يجمع بين الرمزية والحداثة.
• المزج بين الشعر والنقد: تظهر ملامح نقدية تتداخل مع الصور الشعرية، ما يضفي على النص بعداً فلسفياً نقدياً يهدف إلى استكشاف الذات والواقع.
• البعد المعرفي: يستخدم النص عناصر اللغة والرمزية لاستحضار مفاهيم فلسفية ومعرفية، مما يجعله نصاً متعدد الأبعاد.
• الخطاب الثوري: استخدام لغة حماسية مباشرة تدعو إلى المقاومة مثال: “لن نصالح، لن نبارح، لن نسامح”.
• الاستفهام الإنكاري: “ما يعدكم القرطاس والفرشاة والقلم؟” لتفجير الأسئلة الفلسفية حول دور الأدب في المواجهة.
الانزياح اللغوي:
الابتعاد عن القواعد التقليدية: يظهر ذلك من خلال تراكيب لغوية جديدة واستخدام تعبيرات غير مألوفة تتحدى القواعد النحوية الكلاسيكية. والاعتماد على الصور الرمزية: كثير من العبارات تحمل رموزاً واستعارات تتطلب قراءة متأنية لفهم دلالاتها المتعددة. والتداخل بين مستويات اللغة: يمزج النص بين لغة الشارع والأدب الرفيع، مما يعطيه طابعاً معاصراً يجذب فئات متعددة من القراء. أبرز الانزياحات جاءت في عدة أشكال ومستويات ومنها:
(انزياح ديني): تكرار عبارات مثل “الله أكبر”، “جند الله”، لربط النضال بالقداسة.
(انزياح تاريخي): استحضار رموز مثل “كنعان”، “محمد”، و”فلسطين” لتأصيل الهوية.
(انزياح مجازي): تشبيه الأرض بأنثى غزة كـ “فاطمة”، “العذراء”، والمقاومة بالنار، “غزة فوق القصف… وفوق النار”.
(التكرار): لتأكيد الإصرار مثال: “نحن شعب… نحن شعب…”.
الأبعاد الفلسفية:
بحث في الوجود والهوية: يستحضر النص أسئلة وجودية حول معنى النصر والهوية الإنسانية، والتجارب الفردية والجماعية في مواجهة التحديات. التفكيك والتجديد: يظهر تأثراً بمدارس الفلسفة المعاصرة التي تسعى إلى تفكيك البنى اللغوية والمعرفية التقليدية واستحداث طرق جديدة للتعبير. التأمل في الزمن والمكان: تتناول النصوص والقصائد قضايا الزمن والمسافة باعتبارهما عناصر تؤثر في تجربة الإنسان وتحقيقه للنصر على المستوى الرمزي والوجودي. على سبيل المثال: (الوجودية المقاومة): التركيز على الاختيار الحر للفرد/الشعب في مواجهة القهر مثل: “وجودنا قرار”. (الهوية الجريحة): استعادة الذات عبر رموز الأرض والتاريخ مثل: “نحن التراب والشجر… نحن القدس”. (الثنائيات الضدية) مثال: الحياة/الموت، العار/الكبرياء، التحرر/الاستعباد، لخلق صراع درامي يعكس أزمة الإنسان الفلسطيني. (النقد الذاتي للأمة العربية) مثل: “يا أمة المليار… يا أمة الزور” كتعبير عن خيبة الأمل من التضامن العربي.
قراءة تحليلية لإحدى القصائد من كتاب (قاب نصر من مسافة صفر) بعنوان” ارفعي الأكفان”.
إرفعي الأكفان
*غزة …. ارفعيها
وإرفعي الأستار
يا غزة … وعَلّيها
عن أممٍ
قد ماتت النخوة فيها
واكشفي السِتر
يا غًزَّتي …
وأميطي اللثام بقسوة
عن اعرابِ!
*خسةٍ نجسة*
تغلغلوا بالغدر في أعراقها
فإزينت بالعهر منهم نواصيها
إرفعي أصواتك يا غزة
بصراخ الكرامة والعزة
في بلاد علت فيها طبول
“اللات والعـُزى”
بمن فيها وكل ما فيها
الا ولتُفصحي للقدح
فيهم معنىً ومغزىً
ولتُمعني لُسنا
ولتُجري في آلياتهم
أسنّة سُننا
مطالعها وقوافيها
وارمي في خنوثتهم
رماحا وأسهما
واشحذي للموبقات
نيازك وشهبا حمما
واقذفيهم بالراجمات
رجما وافضحيها
ألا إن ترخِ
يا غزة …
بقيد أنملة
من طهرٍك والعفة
على أمم أنجاس *لمما
تزكيها!
فعري قِحاب زمانها وزناتها
امام عين الله وأعينهم… عريها
عررررريهاااااا
وفَعَلي مُرَّك وأمركـ فيها ….
تجسد قصيدة “إرفعي الأكفان” خطابًا شعريًا مقاومًا، يعرّي الخيانة العربية ويُسائل القيم المنهارة بلغة رمزية حادة. توظف صوتًا أنثويًا غاضبًا، تعكس اغترابًا وجوديًا وسياسيًا، وتعيد تعريف المقاومة بوصفها فعلًا جماليًا وثقافيًا. القصيدة صرخة وعي وفضح، تمزج بين التحدي، الانتماء، والانبعاث من الألم. تندرج قصيدة “إرفعي الأكفان” ضمن ما يمكن تسميته بـ(الشعر المقاوم الميتافيزيقي)، حيث تلتقي ” الوظيفة الجمالية” مع “الوظيفة التوعوية والتعبوية”، متخذة من غزة رمزًا للهوية الجريحة، ونافذة على العار الجمعي العربي.
تبدأ القصيدة بتوجيه نداء غاضب إلى غزة، مع التركيز على “رفع الأكفان” و”رفع الأستار”، مما يوحي بضرورة الكشف عن الحقيقة وإظهار ما هو مخفي. هذا النداء يمثل إرادة الكشف والتغيير، مع إشارة قوية إلى عجز الأمم الأخرى عن الاستجابة لمطالب غزة، مما يعكس الشعور بالعزلة. كذلك تتبنى القصيدة صوتًا أنثويًا جمعيًا غاضبًا، يحاكم التاريخ والواقع، ويرفض التواطؤ، ويتحدى الصمت. يظهر (الاغتراب الوجودي والقيمي) بوصفه ثيمة مركزية، سواء من خلال إحالة رمزية إلى “الأكفان” و”الستار”، حيث تستعمل القصيدة الرمزية الدينية بشكل واضح عبر استدعاء “اللات والعزى” كرموز للردة والانحطاط، آلهة الوثنية في الجاهلية، ليعكس الخضوع والهزيمة في الأرض التي استولى عليها الفساد، ما يعزز فكرة الصراع بين الأديان والأنظمة الفاسدة. هذا الاستحضار الديني يأتي ليزيد من دلالة الإدانة والتحدي. أما في الجزء الذي يتحدث عن “الأعراب” وخسة نجسة”، فتظهر القصيدة موقفًا حادًا تجاه الخيانة والتواطؤ. تستخدم الشاعرة ألفاظًا قاسية مثل: “خسةٍ نجسة” و”عهر” لتوصيل مشاعر الإحباط والحقد على القوى المتواطئة. هذه الألفاظ ليست مجرد نقد سياسي، بل تمثل أيضًا هجومًا ثقافيًا، حيث تهاجم الشاعرة (نايات) القيم التي تراها الأمة العربية في حالة انحلال أخلاقي وتفكك. في نهاية القصيدة وتصيغ تحريضًا صريحًا للمقاومة والتحدي، حيث تطالب الشاعرة غزة بأن “تفضح” وتجعل العالم يرى الحقائق التي يخفيها. هذه الدعوة، باستخدام الأفعال القوية والمباشرة مثل “اقذفيهم” و”فضحيها”، تمثل رغبة في إحداث تغيير جذري وفتح الأعين على الخيانات التي لا يمكن السكوت عنها.
الأسلوب الأدبي للقصيدة: تضمنتها قصيدة (ارفعي الأكفان) عدة أساليب أدبية ومنها: النداء الخطابي مثل: “ارفعي الأكفان غزة… ارفعيها” لتحويل الخطاب إلى فعل. والتناص الديني والتاريخي: استعارة آيات قرآنية وأحداث تاريخية (مثل معركة حطين). والسرد الملحمي: حكايات الشهداء والمقاومين كجزء من سردية جماعية. والمفارقة: مثل “ممنوعة أنا من ممارستي طقوس الحرية” لفضح التناقض بين الخطاب الدولي والواقع. النص يعكس تحول الشعر من أداة جمالية إلى وسيلة نضالية، حيث تتحول الكلمات إلى “رشاشات” و”قنابل مولوتوف” قراءة تحليلية في قصيدة “إرفعي الأكفان”.
لغويًا، تعتمد القصيدة على (بنية تفجيرية) للغة؛ فالأسلوب قائم على (التكسير النحوي) والانزياحات القوية التي تُظهر شحنة عاطفية مكثفة. فـ”ارْفعيها” لا تُقرأ فقط بوصفها أمرًا لغويًا، بل فعل مقاومة، فعل كشف وفضح. “الصوت الأنثوي المقاوم” في القصيدة لا يتردد في استخدام لغة غاضبة، هجائية، صادمة أحيانًا، بهدف إحداث هزة وجدانية، وتحطيم الإطار التقليدي للتلقي الشعري. رمزية الانزياحات اللغوية هنا ليست مجرد زخارف، بل أدوات لتفكيك الخطاب المهيمن وإعادة بناء الهوية عبر اللغة.
الصور الشعرية: الصورة النارية مثل: “غزة ضد الانصهار… نحن نار” (رمز التحدي). والصورة الجسدية المجزأ مثل: من دمائك… كل لحما” (تشيئ الجسد كفداء للوطن). والصورة الدينية مثل: “سنصلي دما في محراب أقصانا” (دم الشهداء كطقس مقدس). والصورة السوداوية مثل: “موتوا جوعًا… موتوا عطشًا” (سردية المعاناة الجماعية).
القصيدة تتجاوز التوصيف العاطفي البسيط للألم، إذ تكشف عن فلسفة عميقة حول الكرامة والوجود. هناك تحفيز لصوت غزة لكي “تصرخ” بقوة، وهو صراع يرفض الاستسلام ويطالب بالعزة. الشاعر لا يقتصر على الشكوى، بل يُظهر أيضًا القوة المستمدة من المظلومين. حيث تقدّم الشاعرة مقاومة نفسية وثقافية عميقة. إجمالًا، القصيدة تقدم صورة للمعاناة والتحدي، لكنها تتوجه أيضًا للأمل في النهوض والمقاومة، مع استخدام قوي للغة البلاغية والرمزية التي تجعلها أداة لرفع الوعي وتحفيز العمل في مواجهة الظلم. القصيدة النثرية “إرفعي الأكفان” هي قصيدة تعبيرية تمثل أدب المقاومة، الذي يستحضر الإحساس بالظلم ويعبّر عن الرفض والمقاومة للواقع القاسي. تشتمل القصيدة على عدة مستويات نقدية وفلسفية تتجلى فيها الرمزية، والبلاغة، والصراع بين الخير والشر.
من وجهة نظر نقدية فلسفية معاصرة لمجمل الكتاب “قاب نصر من مسافة صفر”، يمكن النظر إلى بعض السلبيات المحتملة في الكتاب، مع التأكيد على أن هذه النظرة تعتمد على زاوية التحليل وقد يراها البعض نقاط قوة:
التجريبية المفرطة والغامضة يعتمد العمل بشكل كبير على أسلوب تجريبي يكسر القواعد التقليدية للغة، ما قد يؤدي إلى عدم الوضوح والرسالة المتشابكة: استخدام الرموز والاستعارات المعقدة بشكل مفرط قد يصعب على القارئ استخراج فكرة موحدة أو فهم الرسالة الأساسية للنص.. الانحياز إلى التجديد على حساب العمق. أيضًا الخطابية العالية والنزعة الحماسية: قد يرى البعض أن اللغة المستخدمة في الكتاب تميل إلى الخطابية العالية والنزعة الحماسية القوية، مما قد يؤثر على التوازن بين العاطفة والعقل في الطرح. في حين أن هذا الأسلوب يمكن أن يكون فعالاً في إثارة المشاعر والتفاعل مع القضايا المطروحة، إلا أنه قد يعتبره البعض مفرطًا في التأثير على القارئ ويقلل من المساحة النقدية والتفكيرية. التركيز على البطولة دون تعمق فلسفي (الانفصال عن الجدية الفلسفية): الكتاب يُبرز البطولات بشكل مباشر دون التعمق في الجوانب الفلسفية المتعلقة بالوجود الإنساني أو القيم، مما قد يقلل من تأثيره على القارئ الذي يبحث عن تحليل أعمق للصراع. محدودية الطرح النقدي وغلبة العاطفة على التحليل: النصوص الأدبية في الكتاب تعتمد بشكل كبير على العاطفة والانفعالات، مما قد يُضعف الجانب التحليلي الذي يُمكن أن يثري تجربة القراءة ويُعزز فهم القارئ للواقع المعقد. هذه النقاط تجعل الكتاب مناسباً لجمهور يبحث عن الإلهام العاطفي أكثر من التحليل الفلسفي العميق.
الخلاصة
يتجسد في هذا العمل توجه أدبياً معاصراً يمزج بين الشعر والنقد الفلسفي، معتمدًا على أسلوب تجريبي يكسر القوالب التقليدية ويستحضر مفاهيم فلسفية وجودية. عنوان الكتاب “قاب نصر من مسافة صفر” يحمل دلالات رمزية تشير إلى النصر القريب أو المباشر، ويعكس فلسفة التفكيك والتجديد اللغوي. كما يظهر في النص ارتباط قوي بالرموز والصور الشعرية التي توحي برحلة فكرية عميقة.