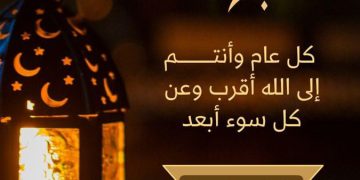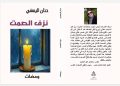الشاعر الدكتور سلطان إبراهيم: سيرة ذاتية نقدية وتقييم لأثره الفكري والأدبي
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
[email protected]
كلمة تمهيدية:
يُمثِّل الشاعر الدكتور سلطان إبراهيم عبد الرحيم محمد ظاهرة أدبية وفكرية تستحق الوقوف عندها طويلاً. فهو ليس شاعرًا ينسج قصائده من عواطف عابرة فحسب، بل هو باحث أكاديمي منضبط، ومفكر إسلامي واعٍ، وأحد فرسان الشعر المنافح عن قضايا الأمة. يجسد في مسيرته تلاحم العمق الأكاديمي مع الحس الشعري الملحمي، مما يجعله نموذجًا فريدًا في المشهد الثقافي المصري والعربي المعاصر. يتناول هذا المقال سيرته الذاتية، ويقيم أثره متعدد الأبعاد، ثم يغوص في تحليل نقدي معمق لأبرز أعماله الشعرية.
الفصل الأول: السيرة الذاتية وسياق التكوين الفكري
1.1. النشأة والجذور:
وُلد الشاعر في 20 يوليو 1971 في قرية “أبطوجة” بمحافظة المنيا، تلك الصعيد المصري العريق الذي يشكل مخزونًا تراثيًا وثقافيًا يغذي الوجدان ويلهم اللغة. لا شك أن هذه البيئة الريفية الأصيلة، ببساطتها وعمقها، كانت الحاضنة الأولى لموهبته، حيث تغذى من ينابيع اللغة العربية الفصيحة والشعر العربي الأصيل.
2.1.المسار الأكاديمي والعلمي:
يمتلك الدكتور سلطان إبراهيم رصيدًا علميًا مثيرًا للإعجاب، يجمع بين العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية، مما أضفى على نتاجه الأدبي ثراءً وتميزًا. يمكن تتبع مسيرته العلمية كالتالي:
• التكوين التطبيقي: بدأ بدبلوم الخدمة الاجتماعية (1992)، مما منحه رؤية واقعية لقضايا المجتمع والإنسان، وهو ما يتسرب إلى كثير من نصوصه.
• التعمق في العلوم الشرعية والعربية: حصل على ليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة (2007)، واجتاز مرحلة التمهيدي للماجستير في الشريعة الإسلامية، مما وطّد لديه منهجية التفكير الشرعي والفهم العميق للنصوص.
• الاحتراف الأكاديمي: حصل على درجة الماجستير في البلاغة والنقد من جامعة عين شمس بدرجة امتياز عن رسالته “شعر عنترة بن شداد: دراسة تداولية”، وهي دراسة تجمع بين التراث والأدوات النقدية الحديثة. ثم نال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في أبريل 2024 عن أطروحته العميقة “بلاغة الحجاج عن القضية الفلسطينية في الشعر الفلسطيني المعاصر”، والتي توجت مسيرته البحثية وربطتها بشكل عضوي بمنحاه الشعري.
• التكامل المعرفي: حصوله على شهادة التجويد والدبلومة التربوية (2025) يظهر حرصه على التكامل بين العلم الشرعي، والأداء الصوتي للغة، والمنهجية التربوية.
3.1. العضوية والتكريمات:
يشغل الدكتور سلطان إبراهيم عضوية عدد من الهيئات الأدبية الرصينة مثل اتحاد كتاب مصر، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، ونادي أدب الجيزة، وملتقى السرد العربي. وقد حظي بتكريم في أهم المحافل الثقافية، منها دار الأوبرا المصرية، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، وجامعة الأزهر، ورابطة الأدب الإسلامي. كما نال جوائز مرموقة مثل جائزة النشر الإقليمي (2017) وجائزة مؤسسة بنت الحجاز الثقافية (2023).
الفصل الثاني: تقييم الأثر الفكري والشعري والثقافي
1.2. الأثر الفكري والمنهجي:
يتمثل أثره الفكري في تقديمه نموذجًا للشاعر الباحث، الذي لا يكتب بانفعال عاطفي فقط، بل يساند رؤيته بأدوات بحثية ومنهجية صارمة. دراساته الأكاديمية حول “الحجاج” و”التداولية” تنعكس مباشرة على شعره، حيث تبدو قصائده محكمة البناء، تقوم على الاستدلال والاستنهاض وبناء الحجة الشعرية المقنعة، خاصة في قصائد القضية الفلسطينية وقضايا الأمة.
2.2. الأثر الشعري والأدبي:
أثرى المكتبة العربية بأكثر من عشرين ديوانًا شعريًا، يتنوع بين الغزل الوجداني، والشعر الاجتماعي، وذروة إبداعه: الشعر الملحمي المنافح. يشكل شعره سجلاً أدبياً حياً لقضايا الأمة في العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين. لقد نجح في تحويل الأحداث الجسام (كمعركة سيف القدس، طوفان الأقصى) إلى نصوص شعرية خالدة، تخلد الحدث وترفعه إلى مستوى الملحمة.
3.2. الأثر الثقافي والعلمي:
لا يقاس أثره بما كتبه فقط، بل بما كُتِبَ عنه. فقد أصبحت أعماله منهجًا للبحث والدراسة في الجامعات، حيث نوقشت عنه أطروحتان للدكتوراه (في جامعة الأزهر) وعدة رسائل ماجستير وبحوث في الجزائر ومصر. هذا التناول الأكاديمي لشعره يرفعه إلى مصاف الكلاسيكيين المعاصرين، الذين يُدرَس أسلوبهم وموضوعاتهم.
الفصل الثالث: تحليل نقدي معمق لأربعة دواوين رئيسية
هذه الدواوين الأربعة تمثل قلب المشروع الشعري للدكتور سلطان إبراهيم، وتتجلى فيها سماته الموضوعية والأسلوبية بأعلى درجة.
1. ديوان (على أبواب دمشق):
ديوان “على أبواب دمشق” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم يمثل وثيقة أدبية وشعرية تعكس رؤية عميقة للواقع السوري خلال فترة الثورة والمعاناة، كما يتناول قضايا التحرر، المقاومة، الإيمان، والأمل. يعبر الديوان عن صوت الجماعة المناضلة وأحلامها، ويجسد معاناة الشعب السوري بأسلوب شعري مكثف، مليء بالرمزية والحماسة الدينية والوطنية.
التحليل الفني والأدبي
1. البناء الفني واللغوي
• اللغة: تستخدم لغة شعرية قوية، تمزج بين الفصحى والعاطفة الجياشة، مع حضور كثيف للصور البلاغية والاستعارات والتشبيهات.
• الإيقاع: تنوع في الأوزان والقوافي، مما يعكس تعدد الأجواء النفسية بين الحزن والأمل، الثورة والثبات.
• العنوان: “على أبواب دمشق” يحمل دلالة رمزية قوية، فهو يشير إلى الاقتراب من النصر، أو لحظة التحول التاريخي.
2. المحتوى والموضوعات
• المقاومة والنضال: يتجلى هذا في قصائد مثل “أهوال حلب” و”دمشق عروس النصر”، حيث يُصوّر المعاناة والصمود.
• البعد الديني: يشكل الإيمان والإسلام مصدرًا رئيسيًا للإلهام، كما في قصيدة “طلائع الإيمان” و”العلم المقاوم”.
• اللجوء والشتات: تتناول قصائد مثل “مضت السفينة” معاناة اللاجئين السوريين وتشتتهم.
• النقد السياسي: يهاجم الشاعر النظام السوري وأدواته، كما في “بشار يسقط” و”فلسفة الخيانة”.
3. الرمزية والدلالات
• دمشق: ترمز إلى العروبة، الإسلام، والنضال.
• الحلم: يتكرر كرمز للأمل والتحرر.
• الطفل والشهيد: يمثلان البراءة والتضحية.
• الخيانة والغرب: يصوران كقوى معادية للشعب السوري وقضيته.
الأثر الفكري والأدبي والثقافي
1. الأثر الفكري
• يعزز الديوان قيم المقاومة والثبات على المبادئ.
• يطرح تساؤلات حول الخيانة، الحرية، والمسؤولية الأخلاقية.
• يعكس وعيًا نقديًا تجاه الواقع العربي والسياسات الدولية.
2. الأثر الأدبي
• يمثل إضافة نوعية للأدب المقاوم والشعر الثوري.
• يجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين العمق الديني والهم الإنساني.
• يقدم نموذجًا لشعرية الموقف، حيث يصبح الشعر وسيلة للمقاومة والتغيير.
3. الأثر الثقافي
• يساهم في توثيق المرحلة التاريخية للثورة السورية بأبعادها الإنسانية والسياسية.
• يعيد تعريف دور المثقف والشاعر كصوت للجماعة وضمير الأمة.
4. الأثر العلمي
• يمكن أن يكون مادة خصبة للدراسات النقدية والأكاديمية، خاصة في مجالات:
o شعر المقاومة.
o توظيف الرمزية الدينية في الشعر الحديث.
o التفاعل بين الأدب والواقع السياسي.
ديوان “على أبواب دمشق” ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو مشروع ثقافي وإنساني يعبر عن روح الأمة في لحظة تحولها. يجمع الشاعر بين العمق الفني والالتزام الأيديولوجي، مما يجعله نموذجًا متميزًا في الشعر العربي المعاصر. يؤكد الديوان على دور الأدب كسلاح مقاومة وكوسيلة لتخليد الذاكرة الجمعية وتشكيل الوعي النقدي.
2. ديوان (جذوة القلب):
تحليل أدبي نقدي لديوان “جذوة القلب”
ديوان “جذوة القلب” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم يمثل تجربة شعرية عميقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الذاتي والموضوعي، بين الروحاني والإنساني. يعكس الديوان رؤية شاعر متمكن من أدواته، متعدد المشارب الثقافية والأدبية، يجسد في قصائده هموم الإنسان المعاصر وأحلامه، ويوظف اللغة توظيفًا جماليًا وإيحائيًا يلامس شغاف القلب.
أولاً: التحليل الفني والأدبي
1. البناء الفني واللغوي:
• اللغة: تمتاز لغة الشاعر بالجزالة والعمق، مع ميل إلى الانزياحات البلاغية والاستعارات المبتكرة التي تثري النص وتضفي عليه طابعًا تأمليًا.
• الإيقاع: يستخدم الشاعر بحورًا خليلية متنوعة، مع توظيف للتقفية والجناس والطباق، مما يعزز الموسيقى الداخلية للقصيدة.
• الصورة الشعرية: تتنوع الصور بين البصرية والسمعية والحسية، مثل:
o “جذوة القلب تُذكى بالخير الدائم”
o “صوت القصيدة يُسرع الخفاق المعاني الفريدة”
2. المحتوى والموضوعات:
• الذات والوجدان: يعبر الشاعر عن مشاعره الشخصية بصدق، كالحب، الشوق، الألم، والأمل، كما في قصيدة “رجاء” و”ماذا يشفيك؟”.
• الالتزام الاجتماعي والإنساني: يتناول قضايا مثل الفقر، الطفولة، العدالة، كما في “بائعة المناديل” و”نامي بنية”.
• الروحانيات والقيم: يظهر تأثره بالقيم الإسلامية والإنسانية، كما في “استقامة بالقرآن” و”أساس البيوت”.
• الوطن والقضية الفلسطينية: يُظهر تعاطفًا واضحًا مع القضية الفلسطينية والأقصى، كما في “قطر العروبة” و”طوفان الأقصى”.
3. الرمزية والأبعاد الفلسفية:
يستخدم الشاعر الرمز لتجسيد أفكار مجردة، مثل:
• “جذوة القلب” رمزًا للعطاء المستمر والأمل.
• “العقرب” رمزًا للزمن القاسي.
• “الطفل التائه” رمزًا للإنسان الضائع في زحمة الحياة.
ثانيًا: الأثر الفكري والأدبي والثقافي
1. على المستوى الفكري:
• يقدم الديوان رؤية متوازنة بين العقل والقلب، بين الإيمان والعلم، بين الأصالة والحداثة.
• يشجع على التأمل والتفكير النقدي في قضايا الوجود والمجتمع.
2. على المستوى الأدبي:
• يمثل إضافة نوعية للشعر العربي المعاصر، خاصة في مدرسة الشعر الالتزامي والوجداني.
• يمتاز بتنوع الأغراض الشعرية (غزل، رثاء، حكمة، وطني، إسلامي).
3. على المستوى الثقافي:
• يعكس ثقافة الشاعر الواسعة، من خلال الإحالات التاريخية والدينية والأدبية.
• يساهم في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة.
4. على المستوى العلمي:
• يمكن أن يكون مادة خصبة للدراسات النقدية والأكاديمية، كما ظهر في الأطروحات والبحوث التي تناولت شعره.
• يُظهر الشاعر وعيًا نقديًا بلاغيًا، خاصة في استخدامه للحجاج والاستدلال، انطلاقًا من خلفيته الأكاديمية.
ديوان “جذوة القلب” ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو مشروع ثقافي وإنساني يلامس هموم الإنسان المعاصر ويقدم رؤية متفائلة قائمة على الإيمان والقيم. يمثل الدكتور سلطان إبراهيم نموذجًا للشاعر الملتزم الذي يجمع بين الإبداع والأكاديمية، بين الروح والعقل، بين الذات والآخر. وهذا ما يجعل الديوان إضافة قيمة للمكتبة العربية وللحركة الأدبية المعاصرة.
3. ديوان (العاديات إلى الأقصى):
ديوان “العاديات إلى الأقصى” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم عبد الرحيم محمد يمثل نصوصًا شعرية تعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية ومعاناة شعب غزة تحت الاحتلال. يستخدم الشاعر لغة شعرية قوية، مليئة بالرمزية والتضمين التاريخي والديني، مما يجعل النص يحمل أبعادًا متعددة: سياسية، واجتماعية، وروحية. يتناول الديوان موضوعات مثل الشهادة، المقاومة، الصمود، الخيانة، النفاق، والوحدة العربية، مع تركيز واضح على دور الشعر كسلاح معنوي وفكري.
التحليل الأدبي والنقدي
1. الموضوعات الرئيسية
• المقاومة والصمود: يتجلى هذا الموضوع في قصائد مثل “كفاح رفح” و”خطوة السنوار”، حيث يصور الشاعر البطولة والتضحية في مواجهة القمع.
• الشهادة والشهداء: تُعد قصيدة “روح الروح” و”الموت أمنية المجاهد” نماذج بارزة لتجسيد مفهوم الشهادة كفوز وعزة.
• النقد السياسي والاجتماعي: يهاجم الشاعر الأنظمة العربية والعالم الغربي بسبب صمتهما أو تواطئهما، كما في قصيدة “عصبة غدارة” و”تهديدات الشراهق العجوز”.
• الوحدة والأخوة الإسلامية: يدعو الشاعر إلى الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية والإسلامية، كما في “لبنان تصرخ” و”الحمى المتناثر”.
2. البناء الفني والأسلوب
• اللغة: تستخدم لغة شعرية فصيحة، غنية بالصور البلاغية والاستعارات والتشبيهات، مثل تشبيه المقاومين بالأسود أو الأبطال التاريخيين.
• الإيقاع والقافية: يتميز الديوان بتنوع الإيقاعات والقوافي، مما يعكس تنوع المشاعر والمواقف، من الحماسة إلى الحزن إلى التفاؤل.
• الرمزية: يستخدم الشاعر رموزًا دينية وتاريخية، مثل “السنوار” و”حمزة” و”الأقصى”، لربط النضال المعاصر بتراث الأمة المجيد.
3. الجانب العاطفي والروحي
• العاطفة الجياشة: يعبر الشاعر عن مشاعر الألم، الغضب، الفخر، والأمل، مما يجعل القصائد مؤثرة ومحفزة.
• البعد الروحي: يظهر التوجه الإسلامي جليًا في الديوان، من خلال الدعاء، الاستشهاد بالقرآن، والحديث عن الجهاد والشهادة.
4. التفاعل مع الواقع
• الارتباط بالحدث: كثير من القصائد كتبت ردًا على أحداث معينة، مثل مجزرة الخيام، استشهاد القادة، أو الهجمات على غزة.
• توثيق اللحظة التاريخية: يعتبر الديوان سجلًا أدبيًا للمعاناة الفلسطينية والمقاومة، مما يمنحه قيمة توثيقية بالإضافة إلى قيمته الفنية.
تقييم الأثر الفكري والأدبي والثقافي
1. الأثر الفكري
• تعزيز الوعي: يساهم الديوان في رفع الوعي بالقضية الفلسطينية وقضايا الأمة، من خلال تقديم رؤية نقدية جريئة.
• تحريض الضمير: يشكل الديوان صرخة ضد الظلم والخيانة، مما يحفز القراء على التفكير والنقاش والتحرك.
2. الأثر الأدبي
• إثراء الشعر السياسي والمقاوم: يضيف الديوان لمسة معاصرة للشعر الملحمي، مستخدمًا لغة حديثة مع الحفاظ على الأصالة.
• نموذج للشعر الملتزم: يمكن اعتبار الديوان مرجعًا لأدب المقاومة في العصر الحديث، حيث يجمع بين العمق الفني والرسالة الوطنية.
3. الأثر الثقافي
• توثيق الذاكرة الجمعية: يحفظ الديوان أحداثًا ومعاناة قد تهمل أو تُنسى، مما يجعله جزءًا من الذاكرة الثقافية العربية.
• الحفاظ على الهوية: يعزز الديوان الانتماء العربي والإسلامي من خلال التأكيد على الرموز والقيم المشتركة.
4. الأثر العلمي
• مادة للدراسات النقدية: يمكن أن يكون الديوان موضوعًا للبحث الأكاديمي في مجالات الأدب المقارن، تحليل الخطاب، أو الدراسات الثقافية.
• تفاعل مع التراث: يقدم الشاعر حوارًا مع التراث العربي والإسلامي، مما يفتح آفاقًا للدراسات البينية بين القديم والحديث.
ديوان “العاديات إلى الأقصى” للدكتور سلطان إبراهيم ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو وثيقة أدبية وتاريخية تعبر عن روح الأمة وتطلعاتها. يجمع بين العمق الفني والالتزام الأيديولوجي، مما يجعله نموذجًا متميزًا لأدب المقاومة في العصر الحديث. يؤكد الديوان على دور الشعر كوسيلة للمقاومة والتغيير، ويسهم في إثراء الحركة الأدبية والثقافية العربية، كما يظل شاهدا على معاناة شعبٍ وصدق شاعر.
4. ديوان (طوفان الأقصى):
يُمثِّل ديوان “طوفان الأقصى” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم عبد الرحيم محمد وثيقة أدبية ونضالية تخلّد أحداثًا تاريخية ومعاصرة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بمسجد الأقصى وغزة والمقاومة. يبرز الديوان كمشروع شعري ملتزم يجسد معاناة الشعب الفلسطيني ويوظف اللغة العربية ببلاغة عالية، ممزوجةً بروح الإيمان والثورة. يضم الديوان مجموعة من القصائد التي كتبت في فترات زمنية مختلفة، لكنها تشكل نسيجًا واحدًا يعبر عن هموم الأمة وآمالها.
التحليل النقدي للأبعاد الفنية والموضوعية
1. البنية الموضوعية والفكرية
• الروح النضالية: يتجلى في الديوان تمسك الشاعر بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية، مع التركيز على رمزية الأقصى وغزة كأيقونات للصمود.
• البعد الديني والتاريخي: يستحضر الشاعر الرموز الإسلامية (كالصحابة، والأبطال التاريخيين) ويوظفها في سياق معاصر لتعزيز الروح المعنوية وتذكير الأمة بمجدها التليد.
• النقد السياسي والاجتماعي: يوجه الشاعر انتقادات لاذعة للأنظمة العربية والعالم الغربي بسبب صمتها أو تواطئها مع الاحتلال، كما في قصيدة “هي وحدها” التي تُظهر خيبة الأمل من الدور العربي الرسمي.
• التفاعل مع الأحداث الجارية: كثير من القصائد كُتبت على هامش أحداث محددة (مثل اقتحام الأقصى، عمليات المقاومة، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة)، مما يجعل الديوان سجلاً أدبياً حياً لتلك اللحظات.
2. البنية الفنية والأسلوبية
• اللغة والشعرية: يتميز أسلوب الشاعر بالجزالة الثراء المعجمي والصور البلاغية المُفعمة بالحركة والعاطفة، مع استخدام متكرر للمحسنات البديعية والاستعارات والتشبيهات التي تعكس حالة الصراع والأمل.
• الإيقاع والقافية: اعتمد الشاعر على بحور الشعر التقليدية (كالطويل والكامل والرجز) مع تنويع في القوافي لتناسب موضوع كل قصيدة، مما يعكس براعته في صياغة الشعر العمودي.
• التكرار والرمزية: يُكرر الشاعر رموزًا مثل “الطوفان”، “الأقصى”، “الشهداء”، “القدس”، مما يعمق تأثيرها النفسي والرمزي في نفس المتلقي.
• الحوارية والخطاب المباشر: في كثير من القصائد يخاطب الشاعر الأعداء أو الأمة أو رموز المقاومة (كـ يحيى السنوار)، مما يخلق حوارًا دراميًا مؤثرًا.
3. الأبعاد النفسية والعاطفية
• العاطفة الجياشة: يمتزج الحزن والألم بالغضب والأمل في نصوص الديوان، مما يعكس حالة الوجدان الجمعي للشعب الفلسطيني.
• التسامي بالنفس البشرية: يصور الشاعر الشهداء والمقاومين كأبطال خالدين، مما يعزز قيم التضحية والإيمان لدى المتلقي.
تقييم الأثر الفكري والأدبي والثقافي لديوان “طوفان الأقصى”
1. أدب المقاومة والالتزام: تجسيد المعاناة وتحفيز الصمود
يمثل الديوان نموذجًا راقيًا لأدب المقاومة الذي لا يقتصر على سرد المعاناة، بل يتحول إلى سلاح معنوي وفكري يواجه محاولات طمس الهوية والقضية. من خلال توظيف الرموز الدينية والتاريخية (مثل الصحابة والأبطال المعاصرين مثل يحيى السنوار)، يعيد الشاعر بناء خطاب مقاوم يستند إلى مرجعية إسلامية وعربية أصيلة.
• الأثر الفكري: يُعمق الديوان مفهوم المقاومة بوصفها ضرورة أخلاقية ودينية، وليس مجرد رد فعل سياسي.
• الأثر الأدبي: يرفع مستوى أدب المقاومة من خلال الجمع بين البلاغة الكلاسيكية والموضوعات المعاصرة، مما يخلق نصوصًا قابلة للدراسة والنقد كأعمال فنية متكاملة.
• الأثر الثقافي: يحفز الديوان على إنتاج أعمال أدبية وفنية أخرى تعبر عن القضية الفلسطينية، مما يساهم في بناء أرشيف ثقافي مقاوم يتحدى الرواية الصهيونية.
2. التوثيق التاريخي الشعري: تسجيل الأحداث برؤية فنية
يقدم الديوان توثيقًا أدبيًا حيًا لأحداث مفصلة (مثل اقتحام الأقصى، عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة). هذا التوثيق لا يقتصر على السرد، بل ينقل المشاعر والتأملات الجمعية في لحظات فارقة.
• الأثر الفكري: يحول الديوان الأحداث اليومية إلى جزء من الذاكرة الجمعية، مما يمنع طمسها أو تشويهها.
• الأثر الأدبي: يخلق تقليدًا جديدًا في التوثيق الشعري الذي يجمع بين السرد التاريخي والتعبير الجمالي.
• الأثر الثقافي: يساهم في حفظ التاريخ الشفوي للقضية الفلسطينية، خاصةً في ظل غياب التوثيق الرسمي أو تحيز الوسائل الإعلامية.
3. التأثير في الوعي الجمعي: تعزيز الهوية والمسؤولية
يعمل الديوان على تنشيط الوعي العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية من خلال خطاب عاطفي وعقلاني يجذب شرائح متنوعة (الشباب، المثقفين، العامّة).
• الأثر الفكري: يذكر الأمة بمسؤوليتها الدينية والتاريخية تجاه القدس وفلسطين، ويحفز على التفكير النقدي في أسباب الضعف والهزيمة.
• الأثر الأدبي: يخلق لغة شعرية موحدة تعبر عن هموم الأمة، مما يعزز الشعور بالانتماء إلى هوية مشتركة.
• الأثر الثقافي: يشكل الديوان مرجعًا في الخطاب الثقافي المعاصر الذي يدعو إلى الوحدة والتضامن، خاصةً في ظل التحديات السياسية والثقافية التي تواجه العالم العربي.
4. إثراء الحركة الأدبية: الجمع بين الأصالة والحداثة
يتميز الديوان بأسلوب يجمع بين الأصالة الشعرية (الوزن والقافية والبلاغة الكلاسيكية) والموضوعات المعاصرة الملحة، مما يجعله جسرًا بين التراث والحداثة.
• الأثر الفكري: يثري النقاش حول دور الأدب في معالجة القضايا المعاصرة، وكيفية توظيف التراث لخدمة الحاضر.
• الأثر الأدبي: يقدم نموذجًا للشعر الملحمي الحديث الذي يمكن أن يدرس في الأوساط الأكاديمية كجزء من تطور الشعر العربي المعاصر.
• الأثر الثقافي: يحفز الشعراء والأدباء على تجريب أشكال جديدة تعبر عن هموم الأمة دون التخلي عن الجذور الثقافية والدينية.
5. نقد الواقع السياسي: جرأة في طرح الأسئلة المحرجة
لا يتردد الديوان في نقد الأنظمة العربية والعالمية بسبب تواطئها أو صمتها تجاه القضية الفلسطينية. هذا النقد لا يعتمد على العاطفة فقط، بل على تحليل واقعي يستند إلى قيم العدالة والأخلاق.
• الأثر الفكري: يثير أسئلة حول المسؤولية الأخلاقية للفرد والمجتمع والدولة، ويحفز على مراجعة المواقف والسياسات.
• الأثر الأدبي: يطور تقليدًا أدبيًا للنقد السياسي من خلال الشعر، حيث يصبح الشعر وسيلة للتعبير عن الرأي وتغيير الوعي.
• الأثر الثقافي: يساهم في خلق ثقافة المساءلة والنقد البناء، مما يعزز المشاركة المجتمعية في القضايا المصيرية.
يُعد ديوان “طوفان الأقصى” أكثر من مجرد عمل أدبي؛ فهو مشروع ثقافي متكامل يسعى إلى:
• توحيد الخطاب الثقافي حول القضية الفلسطينية.
• تثقيف الأجيال الجديدة على قيم المقاومة والانتماء.
• تحويل الشعر إلى أداة فاعلة في المعركة الفكرية والثقافية.
• خلق تراث أدبي مستمر يتحدى محاولات التهميش والنسيان.
بهذا، يصبح الديوان جزءًا من الحراك الثقافي الأوسع الذي يعيد تعريف دور المثقف والأديب في زمن الأزمات، ويؤكد أن الكلمة لا تزال قادرة على هز أعتى الجبابرة.
الفصل الرابع: تحليل أدبي نقدي لقصيدة (كوسوفا الإباء)
“كوسوفا الإباء”
هُنا أرض الدموع مع الدماء ** وفي البلقان كوسوفا الإباء
هنا الإسلام يسري في الحنايا ** بقلب الطيبين بلا رياءِ
هنا التاريخ يحكي للبرايا ** أقاصيص البطولة في جلاء
هنا شعبٌ يتوقُ إلى حياةٍ ** ويأبى ذاك صُناعُ الشَّقاء
فقد هاجت خفافيش الدياجي ** لوأد الصُبح في قبر المساء
وكم أورى الطغام سعير حقدٍ** بتميز مقيتٍ وازدراءِ
وكم قد حاربوا الإسلامَ جهْرًا **وكم هدموا المآذن في اجتراء
وكم بطشوا بأطفال صغار** وألقوا بالضحايا في العراء
وعاث المجرمون بكل ربع ** فسادًا في جنونٍ وانتشاءِ
وبات المسلمون بلا أمانٍ** وأضحى الصرب أفتكَ مِن وباء
كأنَّ الصرب طوفان الرزايا** يُدَمِّر ما يقابل مِن بناء
دَوِيُّ رصاصهم في كُلِّ وادٍ ** مضى غدْرًا لحصد الأبرياء
وكم هدموا المنازل واستباحوا ** أفانين الجرائم في غباءِ
وكم قد أحرقواغرسًا وزرعًا ** وما رحموا استغاثات النساء
فآهاتٌ تشق الصخر شقًّا ** وأنَّاتٌ تُقَطِّرُ بالعناء
تمادى بغيهم ليمسَّ عِرضًا ** فيا للهول مِن وقع البلاء
فأسسنا لنا جيشًا يُفادي ** ربوع بلادنا يوم النداء
ولم نأبه بإرعاد وبطش** وسرنا نرتجي نصر اللواء
على درب التحرر قد مضينا ** وفَجَّرنا ينابيع الفداء
نزعنا الفجر من شدق الدياجي ** وسطرنا الملاحم بالعطاء
فلاحت للورى أنوار حَقِّ ** وعمَّ الأرض فيضٌ من ضاءِ
وولَى الصرب وانهزموا وخابوا ** وجاء النصرُ مِن ربِّ السماء
تعد قصيدة “كوسوفا الإباء” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم نموذجًا بارزًا للشعر السياسي الوطني المقاوم، الذي يوثق لواحدة من أقسى الفترات في التاريخ الإسلامي الحديث، وهي مأساة شعب كوسوفا على يد القوات الصربية في تسعينيات القرن الماضي. لا تكتفي القصيدة بسرد الأحداث، بل ترفعها إلى مستوى الملحمة، حيث تتحول المعاناة إلى مصدر للقوة، والظلم إلى باعث على المقاومة، والهزيمة الظاهرية إلى نصر مؤزر بإرادة الله ثم بإرادة الشعب. تمتزج في القصيدة عناصر عدة: التاريخية، والدينية، والوطنية، والوجدانية، لتخلق نصًا أدبيًا قويًا يخاطب العقل والقلب معًا.
التحليل النقدي الموسع
1. الفكرة المركزية والموضوعات الرئيسية
تدور الفكرة المركزية للقصيدة حول ثنائية الظلم والمقاومة، أو المأساة والنصر. فهي تصور رحلة شعب من حالة الضحية المستسلمة إلى المقاوم المنتصر، مع التأكيد على أن هذا النصر هو نتاج إيمان راسخ وإرادة صلبة وتضحية عظيمة.
الموضوعات الرئيسية المتفرعة من هذه الفكرة:
• تصوير المأساة والإبادة: يركز الشاعر على تفصيل الفظائع التي ارتكبت بحق الشعب المسلم في كوسوفا (تدمير المساجد، قتل الأطفال، التطهير العرقي) لخلق صورة حية تثير التعاطف والغضب.
• الإيمان كمنبع للقوة: يربط الشادر بين الهوية الإسلامية للشعب الكوسوفي وبين صموده. فالإسلام هنا ليس مجرد دين، بل هو روح المقاومة وسبب التمسك بالكرامة (“هُنا الإسلام يسري في الحنايا”).
• نقد الغطرسة والطغيان الصربي: يتم تصوير القمع الصربي ليس كعمل عسكري فحسب، بل كعمل همجي ينم عن حقد أعمى وغرور (“كأنَّ الصرب طوفان الرزايا”).
• البطولة والصمود: يحول الشاعر معاناة الشعب إلى ملحمة بطولية. فالمقاومة هنا هي فعل إنساني نبيل يهدف لاستعادة الحق والحياة الكريمة (“وفَجَّرنا ينابيع الفداء”).
• النصر الإلهي والبشري: يجمع الشاعر بين عنصرين أساسيين في النصر: التخطيط البشري والعمل الجاد (“أسسنا لنا جيشًا يُفادي”) والعون الإلهي (“وجاء النصرُ مِن ربِّ السماء”)، مما يعطي الرسالة بعدًا روحياً واقعياً.
2. السمات الأسلوبية والبلاغية
تمتلك القصيدة ترسانة بلاغية غنية تعزز معناها العاطفي والفكري:
• الطباق (المقابلة): يستخدم الشاعر التقابل بين المفاهيم لخلق تأثير درامي قوي:
o أرض الدموع مع الدماء ↔ كوسوفا الإباء
o خفافيش الدياجي (قوى الشر) ↔ وأد الصبح (قمع الخير)
o صناع الشقاء ↔ شعب يتوق إلى حياة
o قبر المساء ↔ نزعنا الفجر
هذا الطباق يبرز حدة الصراع بين قوى الخير والشر.
• التشبيه والاستعارة: يستخدم الشاعر صورًا مجازية قوية:
o تشبيه الصرب بـ “طوفان الرزايا”: يوحي بالقوة التدميرية العمياء التي لا تميز بين شيء.
o تشبيههم بـ “الوباء”: يشير إلى طبيعة خطرهم المعدية والفتاكة التي تنتشر في كل مكان.
o استعارة “خفافيش الدياجي”: للدلالة على قوى الشر التي تنتعش في الظلام (الظلم) وتكره النور (الحرية والحق).
o استعارة “نزعنا الفجر من شدق الدياجي”: صورة بطولية مذهلة، حيث يحول المقاومون الظلام إلى نور بقوتهم وإرادتهم.
• التكرار: يستخدم التكرار لتأكيد المعنى وخلق إيقاع عاطفي متصاعد:
o تكرار كلمة “هُنا” في البداية للتأكيد على مكانية الحدث وأهميته.
o تكرار أداة التوكيد “قد” (“قد مضينا”، “كم قد حاربوا”).
o تكرار أداة الاستفهام “كم” للتكثير من جرايم الصرب وإثارة emotion الحزن والاستنكار في نفس المتلقي (“وكم أورى”، “وكم هدموا”، “وكم بطشوا”).
• اللغة والصور الحسية: اللغة مباشرة وقوية ومشبعة بالصور المؤثرة التي تخاطب الحواس:
o السمع: “دَوِيُّ رصاصهم”، “آهاتٌ تشق الصخر”، “أنَّاتٌ تُقَطِّرُ”.
o البصر: “أقاصيص البطولة في جلاء”، “أنوار حق”، “تهديم المآذن”.
o اللمس/الإحساس: “يسري في الحنايا”، “واقع البلاء”.
هذه الصور تجعل التجربة حية وملموسة للقارئ.
• الإيقاع والقافية: اعتمد الشاعر على بحر الطويل أو المتقارب الذي يعطي وقارًا وجلالاً يناسب طبيعة الملحمة. والقافية الموحدة (الاءِ/اءْ) تعطي انسيابية موسيقية وتوحد القصيدة ككل متماسك.
3. البناء الفني للقصيدة
يمكن تقسيم القصيدة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
1. الاستهلال (المقدمة الملحمية): (من البيت الأول إلى الثالث) حيث يقدم الشاعر المكان (كوسوفا) والشعب (حامل الإسلام والإباء) والصراع كجزء من تاريخ البطولة.
2. جسد القصيدة (ذروة المعاناة): (من البيت الرابع إلى السادس عشر) وهو قسم طويل يفصّل فيه الشاعر فظائع الصرب ومعاناة الشعب، مستخدمًا أسلوبًا سرديًا دراميًا لوصف المأساة.
3. الختام (ذروة المقاومة والنصر): (من البيت السابع عشر إلى الأخير) حيث يتحول المشهد من السلبية والمعاناة إلى الإيجابية والفعل، لينتهي بانتصار الحق وهزيمة الباطل، مع إرجاع الفضل إلى الله.
تقييم الأثر الأدبي والسياسي
• الأثر الأدبي: تقف القصيدة كوثيقة أدبية خالدة لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية. إنها تنقل الشعر من دائرة الذاتية والغزل إلى دائرة الهم الإنساني الجماعي. تعيد القصيدة إحياء دور الشعر الكلاسيكي في الحماسة والمناصرة، مع استخدام أدوات عصرية في الصورة والتكثيف. تعتبر إضافة نوعية للأدب المقاوم الذي يوثق للقضية الكوسوفية بشكل خاص، والقضايا الإسلامية المظلومة بشكل عام.
• الأثر السياسي: للقصيدة بعدٌ توعويٌ وسياسيٌ كبير. فهي:
o كسر لحاجز الصمت: ساهمت مثل هذه القصائد في تسليط الضوء على الجريمة التي كانت قد تُرتكب بعيدًا عن أعين العالم في ذلك الوقت.
o تعبئة المشاعر: حركت المشاعر العربية والإسلامية تجاه قضية ربما كان الكثيرون يجهلون تفاصيلها، مما يخلق رأيًا عامًا ضاغطًا.
o تخليد الذاكرة: تحولت القصيدة إلى نصب تذكاري أدبي يحفظ ذكرى الضحايا ويحذر من повтор التاريخ.
o تأكيد الهوية: تؤكد على الهوية الإسلامية لكوسوفا وتاريخها المجيد، مما يعزز من شرعية نضالها internationally.
“كوسوفا الإباء” ليست مجرد أبيات من الشعر، بل هي صرخة إنسان، ورواية شاهد، وملحمة شعب، وأنشودة نصر. استطاع الدكتور سلطان إبراهيم عبر لغته القوية وصوره المبتكرة وإحساسه المرهف أن يختزل مأساة بأكملها في إطار شعري مكثف، يجمع بين دقة الوصف وقوة التعبير وصدق العاطفة. نجح الشاعر في تحويل الألم إلى فن، والمعاناة إلى مصدر إلهام، والهزيمة إلى أمل. تبقى القصيدة شاهدًا أدبيًا على أن الكلمة يمكن أن تكون سلاحًا في معركة الحق ضد الباطل، وأن الشعر يمكن أن يكون خندقًا من خنادق المقاومة ووسيلة لتخليد الذكرى وبناء المستقبل.
الفصل الخامس: تحليل أدبي نقدي لقصيدة (كفاح كوسوفا)
“كفاح كوسوفا”
اسكب دموع الوجد تجري أنْهُرا
فدماء كوسوفا تسيل على الثرى
وابعث أنينك والوجيب رسائلا
تترى إلى كُل المدائن والقُرى
فالخطب والهفاه يُعجز أحرفي
ما كُنت أحسب أن أُشاهد ما أرى
يا أمة المليار أين جيوشكم
لتُعيد للمظلوم حقًا مُهْدَرا
يا أُمة حفظ الزمان نضالها
كيف السكوت على الدنية يا تُرى؟!
الآن يقتات الردى بلقاننا
الآن كوسوفا تباعُ وتُشترى
والصرب قد عاثوا بكل ربوعها
فمتى تردُّ الذئبّ أسادُ الشَرى؟
وبأي حقٍّ تستباح حصونها
وبأي وجهٍ شعبها مَن يُزدرى؟!
بالأمس كانت صرخة استنجاد في
أقصى الدُنا تدعو الجموع لتثأرا
واليوم كوسوفا تنادي أمة
أتيجبُ أم غرقت بأحلام الكَرى؟
يا أمتي هذا الأسى قد زاد عن
حدِّ البيان هُنا وفاق تَصَوُّرا
نصب اللئام لأهلها فخ الردى
وسعى لطمس حقيقة بين الورى
قد أخرجوا الأهلين من بلدانهم
وأتوا بغيرهمُ فخاب من افترى
فأبى ليوث الحقِّ أن يتنازلوا
عن حقِّهم وتسابقوا نحو الذُُّرا
قد أسرجوا خيل الجهاد وأسسوا
جيشًا يُكافحُ كي يعودَ مُظَفَّرا
هذي بشائر نصره لاحت فلا
خوف فمن صدق الفدا لن يُكسرا
تعد قصيدة “كفاح كوسوفا” للشاعر الدكتور سلطان إبراهيم وثيقة أدبية نابضة بالألم والحس الوطني والقومي، وشاهداً شعرياً على واحدة من أعظم المآسي الإنسانية في العصر الحديث؛ مأساة شعب كوسوفا المسلم على يد القوات الصربية في تسعينيات القرن العشرين. لا تكتفي القصيدة بتسجيل الأحداث وإنما تتجاوز ذلك إلى استنطاق الضمير العربي والإسلامي، وتوبيخه على صمته وتقاعسه، وتحويل المأساة من مجرد خبر إعلامي إلى قضية شخصية وجمعية. يجسد الشاعر من خلال بنائها الفني المتين وموسيقاها الحادة ومفرداتها الموحية، معنى المقاومة ويخلد صورة الصمود، محولاً الألم إلى فعل، واليأس إلى أمل.
التحليل النقدي
1. الفكرة المركزية والموضوعات الفرعية
• الفكرة المركزية: تدور القصيدة حول المأساة المزدوجة؛ الأولى هي المأساة المادية المتمثلة في الاحتلال الصربي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعب كوسوفا. والثانية، والأكثر إيلاماً في سياق القصيدة، هي المأساة المعنوية المتمثلة في تخاذل وتغافل “أمة المليار” المسلمة عن نجدتهم.因此، الفكرة المركزية هي نداء استغاثة يتحول إلى استنكار واستفزاز للضمير الجمعي، مقترناً بتأكيد على أن طريق الخلاص الوحيد هو بالاعتماد على الذات والجهاد.
• الموضوعات الفرعية:
o التأريخ للألم والظلم: تصوير مأساة كوسوفا بتفاصيلها المروعة من سيل الدماء، وتهجير الأهالي، وطمس الحقائق، وبيع الأرض وشرائها سياسياً.
o النقد اللاذع للتخاذل العربي والإسلامي: يتجلى هذا في نداءات الاستفهام الاستنكارية الموجهة للأمة (“يا أمة المليار أين جيوشكم”، “كيف السكوت على الدنية يا تُرى؟!”).
o تمجيد المقاومة والصمود: تصوير نضال شعب كوسوفا (“أبي ليوث الحق أن يتنازلوا”) وتحويلهم من ضحايا مستضعفين إلى أبطال مقاتلين (“قد أسرجوا خيل الجهاد”).
o التفاؤل والأمل في النصر: الخاتمة المفعمة بالثقة بالنصر القادم (“هذي بشائر نصره لاحت”، “من صدق الفدا لن يُكسرا”).
2. السمات الأسلوبية واللغوية
تمتلك القصيدة ترسانة أسلوبية قوية جعلتها مؤثرة ومتماسكة:
• النداء والخطاب المباشر: يستخدم الشاعر أسلوب النداء بشكل مكثف (“يا أمة المليار”، “يا أمتي”) لخلق حالة من المواجهة المباشرة مع المتلقي، وكسر حاجب الصمت والحياد، وجعل القضية حية وملحة.
• الاستفهام الإنكاري: تسيطر أسئلة الاستنكار على نسيج القصيدة (“أين جيوشكم؟”، “بأي حق؟”، “بأي وجه؟”، “أتِيجبُ أم غرقت؟”). هذه الأسئلة ليست طلباً للمعلومة بل هي اتهامات موجعة وتقريع للضمير.
• المقابلة والتباين: يعتمد الشاعر على التقابل لخلق صورة درامية صارخة:
o الماضي النضالي المجيد للأمة مقابل حاضرها المذل (“يا أُمة حفظ الزمان نضالها… كيف السكوت”).
o أمس الاستنجاد مقابل اليوم الغارق في السبات (“بالأمس كانت صرخة… واليوم كوسوفا تنادي”).
o فعل الصرب الوحشي (“عاثوا”، “يقتات الردى”) مقابل تقاعس الأمة.
o “الذئاب” (الصرب) مقابل “أساد الشرى” (أبناء كوسوفا).
• التصوير البياني:
o الكناية: “اسكب دموع الوجد تجري أنهرا” كناية عن شدة الحزن والعجز.
o التشخيص: “الآن يقتات الردى بلقاننا” حيث شخّص “الردى” (الموت) وجعله كائناً مفترساً يتغذى على جثث الضحايا.
o الاستعارة: “وبأي حقٍّ تستباح حصونها” حيث شبه كوسوفا بالحصون المنيعة التي تم اختراقها. و”غرقت بأحلام الكرى” شبه التخاذل بحالة من النوم والغرق في الأحلام.
o الطباق: بين “يقتات الردى” و “تسابقوا نحو الذُّرى”، وبين “الخطب يعجز أحرفي” و “هذي بشائر نصره لاحت”.
• الموسيقى والإيقاع:
o اعتمد الشاعر على بحر الطويل الذي يُعد من أكثر البحور احتمالاً للمواقف الجليلة والخطب المؤثرة، لما يتسم به من بطء وجلال يناسب موضوع الرثاء والحماسة.
o وحدة القافية (الروي) على حرف الراء المفتوح (ـَ را)، وهو حرف قوي مفتوح يعطي إحساساً بالاستمرارية والاتساع والنداء، مما يعزز معاني الاستغاثة والاستنفار التي تموج بها القصيدة.
3. البناء الفني للقصيدة
• المقدمة (البيتان الأول والثاني): تبدأ بتهيئة عاطفية للمتلقي، بدعوته إلى مشاركة الألم والبكاء على المأساة، مع الإشارة إلى عجز اللغة عن وصف الفاجعة.
• صُلب الموضوع (من البيت الثالث إلى منتصف القصيدة): هنا ينتقل الشاعر من البكاء إلى التوبيخ والاستنكار، موجهاً سهام نقده إلى الأمة المتخاذلة، وراصداَ فظائع الاحتلال الصربي بشكل مباشر وقاس.
• منعطف المقاومة (من “فأبي ليوث الحق…”): يمثل هذا البيت منعطفاً crucial في القصيدة، حيث ينتقل التركيز من حالة الضحية إلى حالة البطل. يتغير المشهد من السلبية إلى الإيجابية، ومن التخاذل إلى الفعل.
• الختام (البيتان الأخيران): يختتم الشاعر قصيدته بنبرة تفاؤلية مشرقة، مبتعداً عن لوعة البداية وحيرة الوسط، مؤكداً على يقين النصر نتيجة للصدق والتضحية، مما يمنح القصيدة والأمة معاً بصيص أمل.
تقييم الأثر الأدبي والسياسي
• الأثر الأدبي: تقف القصيدة ضمن تيار “شعر المقاومة” و”الشعر الإسلامي” المعاصر. فهي تستعيد روح الشعر الحماسي الذي كان يحفز الهمم في العصور القديمة، ولكن في إطار قضية عصرية. أثرها الأدبي يكمن في توثيقها لحظة تاريخية بأدوات عاطفية وجمالية تخلدها في الذاكرة الجمعية أكثر من أي تقرير إخباري. لقد نجحت في تحويل قضية سياسية معقدة إلى قصة إنسانية بسيطة وواضحة، قائمة على ثنائية الظالم والمظلوم، البطل والخائن.
• الأثر السياسي والجماهيري: في وقتها، كانت مثل هذه القصائد سلاحاً معنوياً مهماً. كانت تذكي حماس الجماهير العربية والإسلامية، وتشكل ضغطاً على حكوماتها، وتجعل قضية كوسوفا حاضرة في المساجد والندوات والمنابر الثقافية. لقد ساهمت في تعبئة الرأي العام وتسييس جيل كامل حول قضية كانت تبدو بعيدة. القصيدة لم تكن مجرد تعبير عن واقع، بل كانت محاولة لفعل شيء حياله عبر تحريك المشاعر واستفزاز الشعور بالمسؤولية.
“كفاح كوسوفا” للدكتور سلطان إبراهيم ليست مجرد مجموعة أبيات منسوجة بعناية، بل هي صرخة فنية متعددة الأبعاد. هي مرثية لبشاعة الاحتلال، وهجاء لمرض التخاذل، وأنشودة للحرية والمقاومة، ونبوءة بنصر آت. نجح الشاعر في توظيف أدواته البلاغية والعروضية لخدمة رسالته الإنسانية والسياسية، مخلّداً معاناة شعب كوسوفا في ذاكرة الأدب العربي، ومذكراً الأمة بواجبها وهويتها وقدرتها على صنع النصر عندما تصدق العزيمة وتُسخر الإمكانات. تبقى القصيدة نموذجاً لأدب المقاومة الذي لا ينفصل عن هموم أمته، وشاهداً على أن الكلمة لا تقل قوة عن الرصاصة عندما تُصوّب نحو الضمير.
خاتمة
يختتم هذا المسار النقدي والتوثيقي التأمل في مشروع الشاعر الدكتور سلطان إبراهيم عبد الرحيم محمد، الذي يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين العمق الأكاديمي والحس الشعري الملحمي، بين الالتزام القومي والإسلامي والهم الإنساني الشامل. لقد أثبتت سيرته وإنتاجه أن الشاعر المعاصر يمكن أن يكون صوتًا للضمير الجمعي، ومحركًا للوجدان، وفاعلاً في المعركة الفكرية والثقافية التي تخوضها الأمة.
من خلال تتبع مسيرته، يتجلى لنا كيف أن نشأته الريفية في صعيد مصر وشغفه المبكر باللغة والشكل وعيه الاجتماعي والإنساني، بينما أضاف مساره الأكاديمي المتميز في الدراسات الشرعية والبلاغية والنقدية أدوات منهجية صارمة أثرت نصه الشعري، فجعلته قوي الحجة، متماسك البناء، غني الدلالة.
لم يقتصر إنتاج الدكتور سلطان إبراهيم على الإبداع فحسب، بل امتد ليشمل التأطير النظري عبر أبحاثه الأكاديمية التي تربط التراث بالمعاصرة، وتكشف عن آليات اشتغال الخطاب الشعري المناضل. كما أن تنوع إنتاجه بين القصة والشعر، وبين الغزل الوجداني والملحمة الوطنية، يشهد على سعة ثقافته ومرونة موهبته وقدرته على مخاطبة شرائح متعددة.
تحليل دواوينه المركزية – “على أبواب دمشق”، “جذوة القلب”، “العاديات إلى الأقصى”، و”طوفان الأقصى” – فضلاً عن قصائد مثل “كوسوفا الإباء” و”كفاح كوسوفا”، كشف عن مشروع شعري متكامل يقوم على عدة ركائز:
1. التوثيق الأدبي للأحداث الجسام ونقل المعاناة الإنسانية إلى دائرة التخليد الفنّي.
2. بناء خطاب مقاوِم يستند إلى مرجعية إسلامية وعربية أصيلة، ويوظف الرمزية والتقنيات البلاغية لبناء حجة شعرية مقنعة.
3. نقد الواقع بجرأة ووعي، سواء كان واقع الاحتلال والظلم، أو واقع التخاذل العربي والدولي.
4. تحويل الألم إلى أمل، والمعاناة إلى مصدر للإلهام، من خلال التأكيد على قيم الصمود والتضحية والنصر.
لم يعد أثره مقتصرًا على القارئ العادي، بل تجاوزه إلى الحقل الأكاديمي، حيث أصبحت أعماله مناهج للبحث والدراسة في الجامعات، ونوقشت حولها رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يرفعها إلى مصاف الكلاسيكيات المعاصرة التي تدرس من حيث الأسلوب والمضمون.
باختصار، يمثل الدكتور سلطان إبراهيم ظاهرة أدبية متكاملة الأبعاد: شاعر ملتزم، وباحث منهجي، ومفكر واع، ومثقف عضوي ينزل إلى ساحة الهم العام. لقد نجح في أن يجعل من الكلمة سلاحًا، ومن الشعر تاريخًا حيًا، ومن القصيدة نداء يوقظ الضمير ويحرك الإرادة. مشروعه ليس مجرد إضافة إلى المكتبة العربية، بل هو إثراء للحركة الأدبية المعاصرة وتأكيد على أن الشعر لا يزال يحمل رسالته الخالدة: مقاومة النسيان، وتحدي الظلم، وبناء وعي إنساني حر وشريف.
إلى شاعر كوسوفا وأمته – سلطان إبراهيم
إهداء من أ. د. بكر إسماعيل الكوسوفي
سلطانُ، يا صوتَ الضميرِ الحرِّ في زمنِ العناءْ
يا من جعلتَ كوسوفا أنشودةً تمحو أسى الأرجاءْ
أطلقتَ فينا من حروفكَ شعلةً
تُذكي الفؤادَ وتوقظ الأحياءْ
رسمتَ بالدمعِ المصيرَ، وبالندى
نقشتَ في وجداننا معنى الإباءْ
كوسوفا بَينَ ضفافِ نيلكَ قد غدتْ
وطناً يطلُّ على البلقانِ في أبهى ضياءْ
قد بايعتْكَ قصائدُ النصرِ التي
أطلقتَها “كفاحُها” و”كوسوفا الإباءْ”
فارتاحَ في صدري يقينٌ أنني
ما كنتُ وحدي في دروبِ الشرفاءْ
صرنا أخوَينِ على دربِ الوفا
تجمعنا الأكوانُ في صرحِ السماءْ
فامضِ، فإنَّ الشعرَ ميثاقُ الأُلى
يُبقي القضيةَ حيَّةً رغمَ الفناءْ
التحليل الأدبي النقدي لقصيدة الإهداء
1. الفكرة المركزية والموضوعات
تدور القصيدة حول الاعتراف بالشاعر سلطان إبراهيم ودوره في تحويل مأساة كوسوفا إلى ملحمة شعرية عربية خالدة. الفكرة الأساسية هي: التقدير والامتنان من شاعرٍ كوسوفي إلى شاعرٍ مصري، إذ جمعتهما الكلمة الصادقة في الدفاع عن الحق والحرية.
وتتفرع عنها موضوعات فرعية:
• توثيق حضور كوسوفا في الشعر العربي من خلال سلطان.
• تأكيد دور الكلمة والشعر في مقاومة الظلم وحفظ الذاكرة.
• إبراز العلاقة الأخوية والفكرية بين الكوسوفي والمصري.
• الاحتفاء بقيمة الشعر كرسالة إنسانية خالدة تتجاوز الحدود الجغرافية.
2. السمات الأسلوبية والبلاغية
1. الصور الشعرية:
• استعارة “أطلقتَ فينا من حروفكَ شعلةً” → توحي بالشعر كطاقة إشعاعية توقظ الوعي.
• “رسمتَ بالدمع المصير” → صورة بصرية وجدانية تختزل الألم والتحوّل إلى ملحمة.
• “ضفاف النيل” و”البلقان” كرمزين حضاريين يلتقيان في الكلمة → صورة مكانية رمزية لوحدة العاطفة والرسالة.
2. التكرار:
• تكرار اسم “كوسوفا” يعزز مركزية القضية في النص.
• تكرار أفعال الحركة مثل “أطلقتَ – رسمتَ – نقشتَ – ارتاحَ – صرنا – امضِ” → يمنح النص حركية وديناميكية.
3. الطباق والمقابلة:
• “الموت ↔ الحياة”، “الدمع ↔ الضياء” → تعكس جدلية الألم والأمل.
4. الإيقاع والموسيقى:
• النص ليس ملتزمًا بالوزن الخليلي التقليدي، لكنه يميل إلى إيقاع حرّ قائم على القافية الموحدة أحيانًا (الإباء – الضياء – السماء – الفناء).
• هذا الإيقاع يمنحه جرسًا موسيقيًا مؤثرًا وقريبًا من روح القصيدة العمودية التي كتبها سلطان إبراهيم.
3. البناء الفني
• الافتتاحية (الأبيات 1–3): يبدأ الشاعر بتوجيه التحية لشاعر الضمير سلطان، ويبرز دوره في جعل كوسوفا أنشودة عربية.
• جسد النص (الأبيات 4–8): يتوسع في تصوير أثر القصائد “كوسوفا الإباء” و”كفاح كوسوفا”، وبيان أنها صارت مصدر يقين وأمل للشعوب المقهورة.
• الذروة (الأبيات 9–10): يعكس وحدة المصير بين الكوسوفي والمصري، باعتبارهما أخوين على درب الوفاء.
• الختام (البيتان الأخيران): دعوة للاستمرار في حمل الرسالة الشعرية؛ لأن الشعر ميثاق للحق ووسيلة لتخليد القضايا العادلة.
4. الأثر الأدبي والوجداني
1. الأثر الأدبي:
القصيدة تشكّل نموذجًا شعريًا للحوار الثقافي والأدبي بين الشعوب، وتُجسّد كيف يمكن للشعر أن يكون جسرًا للتواصل بين مصر وكوسوفا. هي نص إهدائي لكنه يحمل مقومات النص الشعري المقاوم، من حيث العاطفة الصادقة، الصور البلاغية، والإيقاع الملحمي.
2. الأثر الوجداني:
تترك القصيدة أثرًا عاطفيًا قويًا؛ لأنها لا تكتفي بالمديح، بل تحوّل الامتنان الشخصي إلى رسالة إنسانية مفادها: أن الشعراء الحقيقيين لا يكتبون لأنفسهم بل لأمتهم.
3. القيمة الرمزية:
النص يربط بين مكانين (النيل – البلقان) وبين شاعرين (مصري – كوسوفي) وبين قضيتين (فلسطين – كوسوفا). بهذا يتجاوز النص حدود المجاملة الشعرية ليصبح وثيقة رمزية لوحدة الأمة.
التقييم الختامي
قصيدة الإهداء ليست مجرد تحية لشاعر، بل هي نص أدبي قائم بذاته، يجمع بين البعد العاطفي (الامتنان) والبعد الفكري (تثمين دور الشعر المقاوم). لغتها صافية، صورها رمزية ووجدانية، وبناؤها متماسك. ورغم كونها غير مقيدة تمامًا بالوزن الخليلي، إلا أنها تحتفظ بإيقاع داخلي يقرّبها من الأذن العربية ويجعلها مؤثرة.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
[email protected]