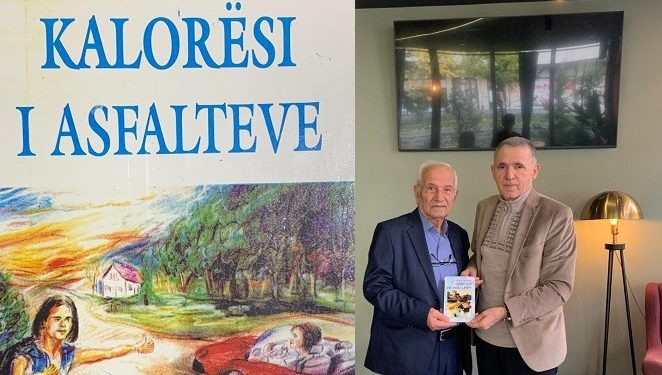المعلم المنفي والشاعر المقاوم: تجربة نجات سعد الله في مرآة قصيدتي “رسالة إلى الجد” و”رسالة من أنقرة”
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
E-mail: [email protected]
السيرة الذاتية للشاعر نجات سعد الله
نجات سعد الله: سيرة شعرية في قلب التحولات
يُمثِّل الشاعر نجات سعد الله (مواليد قرية توري، 22 سبتمبر 1948) نموذجًا فريدًا للمثقف العضوي الذي انصهرت تجربته الحياتية بنتاجه الإبداعي. نشأ في كوسوفا الشرقية (جنوب صربيا حاليًا)، في بيئة سياسية مضطربة وشديدة القمع ضد الهوية الألبانية، فشكَّلت ذاكرة النضال الوطني والواقع الاجتماعي المُعاش مادته الأولية الخام.
تلقى تعليمه في تيرنوفس ثم في المدرسة الكلاسيكية والأكاديمية التربوية في بريزرن، حيث تشبَّع بالحركة الثقافية الألبانية النشطة. عمل لاحقًا مدرسًا للغة الألبانية بين عامي 1974 و1987، وهي فترة حاسمة تبلورت فيها رؤيته التربوية والأدبية معًا. لم يكن منفصلًا عن هموم مجتمعه، فانخرط في العمل السياسي مبكرًا كأحد مؤسسي حزب العمل الديمقراطي (PVD) عام 1990، ليكون صوتًا للأقلية الألبانية في صربيا.
بعد انتقاله إلى فوش كوسوفا عام 1997، واصل عطاءه التربوي والأدبي، مؤسسًا المجموعة الأدبية “نعيم فراشيري” ومتحف فوش كوسوفا، في إطار مسعاه الحثيث للحفاظ على الذاكرة والتراث. تجسِّد قصائده تمازجًا عميقًا بين الحس الوطني الملحمي والبعد الفلسفي التأملي، بعيدًا عن السردية التسجيلية المباشرة. إنما ينحت صورًا شعرية متداخلة تختزل العلاقة الجدلية بين الإنسان والمكان والطبيعة والتاريخ، معتمدًا على ترميز شعري مكثف وتراكبٍ لأزمنة متعددة (الماضي الأسطوري، الحاضر القاسي، المستقبل المتطلع)، ليقدم نصوصًا تحتمل قراءات متعددة، وتقاوم النسيان.
مقدمة
استعادة الذات في زمن التهجير: قراءة في شعرية الخطاب والذاكرة عند نجات سعد الله
تشكل تجربة النفي والتهجير القسري البنية التحتية للكثير من النتاج الإبداعي في أدب الأقليات المضطهدة. وفي هذا الإطار، تأتي قصيدتا “رسالة إلى الجد” و”رسالة من أنقرة” للشاعر نجات سعد الله، كنموذجين مكثفين لسيرورة تشظي الهوية والبحث عن معنى للوجود على حافة الهاوية. لا تنفصل هاتان القصيدتان عن السياق البيوغرافي للشاعر، الذي دفع ثمن هويته فُصِل من عمله، وتعرَّض للملاحقة، وأُجبر على مغادرة مسقط رأسه.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نقدي شامل للقصيدتين، لا بوصفهما وثيقتين تاريخيتين فحسب، بل بصفتهما نموذجين شعريين متكاملين يعيدان إنتاج تجربة الاغتراب الداخلي والخارجي. سنتتبع من خلال أدوات التحليل النصي الآليات البلاغية والأسلوبية التي يوظفها سعد الله لبناء عالمه الشعري، من خلال ثنائيات الضد: الحميمية مقابل العلنية، الوطن مقابل المنفى، الذاكرة مقابل النسيان، والصمود مقابل الاستسلام. كما سنكشف كيف تتحول الرسالة الشخصية الموجهة إلى الأقرباء (الجد، الزوجة) إلى خطاب جمعي، يخاطب من خلاله الأمة بأسرها، معيدًا تشكيل الوعي الجمعي في مواجهة آلات التهميش والإقصاء. تقف هذه القراءة على منعطفين أساسيين في تجربة سعد الله: أحدهما ذاتي بحت (الحوار مع الجذر والجد)، والآخر خارجي قسري (الحوار من قلب المنفى)، لتقدم معًا رؤية شاملة لأزمة المثقف العالق بين مطرقة السلطة وسندان الهوية.
تحليل نقدي أدبي شامل للقصيدة “رسالة إلى الجد” للشاعر نجات سعد الله
قصيدة: رسالة إلى الجد
قيل لي إنك سئمت
من السأم
يأخذ الحصان إلى المرعى
كل يوم للرعي
أرجوك لا تعمل شيئًا
فقد أتعبك الزمن بما فيه الكفاية
أنا الآن أعمل كبناء
أضع الطوب بمهارة
في الطوابق
علمتني كيف أحب العرق
لأنه يجعلك نقيًا
من أجل حياة جيدة
أحفظ الكلمات والذكريات
يا جدي
مثلك في العام
ألف وتسعمائة واثني عشر
عندما في بوتشوك في كومانوفو
أنقذت بالمال
والدك
سأعمل كل يوم يا جدي
ويومًا ما مرة أخرى بمذكراتي
سأدخل إلى الفصل
حفيدك مرفوع الرأس
وسأعلمهم التاريخ
بالكلمة الملتهبة
سأعود يا جدي
عندما ينضج القمح
سانت غالن، 1990
العنوان: “رسالة إلى الجد”
يضع العنوان على الفور نبرة الحميمية والطابع الشخصي والمناجاة للقصيدة. إنها ليست مجرد إهداء، بل هي رسالة – وهي صيغة اتصال تعني المسافة الجسدية، والغياب، والرغبة في خلق اتصال عبر الكلمة. “الجد” ليس مجرد سرد عن شخص، بل هو خطاب مباشر، نداء يجعل شخصية الجد محور العالم العاطفي والأخلاقي للقصيدة. يعد العنوان بحوار بين الأجيال، حيث يلتقي الماضي والمستقبل في حاضر الكتابة.
المقدمة: الحميمية وسأم المنفى
تبدأ القصيدة بملاحظة لطيفة وقلقة:
“قيل لي إنك سئمت / من السأم”
تكرار كلمة “سئمت” يؤكد على حالة وجودية. إنه ليس مللًا مؤقتًا، بل سأم عميق ومزمن، ينبع من السأم نفسه – شعور بالفراغ، وعدم الاستقرار، والانفصال. هذه البداية تضع الحالة النفسية لكلا الشخصيتين: الجد في سأمه الشيخوخي وانعزاله، والحفيد في سأمه من المنفى والترحال. صورة الحصان الذي يُؤخذ إلى المرعى “كل يوم” هي استعارة بسيطة لكنها قوية لحياة الروتين والعدم التقدير، مما يبرز التباين بين سلامة عودة الجد البسيطة إلى الطبيعة واضطراب حياة الحفيد.
الخاتمة: الوعد والعودة المتحدية
نهاية القصيدة هي قسم ووعد بالمستقبل:
“سأعود يا جدي / عندما ينضج القمح”
هذه النهاية محملة بالرمزية. “عندما ينضج القمح” لا تشير فقط إلى المحاصيل الزراعية، بل هي استعارة لنضج الظروف السياسية، لتلك اللحظة المأمولة التي ستكون فيها الأرض، والأمة، والحرية “ناضجة” لاستقبال عودته. هذه خاتمة لا توفر إغلاقًا، بل تحمل أملًا مشروطًا ورغبة غير محققة، تعكس واقعًا مشتركًا للعديد من الألبان في المنفى.
أبرز السمات الأسلوبية
1. اللغة البسيطة والشبيهة بالنثر: يستخدم صادولاهو لغة نقية، خالية من الزخارف المفرطة. الكلمات يومية، مختارة بعناية لخلق نبرة صدق وحقيقة عاطفية. هذه البساطة تجعل القصيدة ملموسة ومؤثرة، مؤكدة أن عظمة الرسالة تكمن في القيم البسيطة والإنسانية.
2. التقابل بين الأجيال: تبنى القصيدة حوارًا مستمرًا بين عالمين:
• الجد والحصان (حياة تقليدية، زراعية، ارتباط بالأرض) مقابل **الحفيد والطوب** (حياة جديدة قسرية، عمل بدني في البناء، منفى).
• الذكريات التاريخية (1912، معركة كومانوفو) مقابل **الأمل بالمستقبل** (العودة إلى الفصل، تدريس التاريخ).
هذا التقابل ليس تناقضًا، بل استمرارية. الحفيد يأخذ دروس جده (يقدر العرق) ويطبقها في سياق جديد، معطيًا إياها معنى جديدًا.
3. الأزمنة وتدفق الزمن: تتحرك القصيدة ببراعة بين الأزمنة المختلفة.
• الحاضر: عمل الحفيد كبناء وقلقه على الجد.
• الماضي القريب: ذكريات الطفولة ودروس الجد.
• الماضي البعيد (التاريخي): عام 1912 وإنقاذ جده (جد الشاعر) لوالده.
• المستقبل: الوعد بالعودة وأن يصبح معلمًا.
هذا التشابك الزمني يظهر أن الهوية الشخصية مبنية بعمق على الذاكرة الجماعية والتاريخية.
4. الرموز القوية:
• العرق: رمز للعمل، والنزاهة، والنصيحة الأخلاقية التي “تجعل المرء نقيًا”. إنها القيمة التي تربط الأجيال.
• الطوب والجدار: لا يمثلان فقط العمل القسري للمهاجر، بل أيضًا البناء الجديد، الأمل في بناء شيء جديد في المنفى، بل هي استعارة أيضًا لبناء مستقبل الأمة.
• الفصل والتاريخ: يمثلان أدوات الكفاح الفكري للشاعر. الرغبة في العودة كمعلم لتعليم التاريخ “بالكلمة الملتهبة” هي بيان سياسي ومهمة وطنية.
الفكرة المركزية للقصيدة
الفكرة المركزية للقصيدة هي الصمود واستمرارية الهوية الألبانية من خلال الذاكرة، والعمل، والالتزام بين الأجيال، في ظل ظروف الاضطهاد والترحال. القصيدة هي رفض قوي لليأس. من خلال الحوار مع الجد، يبني الشاعر جسرًا بين الماضي البطولي (الإنقاذ في عام 1912) والوضع الحالي الصعب (العمل كبناء في المنفى)، مستخدمًا ذلك الجسر لتخطيط مستقبل يعيد فيه للمعرفة والأمة ذاكرتهما. إنها قصيدة تحول الألم الشخصي إلى واجب وطني.
تقييم الأثر
يجب فهم أثر هذه القصيدة وأعمال نجات سعد الله بشكل عام في سياق التطهير العرقي المنهجي للألبان في وادي بريشيفو، ميدفيدجا، وبويانوفتش تحت نظام ميلوسيفيتش.
الأثر الفكري والعلمي: قصائد مثل “رسالة إلى الجد” خدمت كوثيقة شهادة تاريخية. إنها تشهد على واقع الاضطهاد، وفقدان العمل (كمعلم)، والإجبار على الهجرة. إنها تسعى لإثارة وعي نقدي بمصير هذه المنطقة، برفع القضية من المستوى المحلي إلى مستوى الدراما الوطنية الألبانية.
• الأثر الأدبي والشعري: أتى صادولاهو بصوت أصيل من أطراف الأمة المضطهدة إلى الأدب الألباني. أسلوبه البسيط، الشبيه بالنثر، لكنه عاطفي عميق ورمزي، فتح الطريق أمام شكل تعبيري جديد. أظهر أن الشعر الحقيقي يمكن أن ينبع من جذور التجربة الشخصية والوطنية العميقة، دون الحاجة لخطاب منمق.
• الأثر الثقافي: أصبح عمله نقطة مرجعية ثقافية للألبان في وادي بريشيفو وما وراءه. أعطى صوتًا وكرامة لتجربتهم، محولاً إياها من مأساة فردية إلى جزء من السرد الثقافي الأوسع للألبان. التقدير للعمل، والشرف، وذكرى التاريخ الذي يمجده يؤكد على قيم أساسية في الثقافة الألبانية.
• الأثر السياسي: في سياق القمع المنهجي للهوية الألبانية، كانت قصيدة صادولاهو فعل مقاومة. رغبة الحفيد في العودة وتعليم التاريخ “بالكلمة الملتهبة” كانت نقيضًا مباشرًا لسياسة الصربقة ومحو الذاكرة التاريخية. كانت تصريحًا بأن الكفاح من أجل الحقوق سيستمر حتى عبر الوسائل الثقافية والتعليمية.
الخاتمة
“رسالة إلى الجد” لنجات سعد الله هي أكثر من مجرد رسالة شخصية؛ إنها وصية أدبية. تلتقط ألم التهجير، لكنها ترفض التشاؤم. من خلال بنية بسيطة ولغة نقية، تبني عالمًا غنيًا بالمعاني حول العلاقة بين الأجيال، والقوة المنقولة للذاكرة، والالتزام ببناء المستقبل. كصوت خرج من إحدى أكثر مناطق الأمة اضطهادًا، تركت علامة لا تمحى على الخريطة الثقافية والسياسية الألبانية، لتبقى شهادة عنيدة على صمود وأمل شعب.
تحليل نقدي أدبي شامل لقصيدة “رسالة من أنقرة” للشاعر نجات سعد الله
رسالة من أنقرة
– إلى زوجتي رجية –
1.
وأنتِ قلتِ لي
أن أسلك الطريق
وأن أتصل بالطمأنينة
لأن
الجميع كانوا يقولون لي
انفصالي للبلدة
نعتوني
عدوًا للشعب
قلتِ لي ابتعد
اذهب إلى تركيا لفترة
وحدكم كنتم تحبونني
هنا في الأناضول
الحر والقيظ يسود
أبحث عن الراحة فلا أجدها
حياتي فيها فراغ
اليوم تنزهت مع الصديق راميز
عرفني على “نخبته”
في ضريح أتاتورك كنا في الصباح
قابلت رمضان أيضًا
قالوا لي عنه إنه كان قد تحدث
مع أتاتورك ذات مرة بالألبانية
أيها جدي
كم كنت ستحسدني
لأنني – حفيدك الفاضح
في قصر حصار
أتجول بمرسيدس
وفي قصر يلدز في كوشاداسي
2.
هنا لا ينقصني شيء
لكنني أشعر بأنني غريب
كم اشتقت
لـ أنَئِيدَنْ
والآن فقط الدمع والهم
أحملهما في ذاكرتي لها
هل سعادِ يدرس؟
أعلم أن الأصحاب يضايقونه
وهو لا يتحمل
فليتحمل
سيقولون له أن والده
من العمل طردوه
ستموتون من الجوع
لا أحد ليطعكم
سيُجرح في كبريائه
سأشعر في روحي
موجة الذل
لكن دعيه يغذي كبرياءه
زوجتي المعذبة
اهتمي أيضًا
بلوني الصغير
أأصبح مشاكسًا؟
سمعت أن رجال الشرطة
يومًا ما قد أساؤوا معاملته
لكنني افتخرت
فقط في المساء نمت نومًا هنيئًا
أصبعا لوني
أغضبا الصف الثالث
وصبيًا صربيًا (شكينا) ولد
نشيد المستقبل يُغنى
3.
أنا عنيد ومتشدد
لا أهدأ
الأم حتمًا تتضجر
لأن لديها ابنٌ عنيد
والآن هي كالمهندس
تقيس وتعيد قياس الساحة
بوشاح من النار في حضنها
وأنت أيتها الزوجة-الأم
كيف تمضين أيامك؟
لو كنت تعلمين أن مع سلك السياج
ربما لما تزوجت أبدًا
لكنني هكذا أنا
لا أغيّر نفسي
حقًا أنا عنيد مشاكس
لكنكِ قلتِ لي أن أبتعد قليلاً
كي تغسلي أعصابكِ بطمأنينة
لغيابي
أنا لست الملام
4.
قررت أن أعود
الحنين أخذني
إلى طين تيرنوفتس والتلميذ الذي يفتقدني
هنا الصالونات تضايقني
لكنني لم أجلس مكتوف اليدين
قمت بعملٍ قليلٍ من أجل وطني
لا تعاقبوني على هذا
مع تلاتٍ وأصدقاء آخرين
اليوم وضعت إكليلاً أسود
أمام سفارة الصرب (الشكيين)
في وسط أنقرة
زوجتي المتألمة
لا تخافي من رجال الشرطة
لأنه حتى في فرانيا ونيش
لن يرسلوني
ولكن عندما أعود
لا تدعي الخوف يقترب
من رأس همي هذا
في تيرنوفتس
ربما لا أحد سيكلمني
لأنهم يخافون أن نثيروا المرض (المشكلة)
لأنهم اتهموني
وبدلت نشيد الدولة
ولهذا فصلوني
لكنكم كنتم تحبونني
وأنا أحبكم
لذلك سأعود سريعًا
حتى لو صار البحر اللبن الرائب
أنا أرغب في ريح أرضي
أنقرة، 1988
رسالة من أنقرة – إلى زوجتي رجية
المقدمة
“رسالة من أنقرة” لنجات سعد الله ليست مجرد قصيدة غنائية، بل هي وثيقة شعرية، شهادة مؤلمة عن النزوح وتأمل عميق في هوية الألباني من وادي بريشيفا تحت ضغط الأنظمة السلافية. كُتبت في عام 1988، عشية تفكك يوغوسلافيا وتصاعد القمع ضد الألبان، تتحول القصيدة من رسالة خاصة موجهة إلى الزوجة إلى بيان علني للمقاومة واحتجاج ضد عبثية الاضطهاد السياسي. من خلال بنية بسيطة على شكل رسالة، يخترق صادولاهو جوهر المأساة الشخصية والجماعية، مستكشفًا موضوعات النبذ والتهميش والحنين والبحث المتواصل عن الانتماء. السياق السيرة الذاتية للشاعر – الذي فُصل من عمله كمدرس وأُجبر على مغادرة مسقط رأسه بسبب تهم زائفة – هو القلب النابض لهذا العمل، مما يمنحه أصالة وقوة عاطفية نادرة.
أبرز السمات الأسلوبية
1. الأسلوب الرسالي والنبرة الحميمة: شكل الرسالة الموجهة إلى زوجته، رجية ، يخلق إحساسًا بالباشرية والحميمية العاطفية. يصبح القارئ شاهدًا على محادثة خاصة مليئة بالحنين والخوف والذكريات والهموم العميقة. هذا الأسلوب يجعل القصيدة مباشرة، ملموسة وشخصية للغاية.
2. التقابل الحاد (المقابلة): يستخدم صادولاهو التقابل كأداة رئيسية لتسليط الضوء على مفارقة وضعه.
• المنفى الجسدي مقابل الوجود الروحي: هو جسديًا في الأناضول، لكن روحه في تيرنوفتس.
• الغنى الخارجي مقابل الفقر الداخلي: “هنا لا ينقصني شيء / لكنني أشعر بأنني غريب”. مرسيدس والقصور تقابل “طين تيرنوفتس”.
• “الانفصالي” (العدو) في عيني النظام مقابل حب العائلة: “وحدكم كنتم تحبونني”.
• الرفاهية القسرية في تركيا مقابل البساطة المرغوبة في الوطن.
3. لغة بسيطة، مباشرة وسيرة ذاتية: تتجنب القصيدة اللغة المنمقة والاستعارات المجردة. بدلاً من ذلك، تستخدم لغة سردية نقية تشبه السرد المكتوب. هذه البساطة تجعل الألم أكثر صدقًا والاتهامات أكثر وضوحًا. عبارات مثل “قلت لي ابتعد / اذهب إلى تركيا لفترة” أو “فصلوني” تمتلك قوة توثيقية.
4. استخدام السخرية والتهكم: يستخدم الشاعر السخرية لإظهار عبثية الموقف.
• “أيها جدي / كم كنت ستحسدني / لأنني – حفيدك الفاضح / في قصر هيسار / أتجول بمرسيدس”. هنا يسخر من الجنة القسرية، عالماً أن جده كان سيفهم أن هذا ليس نجاحًا، بل اغتراب.
• وصف لقائه “بالنخبة” والزيارات للأماكن الفاخرة مشبع بشعور مرير، مؤكدا أن لا شيء من هذا يرضي روحه.
5. الرموز والصور:
• طين تيرنوفتس: رمز للجذور، الأصل، البساطة والوطن الحقيقي.
• حر الأناضول: انعكاس لحر عدم الاستقرار والاغتراب في المنفى.
• نشيد الدولة / نشيد المستقبل: رمز للسلطة الدولة والانتماء القومي. اتهامه بـ “تبديل” النشيد هو استعارة لمقاومته الثقافية والسياسية.
• سلك السياج: استعارة زراعية للحياة الصعبة وغير المتوقعة التي تنتظر العائلة إذا عاد.
6. التكرار والتوازي: تكرار عبارات مثل “لكنكم كنتم تحبونني / وأنا أحبكم” و “سأعود” يؤكد إصرار الشاعر والارتباط الوثيق بالعائلة والوطن.
الفكرة المركزية للتلخيص
الفكرة المركزية لـ “رسالة من أنقرة” هي مفارقة هوية الألباني المضطهد: المُعلن عنه “غريبًا” و”عدوًا” في وطنه الأم، لكنه يشعر بأنه “غريب” حتى في الملجأ القسري. تطور القصيدة هذا الموضوع من خلال ثلاثة أركان رئيسية:
1. رفض الانصياع: رفض الشاعر “تغيير نفسه” والخضوع للضغط (“لكنني هكذا أنا / لا أغيّر نفسي”). هو يقبل لقب “المشاكس” كوسام شرف.
2. قوة الذاكرة والحنين للوطن: الحنين إلى مسقط الرأس ليس رومانسيًا، بل ملموسًا وجسديًا (“طين تيرنوفتس”، “ريح أرضي”). الذكريات عن العائلة والمخاوف اليومية التي يعيشونها (الشرطة، سوء معاملة الأطفال) هي خريطة روحه.
3. المقاومة كواجب: فعل كتابة هذه الرسالة والقرار بالعودة، بغض النظر عن المخاطر، هو فعل مقاومة. إنه يثبت أن عمله “من أجل الوطن” لم يتوقف وأن العودة هي جزء من هذه المعركة.
تقييم التأثير
“رسالة من أنقرة” تتجاوز الإطار الأدبي البسيط لتترك تأثيرًا متعدد الأبعاد:
1. التأثير الأدبي والشعري: أصبحت القصيدة نموذجًا لأدب ألبان وادي بريشيفا وبشكل أوسع، لأدب المنفى والمقاومة. أظهرت أن الشعر يمكن أن يكون أداة توثيقية وسياسية دون أن يفقد قوته الغنائية. أسلوبها المباشر والسير ذاتي فتح الطريق لأصالة جديدة في الشعر الألباني.
2. التأثير السياسي والاجتماعي: العمل هو شهادة ثابتة على القمع المنهجي ضد الألبان في يوغوسلافيا آنذاك. إنه يشهد على آليات الاضطهاد السياسي (“انفصالي للبلدة”، “عدو الشعب”), والفصل من العمل والإرهاب النفسي. بالمعنى الأوسع، أصبح صوتًا لقضية الألبان في الأراضي العرقية في صربيا، مما أعطى وجهًا إنسانيًا لمأساة جماعية.
3. التأثير الثقافي والفكري: عززت القصيدة الوعي الثقافي والقومي داخل المجتمع. أظهرت أن الهوية الألبانية يمكنها البقاء حتى تحت أعتى ضغوط الاستيعاب. أصبح عمل صادولاهو رمزًا للمثابرة والوفاء للغة والثقافة والأرض، مما ألهم جيلًا كاملًا من المثقفين.
4. التأثير العلمي (في الدراسات الاجتماعية): كنص أدبي، تخدم “رسالة من أنقرة” كمصدر قيم للباحثين والمؤرخين وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الذين يدرسون:
• ديناميكيات الهوية تحت الضغط.
• طرق المقاومة المدنية والثقافية.
• التاريخ الشفوي وتجارب الألبان في فترة يوغوسلافيا الاشتراكية.
في نهاية “رسالة من أنقرة” لنجات سعد الله ليست مجرد أغنية حنين؛ إنها عمل بعمق إنساني وسياسي استثنائي. من خلال أسلوب بسيط لكن قوي، تكشف مأساة إنسان دفع به النظام إلى المنفى، لكنه يرفض أن ينفي وطنه من قلبه. فكرتها المركزية – البحث عن الانتماء في عالم يستبعدك من جميع الجهات – تمنحها صدى عالميًا. كوثيقة تاريخية، وكبيان سياسي وكعمل فني رفيع، تظل “رسالة من أنقرة” واحدة من أبلغ الشهادات وأقواها على الصمود الروحي لألبان وادي بريشيفا، تاركة بصمة لا تمحى على الحياة الأدبية والثقافية والسياسية لمجتمعها وبشكل أوسع.
خاتمة
استراتيجيات الصمود: من خطاب الذاكرة إلى تشريح المنفى
ختامًا، يمكن القول إن قصيدتي نجات سعد الله، “رسالة إلى الجد” و”رسالة من أنقرة”، تشكلان معًا ديوانًا واحدًا متماسكًا عن ألم الوجود الألباني تحت وطأة التهجير. إذا كانت “رسالة إلى الجد” تمثل الحفر العميق في الذاكرة والجذور لاستنباط قوة الصمود، فإن “رسالة من أنقرة” تمثل تشريحًا دقيقًا لجروح المنفى والاغتراب. معًا، تكمل القصيدتان بعضهما: الأولى تبحث عن الشرعية النضالية في الماضي، والثانية تختبر صدقية هذه الشرعية في محكمة الحاضر القاسي.
لقد نجح سعد الله، من خلال هذين العملين، في تحويل تجربته الشخصية الأليمة إلى خطاب شعري مكثف، يمتلك أدواته البلاغية الخاصة. لم يقع في فخ الخطابية المباشرة أو الشعاراتية، بل قدّم رؤيته من خلال تفاصيل إنسانية حميمة وعالم شعري غني بالرموز والتقابلات. إن قوة هذا الشعر لا تكمن فقط في قدرته على توثيق المرحلة، بل في قدرته على مقاومة النسيان وإعادة تأكيد الوجود. إنه شعر يرفض أن يكون ضحية، ويصر على أن يكون شاهدًا ومقاومًا في آن واحد.
بهذا، يقدم نجات سعد الله نموذجًا للمثقف الذي يحوّل السيرة الذاتية إلى سيرة جماعية، والجرح الشخصي إلى وعي جمعي، مؤكدًا أن الكلمة، في زمن العسف، يمكن أن تكون أقوى من الرصاصة، وأن الذاكرة، في زمن التهجير، هي آخر وطن.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
E-mail: [email protected]