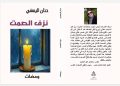الأديبة السورية جمال حسين عبيد: ذاكرة الحرف وإبداع الأنثى العربية – دراسة تقييمية شاملة
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
E-mail: [email protected]
مقدمة
في عالم الأدب، ثمة أصوات تُسمع، وأخرى تُخلّد؛ لأنها تحمل من الجوهرية ما يجعلها سجلاً للذاكرة الجمعية ومرآة عاكسة لتفاعل الإنسان مع محيطه. تُعد الأديبة السورية جمال حسين عبيد من هذه الأصوات الخالدة، التي لم تكن كتاباتها مجرد انعكاس لوجدان شخصي، بل كانت مشروعاً ثقافياً شاملاً، نسجته بخيوط من اللغة المشرقة، والتجربة الحياتية الثرية، والرؤية الإنسانية المتعمقة.
تبدو عبيد كـ”ناسخة للوجود”؛ تنقل تفاصيل الحياة والأمكنة والإنسان إلى فضاءات الأدب، محوّلة إياها من واقع مادي إلى استعارة جمالية تحمل دلالات فكرية وفلسفية. من موطنها الأم سوريا، إلى محطاتها في الجزائر والإمارات، وصولاً إلى انعكاس رحلتها إلى كوسوفا في بؤرة قصيدتها، تشكّلت لديها رؤية فريدة جعلت من “الرقي” قيمة عليا، ومن “التسامح” سلاحاً وجودياً.
لذلك، لا تهدف هذه الدراسة إلى مجرد رصد سيرة ذاتية أو تعداد إصدارات، بل تسعى إلى تشريح هذا المشروع الإبداعي متعدد الأبعاد. ستعتمد الدراسة على منهج تحليلي نقدي، يتتبع التكوين الأكاديمي والمسيرة المهنية للأديبة كأساس بنيوي، ثم يغوص في عالمها الإبداعي لاستخلاص سماتها الأسلوبية والفنية، ليصل إلى تقييم أثرها في الحقول الفكرية والتربوية والثقافية. كما ستحلل الدراسة، كمحور رئيسي، قصيدتها “من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها” كنموذج مكثّف يجسّد تجسيداً حياً لفلسفتها في الأدب والحياة، والذي يضعها في مصاف المبدعين الذين يوظفون الكلمة لبناء وعي جديد، قائم على ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الموت، وعلى الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة صراعات التاريخ.
الفصل الأول: التكوين الأكاديمي والمسار المهني – الأسس البنيوية للتجربة
1.1. الجذور والتكوين الأكاديمي:
تنحدر الأديبة من سوريا، مهد الحضارات واللغات، مما منحها عمقاً تاريخياً وثقافياً. حصولها على ليسانس الأدب العربي من جامعة بيروت العربية لم يكن مجرد شهادة أكاديمية، بل كان بوابة لتشرب اللغة في أصفى صورها، في مدينة هي بمثابة مختبر ثقافي عربي.
2.1. المسار المهني: التربية كرسالة ثقافية:
يمثل مسارها المهني محوراً أساسياً في فهم خطابها الإبداعي:
• مرحلة التأسيس في دمشق (1969-1973): حيث صقلت مهاراتها التعليمية في البيئة التي شكلت وعيها الأول.
• الامتداد المغاربي في الجزائر (3 سنوات): كانت هذه المرحلة محورية في توسيع دائرة فهمها للعربية في سياقها المغاربي، والتعرف على روافد ثقافية جديدة، مما أضاف بعداً آخر لهويتها.
• الاستقرار والعطاء في الإمارات العربية المتحدة (حتى 2016): تمثل هذه الفترة الذهبية لإسهاماتها، حيث تطور دورها من معلمة إلى:
• خبيرة في تعليم العربية لغير الناطقين بها: مما يدل على تملكها العميق لأسرار اللغة وآليات نقلها.
• مشرفة على تطوير المناهج: وهو دور قيادي يعكس الثقة في رؤيتها التربوية وقدرتها على التأثير في المنظومة التعليمية.
3.1. إتقان اللغة الإنجليزية كجسر ثقافي:
لم يكن إتقانها للغة الإنجليزية مجرد مهارة تقنية، بل كان أداة استراتيجية مكنتها من:
• الانفتاح على الآداب والنظريات النقدية العالمية.
• تمكين حوار ثقافي أكثر فعالية، وهو ما تجلى لاحقاً في ترجمة بعض نصوصها ضمن موسوعات أدبية.
الفصل الثاني: المشروع الإبداعي – التشريح النصي والسمات الفنية
1.2. تعدد الأجناس الأدبية: تنوع في الوحدة:
تمتلك الأديبة مشروعاً إبداعياً غنياً ومتنوعاً، يجمع بين:
• المقالة الأدبية: كما في كتاب “على هامش الحياة”، حيث تتحول المقالة إلى نص سردي شاعري، ممزوجاً بروح القصة.
• القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً: كما في “نقوش من الذاكرة” و”موسوعة محطات من الذاكرة”، حيث تبرز مقدرتها على التكثيف واختزال المعنى في مشاهد موحية.
• الشعر: في “قصائد في رحاب القدس” و”ومضات شعرية”، حيث يمتزج الوجدان الشخصي بالهم العام.
2.2. السمات الأسلوبية المميزة:
• اللغة الشاعرية الرصينة: تستخدم لغة محكمة، غنية بالصور البيانية، ولكن دون تعقيد، مما يجعل نصوصها قابلة للتلقي على مستويات متعددة.
• المزج بين الذاتي والموضوعي: فالنص لديها يحمل نبض الواقع ودفء الإنسان، حيث لا ينفصل التأمل الذاتي عن الاهتمام بالهم الإنساني العام.
• التكثيف والومضة: خاصة في إصداراتها الموسوعية مثل “الومضة” و”ومضات نابضة”، حيث تبلغ ذروة فنها في اختزال الفكرة أو المشهد في بضع كلمات تحمل شحنة عاطفية وجمالية عالية.
الفصل الثالث: الأثر والفاعلية – تقييم الدور في الحياة الفكرية والثقافية
1.3. الأثر التربوي والتعليمي:
يمكن تقييم أثرها في هذا المجال من خلال:
• تخريج أجيال: من خلال عقود من التدريس، أسهمت في تشكيل الوعي اللغوي والأدبي لأجيال في ثلاث دول عربية.
• تطوير المناهج: كان لإشرافها على تطوير مناهج اللغة العربية في الإمارات أثر مباشر في تطوير العملية التعليمية وملاءمتها للسياق المحلي والعالمي.
• نقل اللغة والثقافة: من خلال تعليم العربية لغير الناطقين بها، قامت بدور سفيرة ثقافية، تنقل صورة راقية عن الثقافة العربية.
2.3. الأثر الثقافي والأدبي:
• التنظيم الثقافي: من خلال عضويتها ورئاستها لشعبة القصة القصيرة في ملتقى الشعراء العرب، لم تكن مجرد مشاركة، بل كانت قائدة رأسمال ثقافي، حيث ساهمت في رعاية المواهب الجديدة وتنظيم الحركة الأدبية.
• التواصل عبر المنصات: نشرها في صحف ومجلات مرموقة مثل مجلة الرأي وجريدة الخليج ومجلة أزهار الحرف وسع من دائرة قرائها وأكد على حضورها الإعلامي والفكري.
• الموسوعية والإنتاج الغزير: إسهاماتها في موسوعات مثل “قصص عابرة للقارات” و”من أزاهير الأدب” تضعها في سياق المشروع الجماعي لتوثيق الإبداع العربي المعاصر ونقله عبر اللغات.
3.3. الأثر السياسي والديبلوماسي الثقافي:
• الخطاب المقاوم الرمزي: يمثل كتاب “قصائد في رحاب القدس” نموذجاً لأدب المقاومة والالتزام بالقضية الفلسطينية، حيث يستخدم الإبداع كأداة للمقاومة الثقافية والتعبئة المعنوية.
• الدبلوماسية الثقافية غير المباشرة: مسيرتها بين سوريا والجزائر والإمارات، وإتقانها للغة الإنجليزية، جعل منها جسراً ثقافياً. لقد مثلت نموذجاً للمثقف العابر للحدود، الذي يسهم في خلق صورة إيجابية عن المرأة العربية المثقفة والمنتجة.
الفصل الرابع: قصيدة “من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها” – تشريح الجمالية المقاومة وتقييم الأثر متعدد الأبعاد
من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها
من هناكَ…
من حيثُ تُطلُّ الجبالُ على الذاكرة
وتغسلُ الينابيعُ وجهَ الحنين
تمشّتِ القصيدةُ بينَ أزقّةِ كوسوفا
تُحيّي الحجارةَ التي تحفظُ أنفاسَ التاريخ.
رأيتُ في عيونِ الناسِ
نجومًا تُضيءُ رغمَ رمادِ الحروب
وفي أكفِّهم دفءَ الأرضِ
حينَ تلدُ السلامَ من رحمِ الجراح.
كوسوفا…
يا زهرةً نبتتْ في ليلِ العذاب
وسقتْها العزيمةُ من ندى الصبر
يا وطنًا يشبهُ قوسَ المطر
بعدَ دهورٍ من الغيمِ والدمع.
هناكَ
تعلمتُ أنَّ الرُّقيَّ ليسَ أناقةَ الملبسِ
بل أنْ تُهدي الغريبَ ابتسامةً
وتفتحَ بابكَ للضوءِ دونَ سؤال.
شعبُ كوسوفا…
يكتبُ الحلمَ على كفِّ النهار
ويغسلُ قلبَه بماءِ التسامح
فلا عجبَ أنْ يكونَ الحبُّ دينَه
والوطنُ صلاةً
تُؤدّى على عتبةِ الشمس.
تحليل القصيدة
تمثل القصيدة نموذجاً مكثفاً ومتطوراً للخطاب الشعري عند جمال حسين عبيد، حيث تنتقل من الذاتي إلى الكوني، ومن التأمل الوجداني إلى التوثيق النضالي. ليست القصيدة مجرد انطباع عن رحلة، بل هي بيان شعري وفلسفي يقرأ جغرافيا المكان وروحانيات الإنسان، محولاً زيارة كوسوفا إلى استعارة كبرى عن قدرة الجمال والأخلاق على النهوض من بين أنقاض المأساة. يهدف هذا التحليل إلى تشريح بنية القصيدة ودلالاتها، وتقييم أثرها الفكري متعدد الحقول.
1. تشريح العنوان والبنية: رحلة من المكان إلى المعنى
العنوان: “من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها”
• وظيفية الإطالة: العنوان الطويل ليس وصفياً فحسب، بل هو “عتبة نصية” تضع القارئ في السياق المزدوج للقصيدة: السياق المادي (الزيارة) والسياق الأخلاقي (الرقي). وهو يشي بأن القصيدة ليست عن المكان فقط، بل عن سمو الإنسان الذي يسكنه.
• تضمين الرؤية: استخدام كلمة “رقيِّ” من البداية يحول القصيدة من سرد سياحي إلى دراسة أنثروبولوجية وأخلاقية، مما يرفع سقف التوقع لدى المتلقي.
البنية السردية-التأملية:
تتبع القصيدة مساراً حكائياً واضحاً:
1. الوصف الحسي (المشهدية): “من هناكَ… من حيثُ تُطلُّ الجبالُ…” – تقديم المكان بصور طبيعية حميمة.
2. التحول إلى الاستعارة: “تمشّتِ القصيدةُ…” – حيث يتحول المكان إلى كائن حي يتفاعل معه الإبداع نفسه.
3. ملاحظة الإنسان: “رأيتُ في عيونِ الناسِ…” – الانتقال من الطبيعة إلى البشر، مركز الثقل في القصيدة.
4. الخطاب المباشر والاستعارة الميتافيزيقية: “كوسوفا… يا زهرةً…” – تحويل كوسوفا إلى كيان مجازي.
5. الحكمة والخلاصة الفلسفية: “هناكَ تعلمتُ أنَّ الرُّقيَّ…” – حيث تبلور الشاعرة الدرس المستفاد من الرحلة.
6. التتويج بالرمز الديني: “شعبُ كوسوفا… فلا عجبَ أنْ يكونَ الحبُّ دينَه / والوطنُ صلاةً…” – وهي ذروة التطور الفكري والروحي في النص.
2. الفكرة المركزية: الرقي كفعل مقاومة وجودية
الفكرة المحورية التي تدور حولها القصيدة هي إعادة تعريف مفهوم “الرقي”. لا تعني الكلمة هنا التطور المادي أو الثقافي التقليدي، بل تعني “الأخلاق كمنهج حياة وكسلاح للبقاء”. الرقي الحقيقي، وفق رؤية الشاعرة، هو القدرة على:
• الحفاظ على الإنسانية في قلب اللاإنسانية (“نجومًا تُضيءُ رغمَ رمادِ الحروب”).
• تحويل المعاناة إلى منبع للعطاء (“حينَ تلدُ السلامَ من رحمِ الجراح”).
• ممارسة الكرم والتسامح كخيار وجودي، وليس كرد فعل (“أنْ تُهدي الغريبَ ابتسامةً / وتفتحَ بابكَ للضوءِ دونَ سؤال”).
• تقديس الحياة والوطن عبر حب يتعالى على الانتقام (“يغسلُ قلبَه بماءِ التسامح”).
هكذا، يتحول “الرقي” من صفة سلبية إلى فعل مقاومة نشط ضد ثقافة اليأس والكراهية التي تنتجها الحروب.
3. أبرز السمات الأسلوبية والبلاغية
الاستعارة الميتافيزيقية:
• “تمشّتِ القصيدةُ بينَ أزقّةِ كوسوفا”: الاستعارة التي تحول العمل الأدبي إلى كائن حي يتحاور مع المكان، مؤكدة على أن الإبداع هو الشاهد والوسيط.
• “والوطنُ صلاةً / تُؤدّى على عتبةِ الشمس”: استعارة خلاقة تدمج المقدس الديني (الصلاة) بالمقدس الوطني (الوطن) والكوني (الشمس)، لترسيخ فكرة أن حب الوطن هو عبادة وجودية.
المفارقة:
• “تلدُ السلامَ من رحمِ الجراح”: جمع بين نقيضين (السلام/الجراح) لخلق صورة مذهلة عن قدرة التحول من الألم إلى الأمل.
• “زهرةً نبتتْ في ليلِ العذاب”: الجمع بين جمال الزهرة وقسوة العذاب، لتأكيد فكرة النماء في ظروف المستحيل.
اللغة الرمزية:
• “رماد الحروب”: رمز للدمار والموت، يقابله رمز “النجوم” للأمل الثابت.
• “قوس المطر”: رمز للسلام والوعود الجميلة بعد العاصفة (الحرب).
• “ندى الصبر”: حيث يتجسد الصبر كمادة حياة وري.
الإيقاع الداخلي والنسيج الصوتي:
اعتماد القصيدة على الشعر الحر أتاح لها مرونة بناء الصور. لكن الإيقاع الداخلي يتشكل من خلال التكرار (“من هناكَ… من حيثُ”)، والجمل الفعلية القصيرة التي تحاكي خطوات السائر، والجناس (“الغيم/الدمع”) الذي يوحد بين عناصر الطبيعة والعاطفة.
4. تقييم الأثر متعدد الحقول
1. الأثر الفكري والأدبي:
• تساهم القصيدة في تيار “أدب المقاومة الوجودية” الذي لا يقتصر على مقاومة المحتل بالسلاح، بل يقاومه بالتمسك بقيم الجمال والحب. إنها تقدم نموذجاً لأدب “ما بعد الصراع” الذي يركز على إعادة بناء النفس والمجتمع.
• ترفع القصيدة من شأن “أدب الرحلة” من كونه تسجيلاً للمشاهدات إلى كونه استكشافاً لطبقات الروح والذاكرة الجمعية.
2. الأثر الثقافي والديني:
• تقدم قراءة ثقافية عميقة لشعب كوسوفا (ذو الأغلبية المسلمة)، مع التركيز على قيمه الإنسانية العالمية (التسامح، الكرم، الصبر). هذا يفكك الصورة النمطية ويقدم الإسلام كدين يحض على الحب والتسامح.
• استخدام الرموز الدينية (“دينَه”، “صلاةً”) بطريقة شمولية غير طائفية، يجعل الخطاب قابلاً للتلقي على نطاق واسع، ويؤسس لـ”لاهوت إنساني” يجعل من الحب والتسامح مقاصد عليا.
3. الأثر السياسي والدبلوماسي:
• تمارس القصيدة “دبلوماسية القوة الناعمة” بامتياز. من خلال إبراز الجانب الإنساني لشعب تعرض لمأساة، تبني القصيدة تعاطفاً عالمياً وتذكّر العالم بمسؤوليته الأخلاقية.
• هي عمل سياسي بامتياز، لكن بلسان الشعر. إنها توثق لقضية شعب وتخلد كفاحه، ليس عبر سرد الأحداث، بل عبر تخليد روحه.
4. الأثر النضالي والعلمي (الأنثروبولوجي):
• على المستوى النضالي، تقدم القصيدة سلاح “المقاومة بالذاكرة”. إنها تحول معاناة شعب كوسوفا إلى جزء من الذاكرة الأدبية العربية، مما يخلق تضامناً ثقافياً ويحول القضية من محلية إلى إنسانية.
• يمكن قراءة القصيدة كنص أنثروبولوجي شعري، يدرس “ثقافة الصمود” وآليات تكيف المجتمعات ما بعد الصراع، وكيف تتحول التجارب المؤلمة إلى رأس مال رمزي وأخلاقي.
وأخيراً قصيدة جمال حسين عبيد “من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها” هي أكثر من نص أدبي جميل؛ إنها وثيقة إنسانية شاملة. لقد نجحت الشاعرة في تحويل انطباع الرحلة إلى رؤية فلسفية، ورفعت حديثها عن كوسوفا إلى مستوى الخطاب الكوني عن المعاناة والخلاص. القصيدة هي تأكيد على أن أعلى درجات النضال هي القدرة على الحفاظ على إنسانيتك، وأن أسمى أنواع الرقي هو أن تخرج من أتون المعاناة وأنت أكثر حباً للحياة وتسامحاً مع الآخر. بهذا، تضع جمال حسين عبيد نفسها في مصاف المبدعات اللواتي يوظفن الشعر ليس للتغني بالجمال فحسب، بل لبناء وعي جديد، قائم على ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الموت.
خاتمة: الأديبة جمال حسين عبيد.. سفيرة الحرف ورسولة الرقي
في ختام هذه الدراسة التقييمية الشاملة، يتضح أن الأديبة السورية جمال حسين عبيد لم تكن مجرد كاتبة أو شاعرة تُضاف إلى سجل الأدب العربي، بل كانت مشروعاً ثقافياً متكاملاً يتجاوز حدود الأجناس الأدبية والجغرافيا الوطنية. لقد أسست عبيد بناءً إبداعياً شاملاً، قوامه المتين هو تكوين أكاديمي رصين ومسيرة مهنية عميقة في حقل التربية، ما جعل لغتها تحمل سُلطة المعرفة ودفء التجربة الإنسانية.
إن قوة مشروعها لا تكمن في غزارة إنتاجها الأدبي المتنوع بين القصة، المقالة، والشعر فحسب، بل في ثبات قيمها الأسلوبية، حيث مزجت ببراعة بين الذاتي والموضوعي، وكرّست لغة شعرية رصينة قادرة على التكثيف والاختزال، كما ظهر جلياً في فن الومضة الذي أبدعت فيه.
والمحور الأهم في تقييم أثرها هو فلسفة الرقي والتسامح التي جسدتها قصيدتها “من خلال زيارة الشاعرة إلى كوسوفا ورقيِّ شعبها”. هذه القصيدة ليست مجرد توثيق لرحلة، بل هي بيان شعري وفلسفي يرفع المقاومة من مستوى الفعل المادي إلى مستوى المقاومة الوجودية بالجمال والأخلاق. لقد نجحت عبيد في تحويل معاناة شعب إلى رمز كوني، حيث يصبح “الحب ديناً” و”الوطن صلاة”، ما يؤكد دورها كـدبلوماسية ثقافية تعمل بقوة ناعمة على بناء جسور التفاهم والتعاطف الإنساني العابر للحدود.
باختصار: تُمثل جمال حسين عبيد نموذجاً للمثقف العربي الملتزم، الذي يوظف ذاكرة الحرف لخدمة قضية الوعي والحياة. إنها إحدى رائدات إبداع الأنثى العربية اللواتي لم يكتفين بالانعكاس السلبي للواقع، بل شاركن بفاعلية في صياغة رؤية مستقبلية قائمة على التسامح كقوة مقاومة والجمال كطريق للخلاص. وبهذا، ترسخ مكانتها كـسفيرة دائمة للرقي الإنساني في سجل الأدب العربي المعاصر.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
E-mail: [email protected]