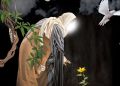يوسف الحَمَلّه: شاعرٌ بين الفصحى والعامية والغنائي
(دراسة أكاديمية في أثره الأدبي والفكري والثقافي والسياسي والدبلوماسي)
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
E-mail: [email protected]
المقدمة
تأتي هذه الدراسة الأكاديمية لتسلِّط الضوء على تجربة شعرية متفرّدة في المشهد الأدبي العربي المعاصر، ممثّلة في شخصية الشاعر يوسف محمد يوسف الحَمَلَّه، الذي وُلد في الخامس من سبتمبر عام 1976 في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ في مصر. فهذه البيئة الريفية ذات الخصوصية الثقافية والاجتماعية ألقت بظلالها العميقة على حساسيته الشعرية، ونحتت جانبًا مهمًا من مخياله ورؤيته للإنسان والطبيعة والقيم. ينتمي الشاعر إلى جيل يمسك بزمام التحوّلات، ويحاول أن يرسم لنفسه ولجمهوره معالم خطاب شعري يتجاوز حدود الشكل إلى آفاق الرمز والهوية والانتماء.
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتجاوز الرصد السيريّ أو العرض البيبليوغرافي لنتاج الشاعر، لتدخل إلى عمق التجربة الإبداعية التي تجمع بين الفصحى والعامية والغنائي، وتستحضر التراث، وتستجيب لأسئلة الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي. فشعر يوسف الحَمَلَّه لا يمكن قراءته بمعزل عن مسارات التحوّل الفكري والثقافي في مصر والعالم العربي، ولا بمعزل عن تأثير التجربة الشخصية التي عبَر من خلالها بين فضاءات الريف والمدينة، وبين اليوميّ والعام، وبين التراث والحداثة.
من هنا، تتبنّى هذه الدراسة منظورًا مركّبًا، يربط بين النص الشعري وسياقاته، وبين الإبداع الفردي وديناميات الجماعة، وبين أثر الشاعر داخل الساحة المحلية المصرية ودوره خارجها عبر حضورٍ أدبيّ وثقافيّ ودبلوماسي متنامٍ. وقد تم تقسيم هذا العمل إلى عدد من الفصول التي تغطي الجوانب التالية:
1. السيرة الذاتية للشاعر بوصفها مدخلاً لتفسير التجربة الشعرية وبنية الوعي.
2. الإنتاج الشعري وتطوّره الفني عبر قراءة تحليلية لدواوينه الأربعة.
3. الأثر الأدبي والفكري للشاعر في ضوء الجمع بين الفصحى والعامية والغنائي.
4. الأثر الثقافي والعلمي والسياسي والدبلوماسي ومدى إسهامه في تشكيل صورة ثقافية لمصر.
5. دراسة نقدية موسّعة لديوان “الفارس المفتون” من حيث أساليبه ورموزه وأثره.
6. تحليل أدبي نقدي لديوان “أمَّاه” بوصفه عملاً يجمع بين الوجدانية والفلسفة والالتزام الأخلاقي.
7. تحليل قصيدة “تحية إلى كوسوفا” بوصفها نموذجًا للدبلوماسية الشعرية والتضامن الإنساني.
إنّ هذه القراءة لا تهدف فقط إلى إبراز جماليات النص، بل تسعى إلى الكشف عن بنية الوعي التي تتحرك داخل الشعر، وعن صورة الإنسان كما يقدّمها يوسف الحَمَلَّه: إنسانٌ مأخوذ بحبّ الأم والوطن، وبقيمة الحرية، وبالمبدأ الأخلاقي، وبالسعي نحو الارتقاء الروحي والفكري.
بهذا المعنى، تقدم هذه الدراسة مساهمة علمية جديدة في تأطير تجربة شاعر يخطّ لنفسه مكانًا واضحًا في خارطة الأدب العربي المعاصر، ويقدّم نموذجًا للتواصل بين الأصالة والحداثة، وبين الشعر والفكر، وبين الأدب والعمل الثقافي العام.
الفصل الأول: السيرة الذاتية كمدخل لفهم التجربة
• الميلاد والنشأة: وُلد يوسف الحَمَلّه في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وهي بيئة ريفية مصرية ذات خصوصية ثقافية واجتماعية، انعكست على حسّه الشعري من خلال حضور الطبيعة والإنسان البسيط.
• التعليم والتكوين: حصل على دبلوم ثانوي تجاري، ثم درس في معهد السياحة والفنادق، قسم الفنادق، كما التحق بالمعهد العربي الإفريقي للسياحة والفنادق. هذا التكوين يعكس انفتاحه على مجالات غير أدبية، مما أضاف إلى تجربته الشعرية تنوّعًا معرفيًا.
• الانخراط المؤسسي: عضويته في “واحة أمير الشعراء”، ورابطة الزجالين وكتاب الأغاني، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، تكشف عن انتمائه إلى شبكات أدبية متعدّدة، تجمع بين المحلي والعالمي.
تحليل: السيرة الذاتية هنا ليست مجرد خلفية، بل هي إطار يفسّر تنوّع تجربته الشعرية، ويكشف عن شاعر يوازن بين الانتماء المحلي والانفتاح العالمي.
الفصل الثاني: الإنتاج الشعري وتطوره الفني
1. ديوان لحن فوق الممر (2015)
• يمثل البدايات، حيث يبرز الحس الموسيقي والرمزي.
• القصائد تحمل نزعة وجدانية، وتكشف عن شاعر يبحث عن صوته الخاص.
2. ديوان الفارس المفتون (2019)
• انتقال نحو البطولة والرمزية التاريخية.
• حضور الفارس كرمز للذات الباحثة عن الحرية والكرامة.
3. ديوان مليكة كوكبي (2024)
• نزعة رومانسية كونية، توظيف الرموز الكوكبية والأنثوية.
• يعكس انفتاحًا على البعد الكوني والإنساني.
4. ديوان أماه (2025)
• عودة إلى الجذور، خطاب وجداني إنساني يربط بين الأم والوطن.
• يعبّر عن علاقة الشاعر بالهوية والانتماء.
تحليل: كل ديوان يمثل مرحلة فكرية، من الذات الفردية إلى الرمز الجمعي، ومن المحلي إلى الكوني، مما يعكس تطورًا متدرجًا في التجربة الشعرية.
الفصل الثالث: الأثر الأدبي والفكري
• التعدد اللغوي: الجمع بين الفصحى والعامية والغنائي يضعه في موقع فريد، إذ يخاطب النخبة والجمهور معًا.
• البعد الإسلامي: انفتاحه على الأدب الإسلامي العالمي يضفي على شعره بعدًا أخلاقيًا وروحيًا.
• المزج بين التراث والحداثة: يوظّف الرموز التراثية بلغة حديثة، مما يجعله جسرًا بين الماضي والحاضر.
تحليل: يوسف الحَمَلّه يقدّم نموذجًا للشاعر الذي يوازن بين الأصالة والحداثة، وبين المحلية والعالمية.
الفصل الرابع: الأثر الثقافي والعلمي والسياسي والدبلوماسي
الأثر الثقافي والعلم
• المؤسسات الثقافية: دوره في تأسيس “واحة أمير الشعراء” يعكس اهتمامه بالحوار الثقافي المحافظ.
• الثقافة الشعبية: إسهامه في رابطة الزجالين وكتاب الأغاني يبرز اهتمامه بالثقافة الشعبية المصرية.
• المادة العلمية: نصوصه الشعرية تُعدّ مادة غنية للتحليل النقدي في مجالات الرمزية والموسيقى الشعرية والهوية الثقافية.
تحليل: شعره ليس مجرد إبداع فردي، بل مادة علمية تُثري النقد الأدبي والدراسات الثقافية.
الأثر السياسي والدبلوماسي
• الأدب الإسلامي العالمي: انتماؤه إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية يضعه في سياق دبلوماسي ثقافي يتجاوز الحدود الوطنية.
• الصورة الثقافية لمصر: شعره الغنائي والوجداني يساهم في بناء صورة مصر الثقافية في المحافل الأدبية.
• الهوية والانتماء: قدرته على التعبير عن قضايا الهوية يجعله صوتًا سياسيًا غير مباشر، يربط بين الأدب والوعي الجمعي.
تحليل: يوسف الحَمَلّه يمارس “دبلوماسية شعرية”، حيث تتحول القصيدة إلى أداة للتواصل الثقافي والسياسي.
الفصل الخامس: تحليل أدبي نقدي موسع لديوان “الفارس المفتون” للشاعر يوسف الحملة
السمات الأسلوبية والفنية للديوان
1. التنوع في الأوزان والقوافي
يتميز الديوان بتنوعه في استخدام البحور الشعرية (كالكامل، الوافر، المتقارب، وغيرها)، مما يعكس براعة الشاعر في التعامل مع الإيقاع الموسيقي للشعر العربي. هذا التنوع يُضفي حيوية على النصوص، ويجعلها قادرة على التعبير عن مشاعر متعددة، من العاطفة الجياشة إلى الحماسة الوطنية.
2. اللغة الشعرية المزيجة بين الخيال والعاطفة
يجمع الشاعر بين اللغة الحسية والمعنوية، مستخدمًا الصور البلاغية الاستعارية والكناية والتورية، كما في قصيدة “والماء مشتعل”، حيث يخلق تناقضًا شعريًا بين الماء والاشتعال، ليعبر عن حالة الحب والعاطفة الملتهبة. كما يستخدم الأسلوب الرمزي والأليغوريا في قصائد مثل “الفارس المفتون”، حيث يرمز الفارس إلى الإنسان المتحدي لعواطفه وتحديات الحياة.
3. الجمع بين العاطفة والفكر
لا يقتصر الديوان على التعبير عن المشاعر الشخصية، بل يتعداها إلى معالجة قضايا فكرية ووطنية وإنسانية. ففي قصيدة “الظلم في وطني”، ينتقد الشاعر الواقع الاجتماعي والسياسي، بينما في “أمانة الحرف”، يتناول دور الأديب في نقل الحقائق والتعبير عن ضمير الأمة.
4. التأثر بالتراث مع الحداثة
يظهر الديوان تأثرًا واضحًا بالتراث العربي الإسلامي، من خلال الاستشهاد بالقرآن والإشارات إلى الرسول الكريم والأخلاق الإسلامية. في الوقت نفسه، يستخدم الشاعر لغة معاصرة وأفكارًا جديدة، مما يجعله جسرًا بين الأصالة والحداثة.
5. البناء الفني المتماسك
يتميز الديوان بتقسيم فني مدروس، حيث يجمع بين القصائد الغزلية والوطنية والصوفية والفلسفية. هذا التنوع لا يشعر القارئ بالملل، بل يمنحه رحلة متكاملة عبر مشاعر وأفكار متعددة.
الفكرة المركزية للديوان
تدور الفكرة الرئيسية للديوان حول **”الفارس المفتون”** الذي يمثل الإنسان الذي تستعبده عواطفه وتحديات حياته، لكنه يظل مناضلاً في سبيل قيمه ومبادئه. يتجلى هذا في:
• الفتنة العاطفية: كما في قصيدة “الفارس المفتون”، حيث يصور الشاعر نفسه أسيرًا لحبه.
• الفتنة الوطنية: كما في قصيدة “الظلم في وطني”، حيث يعبر عن انتمائه وهموم أمته.
• الفتنة الأخلاقية: كما في قصائد مثل “كن عادلاً” و”طريق الحق”، حيث يدعو إلى التمسك بالقيم والمبادئ.
تقييم أثر الديوان على الحياة الفكرية والأدبية والثقافية
1. على المستوى الأدبي
• يعد الديوان إضافة نوعية للشعر العربي المعاصر، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويقدم نموذجًا للشعر الملتزم الذي لا يغفل عن الجمالية الفنية.
• استخدام الشاعر للرمزية والأساليب البلاغية المبتكرة يجعله مرجعًا لدارسي الأدب والنقاد.
2. على المستوى الفكري
• يطرح الديوان قضايا إنسانية كبرى، مثل العدالة، الحرية، الانتماء، والأخلاق، مما يجعله منبرًا للتأمل والنقاش.
• يشكل الديوان صوتًا للضمير الجمعي، خاصة في قصائده الوطنية التي تعبر عن هموم الأمة العربية.
3. على المستوى الثقافي
• يساهم الديوان في تعزيز الهوية العربية والإسلامية من خلال التأكيد على القيم والمبادئ الأصيلة.
• يقدم صورة مشرقة للأدب العربي المعاصر، وقدرته على المنافسة في الساحة الثقافية العالمية.
4. على المستوى العلمي
• يمكن أن يكون الديوان مادةً للدراسات النقدية والأكاديمية، خاصة في مجال تحليل الخطاب الشعري والبلاغة.
وفي الختام يمكننا القول أن ديوان “الفارس المفتون” للشاعر يوسف الحملة يعد عملًا أدبيًا متميزًا، يجمع بين العمق الفني والثراء الفكري. استطاع الشاعر من خلاله أن يقدم رؤية شاملة للإنسان المعاصر، المتأرجح بين عواطفه وقيمه، بين حبه لوطنه وهمومه الإنسانية.
الديوان ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو رسالة إنسانية تهدف إلى إيقاظ الضمير وتجديد الأمل. وهو بلا شك سيبقى علامة بارزة في مسيرة الشعر العربي المعاصر، وسيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.
الفصل السادس: تحليل أدبي نقدي موسع لديوان “أمَّاه” للشاعر يوسف الحَمَلَّة
السمات الأسلوبية والفنية
1. اللغة والأسلوب:
• اللغة الشعرية التقليدية: يتميز الديوان بلغة شعرية راقية، متجذرة في تقاليد الشعر العمودي، مع احترام واضح لقواعد العروض الخليلي. يستخدم الشاعر مفردات موحية وغنية، تعكس عمقاً ثقافياً وأدبياً.
• الصور الشعرية: يمتاز الديوان بصور شعرية مكثفة ومؤثرة، مثل تشبيه الأم بـ “قمرًا منيرًا في القضاء مُخَلَّدًا”، مما يضفي طابعاً فلسفياً وجمالياً على النص.
• الرمزية: يستخدم الشاعر الرمزية بشكل لافت، كما في قصيدة “حظر الرأي”، حيث يمثل “الظلام” القمع و”النور” الحرية والحقيقة.
2. البناء الفني:
• تنوع القوافي والإيقاعات: يحافظ الشاعر على تنوع إيقاعي ملحوظ، مع التزامه بالقافية الموحدة في كل قصيدة، مما يعزز الانسجام الموسيقي للديوان.
• التضاد: يستخدم التضاد بين الظلام والنور، الحرية والقمع، الحياة والموت، لخلق تأثير درامي يعمق المعنى.
• الاستعارة والكناية: يبرع الشاعر في استخدام الاستعارة والكناية لنقل المشاعر والأفكار بشكل غير مباشر، مما يضفي غموضاً جميلاً يشجع القارئ على التأمل.
3. الموضوعات والمضامين:
• الفقد والحنين: تحتل قصيدة “أمَّاه” مكانة مركزية، حيث يعبر الشاعر عن ألم الفقد والحنين إلى الأم، مع تركيز على الجانب الروحي والإنساني.
• الحرية والعدالة: تبرز قصيدة “حظر الرأي” كصرخة ضد القمع، ودعوة إلى حرية التعبير والعدالة الاجتماعية.
• التأمل الذاتي: في قصيدة “حديث مع النفس”، يتناول الشاعر رحلة الاكتشاف الذاتي والصراع الداخلي، مع التركيز على دور الحب كقوة محركة.
• الوطنية والقضايا الاجتماعية: تظهر قصائد مثل “وطني ثم وطني” و”الشهيدة غادة ستباين” اهتمام الشاعر بالهموم الوطنية والإنسانية.
الفكرة المركزية للديوان:
يدور الديوان حول الوجود الإنساني في مواجهة الفقد والظلم والبحث عن الذات. يمثل الحب – حب الأم، الوطن، الحرية، والحب الإلهي – المحور الرئيسي الذي تنتظم حوله القصائد. الشاعر يقدم رؤية فلسفية عميقة للحياة، حيث يكون الألم مصدراً للإلهام، والذاكرة جسراً إلى الأمل، والكلمة سلاحاً في مواجهة الظلم.
تقييم أثر الديوان:
1. على المستوى الأدبي:
• يُعد الديوان إضافة نوعية للشعر العربي المعاصر، حيث يجمع بين الأصالة التقليدية والموضوعات المعاصرة.
• يبرز الشاعر كصوت مؤثر في مدرسة “الشعر المحافظ”، مما يعزز مكانة الشعر العمودي في المشهد الثقافي.
2. على المستوى الفكري:
• يطرح الديوان أسئلة وجودية عميقة حول الموت، الحب، الحرية، والهوية، مما يحفز القارئ على التأمل والنقاش.
• يشكل نقداً لاذعاً للأنظمة القمعية، ويدعو إلى مقاومة الظلم عبر الكلمة.
3. على المستوى الثقافي والاجتماعي:
• يعكس الديوان هموم الإنسان العربي في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية، مما يجعله مرآة لعصره.
• يسلط الضوء على قضايا إنسانية مثل فقدان الأم، الظلم، والصراع من أجل الحرية، مما يخلق حواراً ثقافياً واسعاً.
4. على المستوى العلمي (النقدي):
• يقدم الديوان مادة خصبة للنقاد لدراسة الانزياحات اللغوية، الرمزية، والبناء الفني في الشعر العربي الحديث.
• يمكن اعتباره نموذجاً لدراسة تأثير البيئة الاجتماعية والفكرية على الإبداع الأدبي.
وفي الختام نقول إن ديوان “أمَّاه” ليوسف الحملة هو عمل أدري مكتمل الأركان، يجمع بين جمالية اللغة وعمق المضمون. لا يقتصر على التعبير عن المشاعر الشخصية فحسب، بل يتعداها إلى طرح قضايا إنسانية كبرى. قصائده، يقدم الشاعر رؤية متفائلة رغم الألم، مؤمناً بأن الكلمة يمكن أن تكون جسراً إلى الخلود، وأن الذكرى يمكن أن تكون نوراً في ظلام الفقد. هذا الديوان ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو رسالة إنسانية تخلد في ذاكرة الأدب العربي.
الفصل السابع: “تَحِيّةٌ إلى كوسوفَا” ليوسف الحَمَلَّه — قراءة نقدية أسلوبية ومعنوية وتأثيرية
“تحيّة إلى كوسوفا”
بِـكِ نَحْتَفِي يَـا نَغْمَةَ الأَحْـلَامِ
في عَيْنِ حُسْنِكِ رَوْعَةُ الإِلْهَامِ
يَا دُرَّةً سَطَعَتْ بِـنُـورِ كَـرَامَـةٍ
وَعَبَقْتِ فَخْرًا فِي رُبَى الأَيَّامِ
قَدْ قُمْتِ مِنْ أَلَمٍ جَسُورٍ، نَخْلَةً
تُهْدِي الثِّمَارَ لِمَنْ يُحِبُّ السَّامِي
قَدْ شَابَ تَارِيخُ المَآسِي وَانْجَلَى
فِي وَجْهِكِ النُّورُ الَّذِي لَا يُضَامِي
يَا قِبْلَةَ الأَحْرَارِ فِي تَضْحِيَاتِهِمْ
أَسْقَيْتِ مَجْدَكِ مِنْ دَمٍ وَهُمَامِ
فَتَفَتَّحَتْ أَزْهَارُكِ الخَجْلَى وَرَاهُ
نُسُورُ مِصْرٍ فِي سَمَاكِ تُسَامِي
مِصْرٌ تُحِبُّكِ حُـبَّ قَلْبٍ خَالِصٍ
لَمْ يَعْرِفِ الإِخْلَاصَ غَيْرَ كِرَامِ
يَـا أُمَّـةً نَهَضَتْ عَلَى أَطْلَالِهَا
تَبْنِي الحَيَاةَ وَتَسْتَمِدُّ مَقَامِي
وَصَدِيقُنَا السَّفِيرُ جَاءَ بِنَبْضِهِ
يَهَبُ الوِدَادَ وَيَسْكُنُ الأَحْلَامِ
حَـفِـظَ الإِلَهُ رُبَـاكِ مِـنَ الأَذَى
وَسَقَاكِ نُــورَ الــعِـزِّ وَالإِكْـرَامِ
مقدمة
قصيدة “تحية إلى كوسوفا” للشاعر يوسف الحَمَلَّه نصٌّ وطنيّ/إنسانيّ يوزّع مشاعره بين الانشاد الرثائي والمديح والتحيّة السياسية. تبدأ القصيدة بنداءٍ وعاطفةٍ صريحة نحو كوسوفا ثم تتوسّع لتؤسس صورةً رمزيةً للأرض والشعب والمقاومة، مستخدمةً مفرداتٍ دينية وتاريخية ووطنية. وجود الشاعر يوسف الحملة ككاتب ونشرٍ لقصائد متعدِّدة موحٍ بأن نصوصاً حول كوسوفا ومأساها ووقوف الأقلام العربية تجاهها موجودة في الساحة الأدبية والإعلامية العربية.
قراءة مقطعية للفكرة المركزية
الفكرة المركزية في القصيدة هي تحيّة تضامُنية وإنشادية تجاه كوسوفا، تقوم على محاور رئيسية:
1. تكريم الصمود والكرامة (مكرر في “دُرَّةً سطعت بنورِ كرامة” / “قُمْتِ من الألمِ”).
2. التأطير الديني والأخلاقي للمقاومة (“يا قبلةَ الأحرار”، “حفظَ اللهُ ربّاكِ”).
3. ربط التضحية بالمجد التاريخي والرمزي (“أسقيتِ مجدَكِ من دمٍ وهمام”).
4. إظهار علاقة اجتماعية/دبلوماسية (وجود “صديقنا السفير” كرمزٍ للتواصل والمصالحة والودّ).
القصيدة إذن تعمل كمرآةٍ تجمع البعد الإنساني (الألم والحنين) مع البعد القيمي/التمجيدي (الكرامة والتضحية) ومع بُعدٍ علائقي/دبلوماسي (مصر – السفير – التضامن).
الشكل والبحر والوزن
القصيدة مكتوبة على بحر الكامل، وهو بحرٌ إيقاعيّ يفضي إلى جُمَلٍ موسيقيةٍ طويلةٍ وممتدةٍ تليق بالانشاد والتراتيل. علامات بحر الكامل (تفعيلات مطوَّلة وتراكيب موسيقية) تمنح النص طابعا رسمياً ووقاراً. القافية موحدة إلى حدٍّ كبير (إحساس بالانسجام الصوتي: -امِ/ -ام/ -ي/ اختلال طفيف مقصود أحياناً لإبراز مقطع)، ما يعزز النبرة التمجيدية والولائيّة.
السمات الأسلوبيّة والبلاغيّة البارزة
1. النداء المباشر (يا …) والألفاظ المكانية/القبلة: النداء يجعل القصيدة خطاباً مباشراً إلى كوسوفا، ويحمل طاقة انعزالية واستدعاءً أخلاقياً (“يا قِبلةَ الأحرار”).
2. التمثيل التصويريّ والاستعارة: تشبيه القومية والنهوض بنخلةٍ تهدي الثمار، والدُّرَّة كنورٍ وككرامة — استعارات تقرّب القارئ من صورةٍ حسّيةٍ ومثالية.
3. التشخيص والتأليه الرمزي: “في وجهكِ النورُ الذي لا يُدامي” — منح الأرض/الشعب صفاتٍ إنسانية/مقدسة.
4. الترادف والبناء المتوازٍ: تكرار البناء الموازٍ (“قُمْتِ من الألمِ… قد شاب تاريخ المآسي…”) يعطي القصيدة إيقاعاً بلاغياً منظماً.
5. المصطلحات الدينيّة والوطنيّة الممزوجة: “قِبلة”، “حفظَ الإله”، “دم” — مزج يخلق إدانة أخلاقية للظلم ويعطي الشرعية المعنوية للمقاومة.
6. اللغة البسيطة والجميلة: لا لُغَويَّةٌ افخِرية مبالغٌ فيها؛ المعجم قريب من الجمهور، ما يجعل القصيدة قابلةً للترديد والنشيد.
الصور والرموز المفتاحية
• النخلة: رمز الصمود والعطاء، يدل على استمرارية الحياة وعطاء الأرض.
• الدرّة/النور/الزهور: مؤشرات على الجمال والكرامة والتجليّ.
• الدم والمجد: ربط التضحية بالمكافأة الرمزية — محبوب في تراث الشعر الوطني.
• السفير: رمز للعلاقات، يُنزل النصّ من خانة العاطفة الخالصة إلى مستوى التواصل المدني والدبلوماسي.
البنية الدلالية والنبرة
النبرة في معظم النصّ مهيبة، مؤمنة، ومفعمة بالثقة والتضامن. القصيدة لا تتبنّى خطاباً انتقامياً بل تقوم على تمجيد الكرامة والحقوق والربط الأخلاقي بين الشعوب — لذلك تبدو دعائية بمعنى إيجابي: ترويج لقيم التضامن والإحسان. البنية تميل من الإحساس (النداء والوصف) إلى المعنى العام (الهوية والعلاقات) ثم البركة والدعاء في الخاتمة، وهو ترتيب كلاسيكي في الشعر المدحي/التأبيني.
تقييم الأثر عبر مجالات متعددة
قاعدة منهجية: سأقيّم أثر النصّ بالاعتماد على خصائصه الداخلية (لغة، خطاب، رموز) وإمكاناته التواصلية، مع تحفّظ على نسبة التأثير الفعلي التاريخي دون دلائل نشرية/امتداد جماهيري مُحدّد. يمكن للقصيدة أن تؤثر بدرجات متفاوتة حسب نشرها، قراءتها، وتلقي الجمهور.
1. الأثر الأدبي
o تنتمي القصيدة إلى تقليد “الشعر الوطني/الإنساني” الذي يقدّم أرضاً أو شعباً كنموذج للكرامة. بلاغياً، تضيف النصوص مثل هذه إلى مخزون الشعر السياسي/الوطني المعاصر، عبر دمج الطابع الديني والحنيني مع المديح. قد تُستخدم كنموذج للشعر التعبوي في الخطابات الأدبية والمناسبات التضامنية.
o من ناحية الشكل، المحافظة على بحر الكامل تضيف بعداً استدعائياً للتراث، ما يعزز جسرها بين الكلاسيكية والمعاصرة.
2. الأثر الفكري
o القصيدة تؤكّد مواقف فلسفية وأخلاقية: القيمة الإنسانية للكرامة، والشرعية الأخلاقية للمقاومة في وجه الظلم. يمكن أن تلهم نقاشات حول مفهوم “الحقوق” و”العدالة” في خطابٍ ثقافي عربي-إسلامي.
3. الأثر الديني
o استخدام مفردات دينية (قبلة–دعاء–حفظ الإله) يعطي القصيدة صبغة استحقاق أخلاقي ديني للمقاومة، وهي بذلك قد تساهم في تأييد رؤى دينية ترى في نصرة المظلوم واجباً. لا يعني ذلك بالضرورة تحريضاً؛ النصّ أقرب إلى الدعاء والبركة.
4. الأثر الثقافي
o القصيدة تعمل كـ”سردية ثقافية” تُعيد إدماج حدثٍ أو قضيةٍ بعيدة ضمن خريطة الاهتمام الثقافي العربي. تمنح كوسوفا حيزاً في ذاكرة الجماعة عبر الصور والنداء—وهذا مهم في صناعة التضامن الثقافي.
5. الأثر العلمي
o مباشرةً، القصيدة لا تحمل محتوى علمي؛ لكن من زاوية أوسع، يمكن أن تُستخدم في دراساتٍ عن شعر المقاومة، التمثيلات الأدبية للنزاعات، أو في فروع علوم الاجتماع الثقافي كوثيقة تعكس موقفاً اجتماعياً/ثقافياً تجاه حدثٍ ما.
6. الأثر السياسي والدبلوماسي
وَصَدِيقُنَا السَّفِيرُ جَاءَ بِنَبْضِهِ
يَهَبُ الوِدَادَ وَيَسْكُنُ الأَحْلَامِ
a) الشرح اللغوي والأسلوبي
• صديقنا السفير”: خطاب مباشر يُظهر العلاقة الشخصية والاحترام بين الشاعر والسفير، مما يضفي طابعًا حميميًا على العلاقة الدبلوماسية.
• جاء بنبضه”: استعارة جميلة، فالنبض رمز للحياة والمشاعر الصادقة، أي أنه جاء بقلب نابض بالحب والتضامن، لا بمجرد دور رسمي.
• “يهب الوداد”: الوداد يعني المودة والمحبة، فهو يمنح مشاعر الصداقة والتعاطف.
• “ويسكن الأحلام”: يسكن هنا بمعنى يطمئن ويهدئ، والأحلام ترمز إلى آمال وتطلعات شعب كوسوفا، فوجوده وسفارته يمثلان تحقيق حلم ورمزًا للاستقرار والاعتراف الدولي.
b) الدلالة في سياق القصيدة
القصيدة كلها تحية تعاطفية مع كوسوفا، وهذا البيت يربط العلاقة الشخصية والدبلوماسية بين مصر وكوسوفا من خلال شخص السفير، الذي يمثل جسرًا للتواصل والمشاعر الإنسانية.
c) الأبعاد الرمزية والتأثيرية
• البعد الدبلوماسي: السفير ليس مجرد موظف رسمي، بل هو “صديق” يحمل نبضًا إنسانيًا، مما يرفع من قيمة العلاقة بين البلدين إلى مستوى العلاقات الشخصية المخلصة.
• البعد العاطفي: الشاعر يرى أن السفير يحقق الأحلام ويبعث الطمأنينة، وهذا يعكس الأمل الذي مثّلته سفارة كوسوفا في مصر بعد الاعتراف بها.
• البعد السياسي غير المباشر: القصيدة تدعم شرعية كوسوفا وتُظهر تضامن مصر معها في محنتها، وهذا البيت يكرس ذلك التضامن على المستوى الرسمي والشعبي.
d) تقييم الأثر
هذا البيت يعمق الأبعاد العاطفية في العلاقات الدولية، ويحول الدبلوماسية من إجراء رسمي إلى علاقة إنسانية، مما يعزز التلاحم بين الشعبين، ويرسخ صورة مصر كداعم للقضايا العادلة في البلقان.
7. الأثر النضالي
o القصيدة ترفع من معنويات المظلومين بكونها تشهد على الكرامة والتضحية. يمكن نقلها في فعاليات تضامنية، أو استخدامها في خرائط الخطاب السياسي للدعم، وبالتالي لها دور معنوي ونفسي في مسارات النضال.
وأخيرا نقول “تحية إلى كوسوفا” قصيدةٌ قصيرةٌ لكنّها مركّزة: تجمع بين السجع الإيقاعي لبحر الكامل والصور الرمزية التي تمنح القضية بعداً أخلاقياً ودينياً وإنسانياً. تأثيرها الفعليّ على الحياة الأدبية والثقافية والدبلوماسية والسياسية يعتمد على مدى انتشارها وتلقّي الجمهور، لكن إمكانياتها في شدّ الانتباه المعنويّ، تقديم التضامن الشعبي، والمساهمة في “الدبلوماسية الثقافية” واضحة وبالغة. أخيراً، تظل الأبيات مثالاً عملياً على كيف يمكن للشعر أن يتحول إلى صوتٍ يُضِيفُ لبنة في بناء ذاكرةٍ جماعيةٍ عن كرامةٍ ومقاومةٍ، حتى وإن كان أثرُه العمليُّ يتطلب قنواتٍ ونشاطاً جماهيرياً مُكثّفاً لتحقيقه.
مراجع قصيرة: وجود الشاعر ونشره لقصائد مطروحة في الساحة الاجتماعية/الأدبية، ومقاطعٍ عربية متعدِّدة تتناول كوسوفا تشير إلى أن القضية حاضرة في الشعر العربي المعاصر.
الخاتمة
بعد استعراض السيرة الذاتية للشاعر يوسف الحَمَلَّه وتحليل نتاجه الإبداعي في دواوينه الأربعة، إضافة إلى قراءة نقدية معمّقة لقصيدته “تحية إلى كوسوفا”، يمكن القول إننا أمام تجربة شعرية ناضجة وذات ملامح واضحة، تجمع بين الأصالة اللغوية وروح العصر، وبين الوجدان الفردي والوعي الجمعي، وبين الشعر كفنّ والإبداع كرسالة.
تؤكد هذه الدراسة أن يوسف الحَمَلَّه استطاع، عبر مسيرة متدرجة، أن يبني لنفسه مشروعًا شعريًا يقوم على العناصر التالية:
1. التعدّد اللغوي والفني: فهو شاعر يجمع ببراعة بين الفصحى والعامية والغنائي، ويستخدم الأوزان والقوافي في سياقٍ منضبط وواعٍ، محافظًا على هوية الشعر العربي العمودي مع انفتاحٍ على آفاق الرمز والتجريب.
2. البعد الفكري والروحي: تظهر في شعره قيم العدالة والحرية والوعي الأخلاقي، متشكّلةً في إطار فلسفي وإنساني يجعل القصيدة نافذةً على الذات والوجود، وعلى صراع الإنسان مع الألم والأمل.
3. الحضور الثقافي والدبلوماسي: من خلال عضويته في مؤسسات أدبية مؤثرة، ومن خلال نصوص تحمل رؤيةً إنسانية وعربية وإسلامية شاملة، يقدم الشاعر نموذجًا لما يمكن تسميته بـ الدبلوماسية الشعرية، حيث تتحول القصيدة إلى خطاب تواصل وبناء جسور بين الشعوب والثقافات.
4. التأثير الأدبي والنقدي: لقد أظهرت القراءة النقدية لديوانَي “الفارس المفتون” و”أمَّاه” أن الشاعر يمتلك قدرات جمالية وفكرية تجعله قادرًا على رسم عوالم رمزية ووجدانية عميقة، تجمع بين الفلسفة والحسّ الإنساني وبين الالتزام الاجتماعي والسياسي.
5. الحس الوطني والإنساني: من أبرز ما يميز نصوصه—وخاصة “تحية إلى كوسوفا”—هو المزج بين الانحياز للقيم الإنسانية وبين تصويره لمأساة الشعوب ونهوضها. هنا يصبح الشعر وسيلة لتأكيد التضامن الإنساني، ولتقديم رؤية شمولية تتجاوز حدود الجغرافيا والثقافة.
على ضوء ذلك، يمكن القول إن يوسف الحَمَلَّه ليس شاعرًا تقليديًا، ولا شاعرًا غنائيًا فحسب، بل هو صاحب مشروع أدبي له امتداداته الفكرية والثقافية والسياسية. نصوصه، من حيث هي مرآة للإنسان والوطن، قادرة على أن تكون جزءًا من التراث الشعري العربي في بدايات القرن الحادي والعشرين. كما أنها تشكل حقلاً خصبًا للباحثين الأكاديميين في مجالات الشعر، النقد، الدراسات الثقافية، وتحليل الخطاب.
وختامًا، فإن هذه الدراسة لا تدّعي الإحاطة الشاملة بكل جوانب التجربة الشعرية للشاعر، لكنها تسعى إلى وضع لبنةٍ تأسيسية لقراءة علمية تتجاوز الانطباع إلى التحليل، وتفتح الباب أمام مزيد من الدراسات المستقبلية التي قد تتناول جوانب أخرى من مشروعه الإبداعي، أو تربط شعره بسياقات أوسع كالأدب الإسلامي، والبلاغة الحديثة، والتحولات السياسية والثقافية في العالم العربي. إن شعر يوسف الحَمَلَّه—بتعدده وجماليته وعمقه—يظل شاهداً على قدرة الكلمة على إحياء الوعي، وحمل الذاكرة، وصناعة المعنى، وبناء الجسور بين الإنسان وأخيه الإنسان.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
E-mail: [email protected]