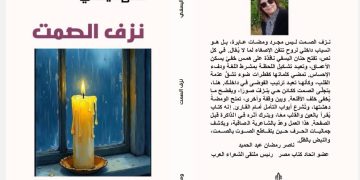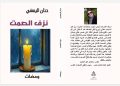الدكتور صلاح عدس: رائد الفكر الإسلامي المعاصر بين التراث والحداثة
دراسة تحليلية لتأثيره في الحياة الفكرية والأدبية والعلمية
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
E-mail: [email protected]
المقدمة
في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، تبرز حاجة مُلحّة إلى مفكرين قادرين على صياغة خطابٍ معرفي يجمع بين الأصالة والتجديد، بين وعيٍ راسخ بالتراث ورؤية نقدية للحداثة. في هذا السياق، يبرز الدكتور صلاح عدس بوصفه أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، الذي لم يكتفِ بالتنظير، بل انخرط في مشروع معرفي متكامل شمل الأدب والمسرح والنقد، إضافة إلى الاهتمام العميق بالتراث العربي والإسلامي وإعادة تقديمه بلغة العصر.
تميّز مشروعه الفكري بالتعدد المنهجي والانفتاح الثقافي، مستفيدًا من تكوينه العلمي والطبي ولغاته المتعددة، ما أتاح له قراءة عميقة للنصوص التراثية والغربية على حد سواء. جاءت أعماله ردًّا حضاريًّا على التحديات الثقافية والفكرية التي تواجه الأمة الإسلامية، بدءًا من أزمة الهوية، مرورًا بالتغريب، وصولًا إلى الحاجة إلى صياغة خطاب تحرري يعيد للأمة ثقتها بذاتها.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المشروع الفكري والأدبي للدكتور عدس، من خلال ثلاث زوايا رئيسة: سيرته ومسيرته، طبيعة مشروعه الفكري، ثم تقييم أثره في الساحة الفكرية والثقافية، انتهاءً بخاتمة تُبرز موقعه ضمن خرائط الفكر الإسلامي المعاصر.
الفصل الأول: السيرة الذاتية والخلفية الأكاديمية
1.1 -النشأة والتكوين العلمي
وُلد الدكتور صلاح عدس في مصر عام 1943 في بيئة علمية محافظة، حيث تلقى تعليمه الأساسي في المدارس الأزهرية، ثم حصل على شهادة الطب من جامعة القاهرة، وهو ما شكّل خلفية مزدوجة جمعت بين العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية.
هذه الثنائية العلمية ساعدته على تطوير خطاب عقلاني متوازن، لا يقع في فخ الخطاب العاطفي أو الإيديولوجي، بل يتسم بالتحليل والتركيب والربط بين المعطيات الواقعية والنصوص المرجعية.
إتقانه للغات الأوروبية (الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية) مكّنه من الاطلاع على الفكر الغربي من مصادره الأصلية، ومن ثم تقديم قراءات نقدية عميقة تجاوزت الترجمة إلى التحليل والمقارنة.
2.1- المسار الفكري والأدبي
رغم انطلاقه من تخصصه الطبي، سرعان ما انحرف اهتمامه الأكاديمي نحو مجالات الأدب والفكر، ليؤسس لنفسه مشروعًا متميزًا في مجالات متعددة:
• التراث الإسلامي: من خلال مشاريع اختصار وتبسيط لأمهات الكتب مثل “تفسير ابن كثير”، و”الإصابة”، و”أسد الغابة”.
• المسرح الإسلامي: حيث كتب ما يزيد عن عشر مسرحيات شعرية ذات مضمون حضاري ورسالي.
• النقد الأدبي والفكري: بتقديم قراءات معاصرة للأدب الغربي من زاوية إسلامية ناقدة.
تميزت كتاباته بالتنوع، حيث خاطبت فئات متعددة من المثقفين، من المهتمين بالتراث، إلى القرّاء العامين، إلى الشباب الباحث عن الهوية في زمن العولمة.
3.1-الاعتراف الأكاديمي والنقدي
تعدّدت الدراسات التي تناولت إنتاجه بالتحليل والنقد، منها ما نُشر في مصر وباكستان، ومنها ما تم اعتماده في رسائل أكاديمية في الجامعات الإسلامية، مما يعكس قبولًا أكاديميًا واسعًا. وتُوّج هذا الاعتراف بنشر أعماله ضمن سلاسل فكرية ومؤسسات ثقافية مرموقة.
الفصل الثاني: قراءة في مشروعه الفكري
1.2- إحياء التراث الإسلامي: بين التبسيط والتأصيل
اعتمد الدكتور عدس في تعامله مع النصوص التراثية على ما يمكن تسميته بـ”الاختيار الهادف”، حيث لم يكن غرضه مجرد تبسيط، بل إعادة توجيهها لخدمة مشروع النهضة، عبر:
• إبراز القيم الحضارية من خلال سِيَر الصحابة والتابعين.
• ربط التراث بالتحديات المعاصرة (مثل الانقسام السياسي والتبعية الثقافية).
• نقد بعض المرويات التي تُستخدم لترسيخ الجمود أو تبرير الاستبداد.
ورغم الانتقادات التي وُجهت إليه بـ”الانتقائية”، إلا أنه كان يؤكد على أنّ هذه القراءة تعيد للتراث وظيفته الحضارية.
2.2-المسرح الإسلامي: الفن كأداة للنهضة والتحرير
اتخذ المسرح عند عدس شكلًا رساليًا، حيث رأى فيه وسيلة لترسيخ القيم الإسلامية، لا مجرد وسيلة للترفيه. فمسرحياته مثل بلال.. الثائر، وعبد الله بن حذافة والقيصر تُجسد معاني البطولة، الجهاد، والكرامة.
استخدم أدوات مسرحية متقدمة: الرمزية، المفارقة التاريخية، الشعر العمودي، بالإضافة إلى استخدام شخصيات تاريخية كنماذج معاصرة للصراع بين الحق والباطل.
وفي المقابل، وجّه نقدًا عميقًا للمسرح الغربي، خاصة مسرح العبث، الذي رآه يعكس حالة فقدان المعنى في الحضارة الغربية.
3.2-“الطريق إلى مكة”: الهوية الروحية والعودة إلى الأصل
في هذا الديوان، نجح عدس في تقديم تأملات شعرية حول مفهوم العودة الروحية والهوية، حيث تحوّلت “مكة” من مجرد مدينة إلى رمزٍ للصفاء والانتماء، ومركز روحيّ يُعيد تعريف المسلم في زمن الغربة الروحية والانفصال الثقافي.
كما يعكس الديوان حسًّا صوفيًا عميقًا، وتجربةً وجودية تتقاطع مع أعمال رمزية مثل رحلة محمد أسد أو مراد هوفمان، لكن من خلال قالب شعري عربي يدمج الجمال اللغوي بالمعنى الوجودي.
الفصل الثالث: تقييم أثره الفكري والعلمي
1.3-التأثير التراثي المعاصر: “المختار من الإصابة” نموذجًا
قدم الدكتور عدس هذا المختصر من كتاب ابن حجر بنَفَس معاصر، حيث لم يُرد فقط توثيق سير الصحابة، بل إبراز القيم الحضارية التي جسدوها، مثل العدل، الجهاد، الزهد، والمشاركة السياسية.
امتاز كتابه بما يلي:
• إعادة توجيه الوعي الجمعي نحو الاقتداء الحقيقي لا التقديس الأجوف.
• نقدٌ ضمني للانفصال بين التنظير والعمل في واقعنا المعاصر.
• توظيف سِيَر الصحابة كمنصة لمواجهة التغريب والانقسام.
2.3-المسرح كخطاب تعبوي: “بلال.. الثائر” نموذجًا
شكّل هذا العمل المسرحي نموذجًا لتحويل الأدب إلى أداة مقاومة، حيث جسد بلال بن رباح صوت المظلومين والثائرين على الظلم الداخلي والخارجي.
• استخدم البناء الدرامي في خلق تعاطف جماهيري مع قيم الحق والعدالة.
• وجّه نقدًا للنماذج الغربية في المسرح، واقترح بديلًا إسلاميًا رساليًا.
• ركّز على رموز التحرير المستمدة من التاريخ الإسلامي، واستحضارها كأدوات لمواجهة الاستبداد المعاصر.
3.3-شعر الهوية والانتماء: “الطريق إلى مكة” نموذجًا
تميّز هذا العمل بما يلي:
• لغة شعرية مشحونة بالرموز، والمجازات الدينية والسياسية.
• نقدٌ للحالة الروحية المهزوزة للأمة في ظل العولمة المادية.
• محاولة بناء وعي جمعي يعيد مكة إلى مركز الفعل الحضاري والفكري، لا فقط الشعائري.
الخاتمة: نحو إعادة الاعتبار للفكر الإسلامي الرسالي
تمثل أعمال الدكتور صلاح عدس نموذجًا أصيلًا لفكر إسلامي متوازن يجمع بين التأصيل والتجديد، ويقدّم الفن والأدب بوصفهما أدوات تحرر ووعي، لا ترفًا ثقافيًا. كما تُبرز دراسته لحياة الصحابة، وكتاباته المسرحية، وشعره الروحي، حاجة الأمة إلى مفكرين يُعيدون ربط الماضي بالمستقبل.
لقد نجح عدس في أن يُجسّد ما دعا إليه مرارًا: أن يكون المسلم مثقفًا فاعلًا، يعيش عصره دون أن يتنكر لتراثه. ومن هنا، فإنّ مشروعه الفكري يستحق أن يُدرّس ويُحلّل كنموذج للفكر الإسلامي الراشد في زمن التحديات.
الفصل الرابع: التحليل الأدبي والنقدي لثلاثة قصائد من ديوان “الطريق إلى مكة”
قراءة نقدية في أشعار الدكتور صلاح عدس بين الثورة والذاكرة والهوية
يشكل ديوان “الطريق إلى مكة” لشعر الدكتور صلاح عدس محطة بارزة في الشعر العربي المعاصر، حيث يتجلى فيه الجمع بين البعد الروحي العميق والالتزام الوطني والإنساني. في هذا الفصل، نسلط الضوء على ثلاث قصائد تمثل محاور أساسية في تجربة عدس الشعرية: التحية الثورية، تحوّلات المكان والذاكرة، والصراع بين الفقدان والأمل.
تُقدم القصائد الثلاث — “تحية إلى كوسوفا”، “شتاء كوسوفا”، و”كوسوفا والبوسنة والهرسك” — رؤى شعرية تغوص في عمق الألم الجماعي والحنين، كما تعبر عن مقاومة حية للأحداث السياسية والاجتماعية التي شكلت مصير هذه الشعوب. عبر هذه القراءات النقدية، نكشف عن الأساليب الفنية والرموز الشعرية التي استخدمها عدس، ونحلل كيف وظّف اللغة والإيقاع لتجسيد تجربة الإنسان في مواجهة المحن، مع إبراز الأبعاد الفلسفية والوجودية التي تتجاوز الحدث المباشر إلى معانٍ أوسع تخص الهوية والانتماء والعدالة.
أولا: القصيدة والتحية الثورية في الشعر المعاصر: قراءة نقدية في “تحية إلى كوسوفا” لصلاح عدس
الملخص:
تتناول هذه الدراسة التحليلية قصيدة “تحية إلى كوسوفا” من ديوان الطريق إلى مكة للشاعر الدكتور صلاح عدس، بوصفها نموذجًا لشعر التحية المقاوِمة الذي يجمع بين الحماسة السياسية والبُعد الروحي الإسلامي. وتسلّط القراءة الضوء على تفاعل الشاعر مع القضية الكوسوفية باعتبارها قضية حرية وعدالة، وعلى البنية اللغوية والصُوَر البلاغية التي تمنح النص زخمًا وجدانيًّا. وتكشف الدراسة عن تداخل الشعر والخطاب النضالي، في سياق فني يُفعّل عناصر الموروث الإسلامي والتاريخي، ويربطها بالواقع التحرري الحديث.
المقدمة:
لطالما لعب الشعر دورًا مركزيًّا في التعبير عن قضايا الشعوب المظلومة والمضطهدة، إذ يتحول من وسيلة جمالية إلى أداة مقاومة وخطاب تضامن. ومن هذا المنطلق، تُعدّ قصيدة تحية إلى كوسوفا تعبيرًا شعريًّا عن موقف وجداني وسياسي إزاء نضال الشعب الكوسوفي من أجل حريته واستقلاله. فقد استطاع الشاعر الدكتور صلاح عدس، من خلال هذه القصيدة، أن يُحوّل الكلمة إلى فعل تحية، والصوت الشعري إلى خطاب مقاوم يزاوج بين البُعد التاريخي الإسلامي، والبُعد التحرري المعاصر.
أولًا: البناء الخطابي للقصيدة – التحية بوصفها خطابًا شعريًّا
منذ المطلع، يتخذ النص بنية خطابية مباشرة: “أحييكم، أحيي شعبك العملاق”، وهي تحية موجهة إلى شعب كوسوفا، لكنها تتجاوز الشكل البروتوكولي إلى تمجيد نضاله. تتكرّر عبارة “أحييكم” بأشكال مختلفة داخل النص، ما يمنح القصيدة طابعًا احتفاليًّا وإيقاعًا إيقاظيًّا يُحرّك المشاعر.
البنية الخطابية هنا تشتبك مع البنية الشعورية، فالشاعر لا يخاطب شعبًا مجردًا، بل “يحمل قلبه المشتاق على كفّه”، ويضعهم “على الأعناق”، في مشهد رمزيّ يجمع بين المحبة، التقدير، والاستعداد للتضحية.
ثانيًا: الرمز التاريخي والديني – استدعاء السلطان مراد
يشكّل استدعاء شخصية السلطان “مراد” نقطة ارتكاز رمزية في النص:
“مراد، أيها السلطان، لا تحزن على ما فات”.
هنا يعود الشاعر إلى الذاكرة التاريخية الإسلامية، إلى معركة كوسوفا 1389م، حيث قُتل السلطان العثماني مراد الأوّل. هذا الاستحضار لا يُراد به الحنين إلى الماضي فحسب، بل إعادة تأويله في سياق معاصر، حيث يُصبح الدم الذي سُفك قديمًا والدم الحديث الذي يُراق، كلاهما جزءًا من مشروع النهوض الإسلامي والتحرر الإنساني.
يرتبط ذلك بخطاب موجه إلى الزمن والقدر، حيث يقول:
“يدُ الثوار قد دقت على بوابة الأقدار”،
وهو تصوير شاعري لقدَرٍ استُنهضَ بالفعل الثوري، فاستجاب بنصر مُحتَّم.
ثالثًا: البنية اللغوية والصورة الشعرية
يعتمد الشاعر على لغة مباشرة ولكنها مشحونة بعاطفة قومية ودينية. تستند اللغة إلى الجُمَل الفعلية التي تعبر عن حركة وحيوية:
“أحمل قلبي”، “نحملكم”، “أهديكم”، “سأصنع من دمي كلمات”.
إن تحويل الدم إلى “كلمات” وتحويل الورد إلى “باقات” للإهداء يُجسّد التقاء الجمال بالشهادة، والحياة بالمقاومة.
أما الصور البيانية، فتتخذ طابعًا حركيًّا – سمعيًّا – بصريًّا، حيث تتحرك الشمس، وتُرفع الرايات، وتُفتح الأبواب، ويعلو صوت التحية. من الصور اللافتة أيضًا:
• “أطلت شمس كوسوفا”: كناية عن ميلاد جديد، بعد ليل الاحتلال.
• “سأصنع من دمي كلمات”: استعارة قوية تختزل التضحية الشعرية والوجدانية في آنٍ.
رابعًا: ثنائية النصر والشهادة – خطاب الوعي الإسلامي
تتوازن القصيدة بين خطاب الفقد والخسارة من جهة، وخطاب الأمل والنصر من جهة أخرى:
“لا تحزن على ما فات”،
“ولا حزن على ما سال من دم أبنائك”،
“فها هي راية الإسلام تعلو”.
بهذا، تتحول مأساة الماضي إلى طاقة تحفيز، والشهادة إلى معراجٍ نحو الفجر. وهذه الثنائيات تعكس خلفية الشاعر الفكرية ذات البُعد الإسلامي الحركي، حيث يُفهم الجهاد لا كمجرد مقاومة عسكرية، بل كأفق حضاري ومشروع نهضوي.
خامسًا: الإيقاع والدلالة الشعورية
تقوم القصيدة على إيقاع داخلي ينبع من التكرار اللفظي:
“أحييكم، أحييكم”،
“يا أحرار، يا أحرار”،
ما يضفي على النص بعدًا غنائيًّا وهتافيًّا في آنٍ، ويُحاكي قصائد المقاومة الشعبية. تتسارع النبرة تدريجيًّا نحو خاتمة مفتوحة على النصر، ما يُرسّخ الإحساس بالاحتفال والتمكين.
الخاتمة:
تشكل قصيدة تحية إلى كوسوفا نموذجًا رفيعًا في توظيف الشعر العربي الحديث لنصرة القضايا العادلة، ولا سيّما القضية الكوسوفية، من خلال لغة عالية التوتر العاطفي والرمزي، تجمع بين جماليات القول وفعلية الموقف. وفي هذا السياق، يتبدّى صوت الشاعر صلاح عدس لا كمتفرج أو متعاطف، بل كـ”شاهد حضاري” على نهوض شعب، ومؤمن بقوة الكلمة حين تتجذر في الحق والحرية.
ثانيا: تحوّلات المكان والذاكرة بين الحنين والخراب: قراءة في قصيدة “شتاء كوسوفا” لصلاح عدس
الملخص
تتناول هذه الدراسة تحليلًا أدبيًّا لقصيدة “شتاء كوسوفا” من ديوان الطريق إلى مكة للدكتور صلاح عدس، مركّزة على ثنائية “المكان والذاكرة” في سياقٍ شعري يُعيد بناء التجربة الكوسوفية من منظور وجداني. تستعرض القراءة كيف تتحوّل الصورة الجمالية للشتاء من رمز للدفء والسكينة إلى مشهد مأساوي للحرب والدمار، وتُبرز الدراسة الطاقات التصويرية والرمزية في النص، بما في ذلك تجليات الحنين، الفقد، والنفي، فضلًا عن استخدام الشاعر لأساليب فنية تستحضر البُعد الإنساني والروحي للكارثة. وتسعى الدراسة إلى تأطير القصيدة داخل الشعر الإنساني المقاوم، حيث يتقاطع الخاص مع الجماعي، والذاتي مع المصير الجمعي لشعب منكوب.
المقدمة
تمثل القصائد التي تتناول المآسي الإنسانية في صيغها الجمالية ذروة تداخل الشعري بالتأريخي، والوجداني بالجمعي. وفي هذا السياق، تأتي قصيدة “شتاء كوسوفا” لتكون شهادة وجدانية وشعرية على مذبحة الزمان والمكان، حيث يتحول الشتاء ـ الذي غالبًا ما يقترن بالحميمية ـ إلى شتاء مفخّخ بالدمار والخسارة. صلاح عدس، في هذه القصيدة، لا يرصد الحدث من موقع خارجي، بل ينغمس فيه بذاكرة شخصية وجماعية، ويُعيد من خلاله صياغة صورة كوسوفا بين ماضٍ دافئ وحاضر مخرَّب.
أولًا: بنية المكان وتحوّلات الذاكرة
يفتتح الشاعر القصيدة بصورة حميمة:
“كان لنا في كوسوفا دار / وصغار / يجرون وراء فراشات حديقتنا…”
هذه البداية تؤسّس لذاكرة مكانية دافئة، حيث البيت والحديقة والأطفال، وتشكّل معجمًا بصريًّا وعاطفيًّا للحياة الهادئة. إلا أنّ هذه الذاكرة سرعان ما تتحوّل:
“لكن شتاء كوسوفا الآن / شتاء الأحزان…”
يتغير الإيقاع والدالّ الزمني، ليتحوّل “الشتاء” من محطة للدفء والتأمل، إلى مسرح للحريق والخراب. وهنا تظهر ثنائية البيت/الخراب، الحديقة/الركام، الأطفال/الأشلاء، وهي ثنائيات تَشطر الذاكرة إلى ما قبل وبعد، وتُحوّل القصيدة إلى مرثية لزمن مفقود.
ثانيًا: التصعيد الدرامي والرمز الكوني
يتدرّج النص من الحنين إلى الانفجار:
“أشعل أعداء الله بها النيران / ما عادت غير خرائب ودخان / يخنقها الموت…”
ثم يُلقى بالمتكلم في تجربة تيه ومحو وجودي:
“أعدو… أترنح / أسقط وسط الأوحال / ومعي يسقط أشلاء بشر…”
هنا، تتكثف اللغة الدرامية عبر صور تتقاطع مع أدب المآسي الجماعية، وكأنّ القصيدة تنتقل من مساحة السرد إلى مساحة الإحساس الحي بالكارثة.
كما يستثمر الشاعر الرمز الديني الكبير:
“وكأنّنا نخرج من فوهة القبر / يوم الحشر”
وهي استعارة تحوّل النكبة من حدث سياسي إلى تجربة وجودية–أخروية، تستحضر يوم القيامة كشاهد على حجم الخراب.
ثالثًا: الصحراء والمنفى – خريطة الألم الوجودي
في القسم الثاني من القصيدة، تتكرس تجربة الشتات والنفي:
“خلفي يحرق الفردوس المفقود / وأمامي صحراء المنفى الأبدية / صحراء جليدية…”
يُستبدَل المكانُ باللا–مكان، والوطن بالمنفى الجليدي. تتحوّل كوسوفا من “دار” إلى “طيف”، ومن “حديقة” إلى “أشباح”، وهو انقلاب يختزل الألم الجمعي في صورة وجودية ـ فلسفية:
“لا ندري أرحلنا / أم رحلت عنا كوسوفا كالطيف؟”
إنّه سؤال مصيري لا يبحث عن إجابة عقلية، بل عن معنى الفقد في ذاته.
رابعًا: الموسيقى الداخلية وبنية التكرار
تُشكّل الموسيقى الداخلية والتكرار الأداتي عمودًا صوتيًّا في النص. فعبارات مثل:
“وسط الغابات… وسط الظلمات… وسط الأمطار…”
ترسّخ إيقاع الانغلاق والدوّامة. وكذلك تتكرر مفردات الحنين والغياب:
“صرخة”، “دماء”، “جروح”، “الريح”، “الضياع”.
ثم تعود العبارة الافتتاحية في آخر سطر:
“كان لنا في كوسوفا دار…”
لتغلق الدائرة، وتُفعّل تقنية الاسترجاع المؤلم الذي يحوّل الذاكرة إلى لعنة، والوطن إلى صورة تُطلّ من خلف الزجاج.
الخاتمة
قصيدة “شتاء كوسوفا” ليست مجرد رثاء لوطنٍ احترق، بل هي بناء شعريّ مركّب يعيد صياغة الكارثة بلغة تستنطق الألم الإنساني في أبعاده القصوى. لقد نجح الشاعر صلاح عدس في إنتاج نصّ يُحاكي أدب اللجوء، ويحمل في طيّاته خطابًا كونيًّا عن الفقد والمنفى. إنها قصيدة تقف عند تخوم الحسرة الوجودية، والنوستalgji، والحنين الموجوع، حيث تندمج الأنا الجمعية والفردية في صرخة واحدة تتلاشى خلف المطر.
ثالثا: من الفردوس المفقود إلى الزلاقة القادمة: قراءة نقدية في قصيدة “كوسوفا والبوسنة والهرسك” لصلاح عدس
الملخص
تندرج قصيدة “كوسوفا والبوسنة والهرسك” ضمن شعر المقاومة والتحريض في الخطاب العربي الحديث، إذ تعيد تركيب التاريخ الإسلامي بوصفه مرآة للصراعات الراهنة. يقدّم الشاعر الدكتور صلاح عدس من خلالها رؤية نضالية مشحونة بالرموز التاريخية والأسطورية، تربط بين سقوط الأندلس ومآسي كوسوفا والبوسنة، وتدعو إلى نهضة إسلامية شاملة ترتكز على الوعي، الوحدة، واستدعاء النماذج القيادية المشرقة من التاريخ. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البنية الأسلوبية والمضامينية للقصيدة، وتفكيك استراتيجيات الخطاب التحريضي، وقراءة الرمزية التاريخية في سياقها الفني والسياسي.
المقدمة
في زمن التفتت والانقسام، تتجلّى بعض النصوص الشعرية كأصوات صارخة في وجه الخضوع، مستنهضة الذاكرة الجمعية للأمة، ومستحضرة مآسيها بوصفها نداءً إلى الفعل والتوحد. وفي هذا السياق، تبرز قصيدة “كوسوفا والبوسنة والهرسك” كنموذج لشعرٍ يجمع بين الحداد السياسي والتحريض الجهادي الرمزي، ويعيد تأويل الخسارة ضمن أفق استنهاضي، حيث تتحول الجراح إلى طاقة تحفز على المواجهة.
أولًا: من الأندلس إلى كوسوفا – تكرار النموذج وتحوّله
يفتتح الشاعر نصّه بمرثية موجزة:
“ضاعت من أيدينا المشلولة / أحلام الأندلس المفقودة…”
يضع هذا المطلع كوسوفا والبوسنة ضمن امتداد فقدٍ تاريخي مهيمن، يبدأ من سقوط الأندلس كرمز للحضارة الإسلامية الضائعة، ويمتد إلى الجراح الحديثة.
لكن العبارة “تحسس رأسك” تتكرر بصيغة تنبيهية، وتحمل بعدًا وجوديًّا:
“فالقادم نحوك… جنكيزخان وتيمورلنك”
الشاعر هنا لا يرثي الماضي فقط، بل يحذّر من القادم، في محاولة لصدم المتلقي وتحفيزه على إدراك أن التاريخ لا يرحم الغافلين، وأن دور الضحية لم يعد خيارًا مقبولًا.
ثانيًا: استدعاء الرموز – الذاكرة كقوة تعبئة
ينتقل الشاعر إلى نداء رموز تاريخية مشحونة بالبطولة والانتصار:
“ارفع سيفك / واشرب كأس الموت فلست تموت / وستبعث في عين جالوت”
ثم يُستدعى: قطز، بيبرس، أيبك، وصلاح الدين، بوصفهم رموزًا للخلاص والتحرير، ويُربط حضورهم باستعادة حِطّين كرمز للنصر.
وفي هذا السياق، لا يُقدَّم الموت كمأساة، بل كممر للخلود والانبعاث، ضمن تصور إسلامي يربط بين الشهادة والبعث النضالي، حيث تصبح “عين جالوت” لحظة مفصلية يمكن تكرارها.
ثالثًا: الخصم المعاصر – صليبيون جدد وزمن مسموم
يواجه الشاعر الحاضر بلهجة حادة:
“فالقادم خلفك جيش صليبيين / إن هادنت لسوف تخون / في هذا الزمن المأفون”
يتم تأطير الحاضر كـ”زمن الفرعون وقارون”، أي أنه يجمع بين الاستبداد (الفرعون)، الفساد المالي (قارون)، والانحراف القيمي (قوم لوط، ثمود، عاد، أصحاب الأخدود).
كما تُبرز العبارة:
“الدرهم معبود / والمسلم مطرود”
أزمة الهوية الإسلامية، حيث تحلّ المادية مكان الإيمان، ويُقصى المسلم من مركز الحضارة.
هذه المقاطع لا تقدم مجرد رثاء، بل تفكيكًا ساخرًا وموجعًا للواقع المعاصر، وتدعو إلى إعادة تعريف العلاقة بين القيم والسلطة والمصير.
رابعًا: نحو الزلاقة الجديدة – استدعاء الأندلس كأمل
تبلغ القصيدة ذروتها بإحياء معركة “الزلاقة”، التي خاضها يوسف بن تاشفين ضد ألفونسو السادس، حيث يقول:
“واجمعهم يا يوسف بن تاشفين / في الزلاقة…”
يُستعاد هنا البطل المغاربي كقائد للوحدة، في إشارة إلى ضرورة تجاوز التفكك العربي والإسلامي، وجمع “ملوك الطوائف” في تحالف عملي.
• الزلاقة تتحول من حدث تاريخي إلى مشروع مستقبلي رمزي.
• ألفونسو الملعون يصبح نموذجًا للعدو القديم–الجديد.
• أما الفردوس المفقود، فيعاد تأطيره كقيمة قابلة للاسترجاع لا للموت.
خامسًا: الأسلوب الفني والتقنية البلاغية
تعتمد القصيدة على أسلوب تحريضي مباشر، يتكئ على:
• الأمر والتكرار: “ارفع سيفك”، “تحسس رأسك”، “اتحدوا”،
• المفارقة: بين ضعف الحاضر وقوة الماضي،
• الإيقاع الداخلي: القائم على الفعل والحركة،
• الرمز التاريخي: كأساس بنائي ودلالي.
اللغة لا توصف ولا تتأمل، بل تدفع وتحفّز، في سعي لتشكيل خطاب تعبوي شعري.
الخاتمة
قصيدة كوسوفا والبوسنة والهرسك لصلاح عدس تندرج في أدب التحريض الذي لا يكتفي بتشخيص الهزيمة، بل يدعو إلى مشروع نهضوي مستند إلى الذاكرة التاريخية والمواجهة الرمزية. يتجاوز النص سياق المرثية إلى أفق المقاومة الفكرية، حيث يُستدعى التاريخ لا للبكاء عليه، بل كخزان استراتيجي لبناء وعي تحرري. إنها قصيدة تحوّل الجرح إلى نداء، والهزيمة إلى تحذير، والحنين إلى فعل سياسي وشعري في آنٍ واحد.
الفصل الخامس: تَجسيرُ القلوب بين النيل وبريشتينا
قصيدة وإشادة أدبية من الدكتور بكر إسماعيل إلى الدكتور صلاح عدس
مقدمة
تشهد العلاقات الأدبية والفكرية بين المفكرين العرب والأوروبيين المسلمين لحظات من التفاعل العميق والتكامل الإنساني والثقافي، وقلّما نجد تجسيدًا حيًّا لهذه العلاقات كما هي في الصداقة الطويلة والعميقة بين الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي والدكتور صلاح عدس المصري. لقد جمعتهما قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية كوسوفا، فتحولت العلاقة بينهما من تعاون علمي إلى رباط وجداني، عبّرت عنه النصوص المتبادلة والقصائد المهداة والمواقف المشتركة.
في هذا الفصل، نقدم قصيدة مهداة من الدكتور بكر إسماعيل إلى الدكتور صلاح عدس، تتناول هذه العلاقة بروح شعرية رفيعة، تُمثّل امتدادًا لما خطه صلاح عدس نفسه في ديوانه “الطريق إلى مكة”، حين قال:
“إلى صديقي العزيز والمفكر والكاتب الأستاذ بكر إسماعيل، مع وافر حبي وتقديري لك ولشعب كوسوفا العظيم، الذي كتبتُ له بعض القصائد في هذه المجموعة.”
القصيدة: “من نيلِكَ جئنا.. إلى دمعتنا في بريشتينا”
إلى صديقي الشاعر والمفكر الدكتور صلاح عدس، مع المحبة والوفاء
من نيلِكَ جئنا..
نحمل دفءَ الحكايا، وعبق الأزهر فينا
نقرأ من دفاترك القديمة
خريطةَ شعبٍ قاومَ..
وصوتَ طفلٍ قال: “أنا كوسوفا”
وأنتَ صغتَه شعرًا.. ونثرًا.. وجمرةً في المدى
من نيلِكَ جئنا..
نُصافح يدك التي كتبتْ لنا
بين مصرعِ كليوباترا
وانتصارِ الزلاقة القادم
فأيقظتَ فينا الوعي..
وشيدتَ في “الطريق إلى مكة”
مئذنةً تنادي باسم كوسوفا..
أيها الصديقُ،
يا من جمعتَ نيلَ القاهرة
بدمعةِ بريشتينا..
وأهديتنا من وجدانك
أغانٍ لا تموت..
وأنشودةً تقول:
“لكم كتبتُ.. ولقلوبكم أُحبّ”
التحليل الأدبي والنقدي للقصيدة
أولًا: البنية الموضوعية
القصيدة تبني جسرًا وجدانيًّا وإنسانيًّا بين قاهرة النيل وبريشتينا المقاومة، وتُبرز كيف يمكن أن يلتقي العقل العربي مع القضية كوسوفا من خلال الكلمة الصادقة والانتماء الثقافي. العلاقة بين الدكتور بكر والدكتورعدس ليست فقط شخصية، بل تُعبر عن اندماج وجداني ثقافي بين الشرق الأوسط والبلقان الإسلامي.
تبني القصيدة جسرًا عاطفيًا وإنسانيًا بين القاهرة على ضفاف النيل وبريشتينا الصامدة، مسلطةً الضوء على كيفية ارتباط العقل العربي بقضية كوسوفو من خلال الكلمات الصادقة والانتماء الثقافي. ليست العلاقة بين بكر وآدا علاقة شخصية فحسب، بل تُعبّر عن اتحاد عاطفي وثقافي بين الشرق الأوسط ومنطقة البلقان الإسلامية.
ثانيًا: اللغة والأسلوب
اعتمد النص على لغة شعرية ذات طابع وجداني شفاف، مع توظيف مكونات بلاغية كـ:
• النداء العاطفي (“أيها الصديق”)
• التكرار (“من نيلك جئنا”) لتعميق الإيقاع الدرامي
• الصور الحسية (“دفء الحكايا”، “دمعة بريشتينا”)
هذا الأسلوب يعزز التأثير العاطفي المباشر، ويمنح القصيدة نَفَسًا ملحميًّا وإنسانيًّا.
ثالثًا: الرمزية والإيحاء
• النيل: رمز للحضارة، للتاريخ، وللعطاء المتجدد.
• بريشتينا: تمثل الوجع والمقاومة والصمود.
• كوسوفا: تظهر في القصيدة كـ”طفل قال أنا كوسوفا”، وهي صورة تلخّص براءة القضية وعدالة الصوت.
• “الطريق إلى مكة”: إشارة ضمنية إلى ديوان عدس، واستخدامها هنا يفتح أفقًا تأويليًا نحو المعنى الروحي والرسالي للشعر في خدمة الأمة.
رابعًا: الدلالة السياسية والثقافية
القصيدة تحمل رسالة سياسية ضمنية، مفادها أن التضامن الحقيقي لا يحتاج إلى شعارات سياسية، بل إلى قلم صادق وقلب مفتوح. يُقدَّم صلاح عدس في هذه القصيدة كمثقف عضوي، يعيش قضايا الأمة أينما كانت، لا يحبس نفسه في جغرافيا واحدة.
خامسًا: الوظيفة الثقافية والتكاملية
يتجلى في هذه القصيدة نموذج نادر لما يمكن أن تحققه الثقافة من جسور روحية بين الشعوب الإسلامية، حتى وإن فصلت بينها المسافات أو ظروف التاريخ والجغرافيا.
الخاتمة:
تُجسّد هذه القصيدة، بما فيها من مشاعر ووفاء ورموز، طبيعة العلاقة الأدبية والفكرية بين مفكرَيْن كبيرَيْن، يمثلان جيلًا من المثقفين العرب والمسلمين الذين لم يكتفوا بإنتاج المعرفة، بل حوّلوها إلى رسالة وجدانية ذات امتداد إنساني وتاريخي. هي قصيدة توثيق، لكنها أيضًا بيان شعري عن القوة الأخلاقية للكلمة حين تُكتب بحبر القلوب لا بحبر الأقلام فقط.
الكلمات المفتاحية
كوسوفا، البوسنة، الأندلس، الشعر السياسي، صلاح عدس، بكر إسماعيل، المقاومة، التحية، الإسلام، الرمزية التاريخية،
ديوان الطريق إلى مكة.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
E-mail: [email protected]