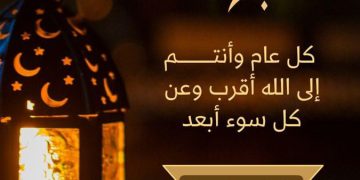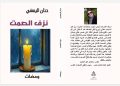الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس (1948-2025م)
عالم الأدب والإنسان: رحلة العطاء الفكري والشعري بين الأصالة والمعاصرة
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
[email protected]
الملخص
يتناول هذا البحث سيرة وإنجازات الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس، أحد أبرز أعلام الفكر والأدب في العالم العربي والإسلامي المعاصر. يجمع البحث بين التوثيق السيرذاتي والتحليل النقدي، مسلطًا الضوء على مسيرته العلمية الحافلة بوصفه أستاذًا جامعيًا، وناقدًا أدبيًا، وشاعرًا مبدعًا، ومفكرًا إسلاميًا. يهدف المقال إلى تقييم أثره متعدد الأبعاد في الحقول المعرفية المختلفة: الأدبية والنقدية والشعرية والثقافية وحتى السياسية من خلال مواقفه الفكرية. ينقسم البحث إلى فصول تتناول مولده وتحصيله العلمي، ومسيرته الوظيفية والأكاديمية، وعضوياته ومشاركاته النشطة، ومؤلفاته وآثاره العلمية والإبداعية، مختتمًا بخلاصة تقيّم مكانته وإرثه الفكري. يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي، مقدِّمًا صورة شاملة لعالم جعل من حياته جسرًا بين التراث والمعاصرة، وبين الإبداع والنقد، وبين المحلية والعالمية الإسلامية.
المقدمة
يشكل حضور العلامة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس نموذجًا فريدًا للعالم الموسوعي الذي جمع بين التخصص الدقيق في علوم اللغة العربية وآدابها، والإبداع الشعري الأصيل، والالتزام الفكري الراسخ بمشروع “الأدب الإسلامي” كمنهج نقدي ورؤية للعالم. لم يكن الراحل مجرد أستاذ جامعي تقليدي، بل كان مشروعًا ثقافيًا متكاملاً، انعكست آثاره على أجيال من الباحثين والأدباء داخل مصر وخارجها. يأتي هذا المقال كمحاولة لتقييم هذه المسيرة الغنية، لا من خلال سرد الوقائع فحسب، بل من خلال تحليل أبعادها الفكرية والجمالية وتأثيرها في تشكيل الخريطة الأدبية والنقدية المعاصرة، مسلطًا الضوء على كيفيّة توظيفه لتراثه الأزهري العميق في قراءة التراث ومواكبة الحداثة، مع الحفاظ على بوصلة قيمية واضحة.
الفصل الأول: الولادة والتكوين: بذور العالم والأديب
تمثل مرحلة التكوين الأولى للأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس الأساس المتين الذي قام عليه صرحه الفكري والشعري اللاحق. فولادته في رحم الريف المصري (قرية منشية العطارين، الشرقية، 1948م) منحته صلةً عضوية بالأرض والإنسان والموروث الثقافي الشعبي. غير أن البعد الأهم في هذه المرحلة هو حفظه للقرآن الكريم في سن مبكرة (التاسعة)، مما غرس في وجدانه النظم اللغوي البديع، والشعور بالإيقاع، والتذوق الجمالي للكلمة المعبِّرة الموحية، وهي مقومات ستظهر جليًا في شعره ونقده لاحقًا.
اتخذ مساره التعليمي طابعًا مؤسسيًا واضحًا من خلال التحاقه بمعهد الزقازيق الديني الأزهري، ثم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، حيث تخرج حاملًا لبكالوريوس اللغة العربية عام 1972. لم يكن هذا المسار مجرد تحصيل للمعارف، بل كان انغماسًا في المنظومة القيمية والعلمية للأزهر الشريف، التي ترى في اللغة العربية والأدب وعاءً للفكر الإسلامي ووسيلةً لإبلاغه. وقد أكمل هذا التكوين بحصوله على درجة الماجستير (1975) ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى (1981) في تخصص الأدب والنقد، ليخرج إلى الحياة العلمية مُسلَّحًا بأدوات المنهج الأكاديمي الصارم، ومشبعًا بروح التراث الإسلامي.
الفصل الثاني: المسيرة الأكاديمية والعملية: بناء الجسور بين القاهرة ومكة
تجسِّد مسيرة الدكتور يونس العملية نموذجًا للمفكر العربي المسلم المنفتح على محيطه، الذي لا تنحسر همومه داخل أسوار الجامعة. بدأ مدرسًا في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك تجربة ثرية في ليبيا (1976-1980)، وهي تجربة أثرت مخزونه الثقافي وأتاحت له الاحتكاك ببيئة عربية أخرى.
مع حصوله على الدكتوراه، انتقل إلى سلك التدريس الجامعي في جامعة الأزهر (1981)، لتبدأ مرحلة العطاء الأكاديمي الأخصب. تميزت هذه المرحلة بحركة دؤوبة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث عمل أستاذًا مشاركًا ثم أستاذًا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة (1984-1988، 1994-2000)، وأستاذًا زائرًا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1993). لم تكن هذه الإعارات والزيارات مجرد وظائف، بل كانت جسورًا لنقل رؤيته النقدية والأدبية، وتأطير المشروع الأدبي الإسلامي في بيئتين رئيستين للفكر الإسلامي الحديث (الأزهر وأم القرى).
توجت مسيرته الإدارية بتوليه منصب عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق (2007-2013)، حيث أسهم في تطوير العمل الأكاديمي والإشراف على عشرات الرسائل العلمية (ناقش وأشرف على قرابة مائتي رسالة). كما مثلت عضويته في اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر (“لجنة المحكمين”) وإدارته لتحرير المجلة العلمية للكلية، جانبًا آخر من مسؤوليته في قيادة وتطوير الحقل الأكاديمي وتنقيته من الشوائب غير العلمية.
الفصل الثالث: النشاط الثقافي والعضويات: المفكر في الفضاء العام
لم ينعزل الدكتور صابر عبد الدايم يونس في برجه الأكاديمي العاجي، بل كان المفكر العام المنخرط بقوة في الحقل الثقافي المصري والعربي. وتكشف عضوياته عن اتساع رقعة تأثيره وتنوعها:
• اتحاد كتاب مصر: حيث كان عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الفروع، مما يوضح حضوره في التيار الأدبي العام واهتمامه بتفعيل الحركة الأدبية في المحافظات.
• رابطة الأدب الإسلامي العالمية: وهي العضوية المحورية التي تشير إلى انتمائه الفكري والمنهجي. لم يكن عضوًا عاديًا، بل كان نائبًا للرئيس للشؤون الثقافية ورئيسًا لمكتبها في القاهرة، مما جعله أحد أبرز منظري وممارسي هذا التوجه الأدبي في مصر.
• المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وهي عضوية تعكس اعتراف المؤسسة الدينية الرسمية بمكانته الفكرية والدينية.
• تأسيس الصالون الأدبي الشهري بالزقازيق (1990): وهي مبادرة شخصية تجسد مفهوم “النخبة المثقفة” الفاعلة في مجتمعها، حيث حوّل منزله إلى منارة ثقافية شهرية تحتضن الحوار والنقد والإبداع، مما أسهم في تنشيط الحركة الأدبية الإقليمية وتكوين أجيال جديدة من الأدباء.
كما تظهر قائمة مؤتمراته المشارك فيها (من مؤتمر العقاد في أسوان إلى مؤتمرات الأدب الإسلامي في إسطنبول والقاهرة والجنادرية السعودية) صورة العالم الرحال الذي ينقل رؤيته ويتبادل الأفكار على أوسع نطاق. ولم يقتصر نشاطه على المحافل المتخصصة، بل امتد إلى الإعلام (إذاعات القرآن الكريم والعرب والبرنامج العام، وقنوات التلفزيون المختلفة) ليبلغ شرائح أوسع من الجمهور، مجسدًا دور المثقف العضوي الذي يشارك في تشكيل الوعي الجمعي.
الفصل الرابع: المؤلفات والآثار: بين التنظير النقدي والإبداع الشعري
يتميز نتاج الدكتور صابر عبد الدايم العلمي والإبداعي بالغزارة والتنوع، وهو ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة:
1. المؤلفات النقدية والدراسات الأدبية:
تمثل كتبه مثل “القيم الإسلامية في الأدب العربي” (1982)، و”الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق” (1990)، و”موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور” (1992)، و”الحديث النبوي: رؤية فنية جمالية” (1999) أركانًا أساسية في مشروعه النقدي. لقد سعى في هذه المؤلفات إلى:
• تأصيل منهج نقدي إسلامي يقوم على استنباط المعايير النقدية من المنظومة القيمية الإسلامية، وليس استيرادها حصريًا من المناهج الغربية.
• الكشف عن الجمال الفني في التراث الإسلامي، كما في دراسة الحديث النبوي، معتبرًا إياه نصًا أدبيًا مكتملاً بمعاييره البلاغية والجمالية.
• ربط النقد بالإبداع من خلال الدراسات التطبيقية كما في كتابه “شعراء وتجارب: نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقي”.
2. الإبداع الشعري:
يعد ديوانه الشعري سجلًا ذاتيًا لتجربته الإنسانية والفكرية، من “نبضات قلبين” (1969) إلى “العمر والريح” (2003). يجمع شعره بين أصالة اللغة وجزالتها، المعتمدة على ثقافته التراثية العميقة، وبين هموم الإنسان المعاصر وقضاياه. تهيمن على قصائده الموضوعات الإسلامية والقومية والإنسانية، مع حضور قوي للرؤية الصوفية العرفانية في بعضها، مما يجعله شاعرًا ملتزمًا بقضية دون أن يفقد شعريته أو ينغلق على خطاب وعظي مباشر.
3. الدراسات التي كُتبت عنه:
يشير العدد الكبير من الرسائل الجامعية (15 رسالة ماجستير ودكتوراه) والكتب النقدية التي dissected تجربته (مثل كتابي د. صادق حبيب ود. صلاح عدس) إلى مدى التأثير الذي أحدثه، وأنه أصبح ظاهرة أدبية ونقدية تستحق الدراسة والتحليل بذاتها. لقد تجاوز كونه موضوعًا للبحث ليكون مدرسة نقدية وشعرية لها أتباعها ودارسوها.
الفصل الخامس: قراءة نقدية في خمسة أعمال للدكتور صابر عبد الدايم يونس
يأتي هذا الفصل كمحاولة جادّة لتسليط الضوء على إسهامات نقدية وأدبية متميزة في المشهد الثقافي العربي المعاصر، من خلال دراسة نقدية متأنية لخمسة أعمال للدكتور صابر عبد الدايم يونس. تُعد هذه الأعمال نماذجَ بارزةً تجمع بين الأصالة والحداثة، بين العمق النظري والتطبيق العملي، وبين الالتزام بالقيم الإسلامية والانفتاح على الإنسانية. تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك المناهج النقدية والأدبية التي تبناها المؤلف، وتحليل رؤيته الحضارية، وتقييم أثر هذه الأعمال في حقولها المعرفية المختلفة. كما تهدف إلى تقديم قراءة متكاملة تُبرز دور الأدب والنقد في تشكيل الوعي الجمعي وبناء الهوية في ظل التحولات الفكرية والثقافية التي تشهدها الأمة.
1. كتاب: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق
دراسة نقدية موسّعة في المفاهيم والمنهج والتأثير
في ظل التحولات الفكرية والثقافية التي شهدها العالم العربي والإسلامي خلال العقود الأخيرة، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم الأدبية التي تحكم الإنتاج الثقافي، وتحديدًا في ما يتعلق بالأدب الإسلامي بوصفه خطابًا حضاريًا وجماليًا يحمل رؤية متميزة للإنسان والكون والقيم. يأتي كتاب الدكتور صابر عبد الدايم يونس: “الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق” ليشكّل مساهمة نوعية في هذا السياق، حيث لا يكتفي بتأصيل المفاهيم النظرية، بل يسعى إلى اختبارها من خلال نماذج تطبيقية تنتمي إلى التراث والمعاصرة على حد سواء.
تتناول هذه الدراسة الكتاب من زاوية نقدية موسّعة، تستعرض بنيته المنهجية، وتفكك أطروحاته النظرية، وتحلل نماذجه التطبيقية، ثم تقيّم أثره في الحقول الفكرية والأدبية والثقافية والعلمية، في محاولة لتحديد موقعه ضمن خارطة النقد الإسلامي المعاصر.
أولًا: البنية المنهجية للكتاب
يتوزع الكتاب على قسمين رئيسيين:
• القسم الأول: تنظيري، يرسّخ المفاهيم الأساسية للأدب الإسلامي، ويعرض إشكاليات التعريف، والوظيفة، والهوية، مستندًا إلى التصور الإسلامي للوجود.
• القسم الثاني: تطبيقي، يتناول نماذج أدبية متنوعة، من البيان النبوي إلى الشعر الإسلامي، محللًا خصائصها الجمالية والفكرية.
يعتمد المؤلف على منهج تركيبي يجمع بين التحليل الفني والرؤية القيمية، ويستند إلى مصادر تراثية ومعاصرة، مثل أعمال سيد قطب، محمد قطب، وعماد الدين خليل، مما يمنح الكتاب طابعًا موسوعيًا نقديًا.
ثانيًا: التأصيل النظري للأدب الإسلامي
1. إشكالية التعريف
يناقش المؤلف إشكالية تعريف الأدب الإسلامي، ويقترح تصورًا يتجاوز التصنيف الديني الضيق، ليشمل كل أدب ينبثق عن رؤية إسلامية للوجود، حتى وإن لم يتناول موضوعات دينية مباشرة. هذا التعريف يتمايز عن الطروحات التقليدية التي تربط الأدب الإسلامي بالمضامين الوعظية أو النصوص الدينية.
2. الوظيفة الأدبية
يرفض المؤلف الفصل بين الجمال والقيمة، ويؤكد أن الأدب الإسلامي لا يتخلى عن الوظيفة التربوية، بل يدمجها ضمن البنية الجمالية للنص، في تماهٍ بين الشكل والمضمون. ويطرح بذلك تصورًا مغايرًا للوظيفة الأدبية، يتجاوز التسلية أو التعبير الذاتي إلى بناء الإنسان وتشكيل الوعي.
3. العلاقة بالتراث والحداثة
يتبنى المؤلف موقفًا نقديًا من الحداثة الغربية، دون أن يسقط في الانغلاق التراثي. فهو يدعو إلى أدب إسلامي منفتح على الإنسانية، دون التفريط في الخصوصية الحضارية، ويؤكد أن الأدب الإسلامي قادر على استيعاب تقنيات الحداثة دون أن يفقد روحه.
ثالثًا: النماذج التطبيقية
1. البيان النبوي
تحليل البيان النبوي في خطبة حجة الوداع يكشف عن تماهي البلاغة مع القيم، ويؤكد أن الأدب الإسلامي لا ينفصل عن النصوص المؤسسة، بل يستلهم منها روحًا وأسلوبًا. ويُظهر المؤلف كيف أن الخطاب النبوي يجمع بين الإيجاز، والإيقاع، والحمولة القيمية، مما يجعله نموذجًا أدبيًا راقيًا.
2. شعر حسان بن ثابت
يُقدَّم شعر حسان بن ثابت كنموذج للشعر الإسلامي، ويُظهر كيف يمكن للشعر أن يكون أداة للدفاع عن العقيدة دون أن يفقد جمالياته. ويُبرز المؤلف عناصر البلاغة، والرمز، والتصوير الفني في شعر حسان، مما يثبت أن الشعر الإسلامي لا يقتصر على المضمون، بل يحقق شروط الفن الرفيع.
3. أدب الطفولة
يتناول المؤلف أدب الطفولة في ضوء التصور الإسلامي، ويُعد هذا من الإسهامات النادرة في النقد التربوي الإسلامي. ويؤكد أن بناء وجدان الطفل عبر الأدب هو مسؤولية حضارية، ويطرح نماذج أدبية تحقق التوازن بين التسلية والتربية، مثل قصص الحيوان والرمز التربوي.
رابعًا: اللغة والأسلوب
• يتميز أسلوب الدكتور صابر عبد الدايم بالرصانة والوضوح، مع ميل إلى التقريرية في بعض المواضع، لكنه يوازن ذلك بالتحليل العميق.
• يستخدم لغة نقدية دقيقة، ويحرص على توثيق آرائه بمصادر تراثية ومعاصرة، مما يمنح الكتاب طابعًا أكاديميًا رفيعًا.
• يدمج بين المصطلحات النقدية الحديثة والمفاهيم الإسلامية، مما يخلق خطابًا نقديًا هجينًا، قادرًا على مخاطبة القارئ الأكاديمي والمهتم بالشأن الإسلامي في آنٍ واحد.
خامسًا: أثر الكتاب في الحقول الفكرية والأدبية والثقافية والعلمية
الأثر المجال
أعاد تعريف العلاقة بين الأدب والدين، وفتح بابًا للنقاش حول الهوية الأدبية الإسلامية في العصر الحديث. الفكر الإسلامي
أسهم في بلورة تيار نقدي إسلامي، وقدم أدوات منهجية لتحليل النصوص من منظور قيمي وجمالي. النقد الأدبي
عزز الوعي بأهمية الأدب في بناء الهوية الثقافية، وطرح أسئلة جوهرية حول وظيفة الأدب في المجتمعات الإسلامية. الثقافة العامة
يُعد مرجعًا في الدراسات الأدبية الإسلامية، ويُستخدم في الجامعات كمصدر تأسيسي في النقد الإسلامي. البحث العلمي
يمثل كتاب “الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق” للدكتور صابر عبد الدايم يونس مساهمة تأسيسية في النقد الإسلامي المعاصر، إذ يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، ويقدم رؤية متكاملة تعانق الجمال والقيم. إنه ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل دعوة لإعادة بناء الذائقة الأدبية على أسس حضارية وإنسانية، تستلهم من الإسلام روحًا لا قالبًا، ومن التراث جوهرًا لا شكلاً.
إن هذا الكتاب لا يُقرأ فقط، بل يُستأنف منه مشروع نقدي متجدد، يليق بأمة تبحث عن ذاتها في مرايا الأدب، ويستحق أن يكون منطلقًا لأعمال نقدية جديدة تعيد الاعتبار للأدب بوصفه فعلًا حضاريًا وإنسانيًا.
2. كتاب: الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة
الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة: قراءة نقدية في تأسيس المنهج الحضاري
يشهد الأدب المقارن العربي تحولات منهجية وفكرية متسارعة، تتراوح بين التبعية للنماذج الغربية وبين محاولات التأصيل المحلي. وفي هذا السياق، يبرز كتاب الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة للدكتور صابر عبد الدايم يونس بوصفه محاولة جادة لتأسيس خطاب نقدي عربي في الأدب المقارن، يستند إلى التراث الثقافي الإسلامي والعربي، وينفتح على المعاصرة دون أن يفقد هويته. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البنية الفكرية والمنهجية للكتاب، وتقييم أثره في الحقل الأدبي والفكري، من خلال قراءة نقدية موسعة تستند إلى أدوات التحليل المقارن، والنقد الثقافي، والمنهج التاريخي.
أولًا: الإطار المفاهيمي والمنهجي
1. مفهوم الأدب المقارن في ضوء التراث
• ينطلق المؤلف من رفض القطيعة المعرفية بين الأدب المقارن والتراث، مؤكدًا أن التفاعل بين الآداب لا يمكن فصله عن السياقات الحضارية التي أنتجتها.
• يطرح مفهومًا موسعًا للأدب المقارن، لا يقتصر على دراسة التأثير والتأثر، بل يشمل تحليل البنية القيمية للنصوص، واستكشاف آليات التفاعل الثقافي.
2. نقد النموذج الغربي
• يوجه المؤلف نقدًا منهجيًا للنموذج الفرنسي التقليدي في الأدب المقارن، الذي يركز على العلاقات الثنائية بين الآداب، ويغفل البعد الحضاري.
• يدعو إلى تجاوز النموذج الأمريكي الذي يدمج الأدب المقارن في الدراسات الثقافية، دون تأسيس منهج نقدي مستقل.
3. نحو تأسيس منهج عربي
• يقترح المؤلف منهجًا عربيًا في الأدب المقارن، يقوم على استلهام التراث النقدي العربي (كابن طباطبا، والجرجاني، وابن خلدون)، ويستجيب لمقتضيات العصر.
• يربط هذا المنهج بالهوية الثقافية، ويؤكد على ضرورة بناء خطاب نقدي قادر على التفاعل مع الآخر دون الذوبان فيه.
ثانيًا: البنية المعرفية والتحليلية للكتاب
1. التوزيع الموضوعي للفصول
• يتناول الكتاب قضايا مركزية مثل: تعريف الأدب المقارن، إشكالية الترجمة، التفاعل بين الآداب، دور الأدب المقارن في بناء الهوية، ونماذج تطبيقية من الأدب العربي والعالمي.
• يعتمد على أمثلة أدبية من الشعر العربي القديم، والنثر المعاصر، ويقارنها بنصوص من الأدب الفرنسي، الإنجليزي، والفارسي، مما يعكس قدرة تحليلية عالية.
2. التفاعل النصي والثقافي
• يبرز المؤلف أهمية التفاعل النصي بين الآداب، من خلال تحليل العلاقات بين النصوص، واستكشاف الأبعاد الجمالية والفكرية المشتركة.
• يركز على مفهوم “التماثل الحضاري” بدلًا من “التأثير والتأثر”، مما يمنح الدراسة بعدًا فلسفيًا وثقافيًا.
3. اللغة والأسلوب
• يتسم أسلوب الكتاب بالرصانة الأكاديمية، مع توظيف دقيق للمصطلحات النقدية، دون أن يغيب البعد الجمالي عن الكتابة.
• يوازن بين التحليل النظري والسرد الأدبي، مما يجعله مناسبًا للباحثين والقراء المثقفين على حد سواء.
ثالثًا: أثر الكتاب في الحقول المعرفية
الأثر المجال
أعاد تعريف الأدب المقارن من منظور عربي، وفتح المجال لنقاشات حول الهوية والمنهج الفكر النقدي
أتاح أدوات جديدة لفهم النصوص في سياقها العالمي، دون التفريط بخصوصيتها الأدب العربي
عزز الوعي بأهمية الحوار بين الثقافات، وضرورة الانفتاح النقدي على الآخر الثقافة العامة
شكّل مرجعًا أكاديميًا في الجامعات، وأثرى الدراسات العليا في الأدب والنقد البحث العلمي
يمثل كتاب الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة مساهمة نوعية في تأصيل منهج الأدب المقارن العربي، ويشكل دعوة صريحة لإعادة النظر في مناهجنا النقدية، وتأسيس خطاب أدبي قادر على التفاعل مع العالم دون أن يفقد جذوره. إنه عمل يجمع بين الرؤية الحضارية، والمنهجية الأكاديمية، والوعي النقدي، ويستحق أن يكون مرجعًا في الدراسات الأدبية المقارنة، وفي بناء خطاب ثقافي عربي معاصر.
3. كتاب: تاج المدائح النبوية: قراءة نقدية تكاملية في تجربة كعب بن زهير الشعرية
دراسة في البنية، الجماليات، والتحوّل الفكري
تُعد قصيدة “البردة” لكعب بن زهير واحدة من أبرز النصوص الشعرية التي ارتبطت بالتحول الفكري والروحي في صدر الإسلام، وقد حظيت باهتمام بالغ من قبل الشراح والنقاد عبر العصور. غير أن كتاب “تاج المدائح النبوية” للدكتور صابر عبد الدايم يمثل نقلة نوعية في تناول هذا النص، إذ لا يكتفي بالشرح اللغوي أو البلاغي، بل يقدّم رؤية نقدية معاصرة تتكئ على منهج تكاملي يستوعب الأبعاد النفسية، التاريخية، الجمالية، والرمزية للقصيدة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكتاب بوصفه نموذجًا نقديًا متكاملًا، يربط بين الشعر والهوية، بين النص والتحول، وبين المدح النبوي والتجربة الإنسانية. كما تسعى إلى تقييم أثره في الحقول الأدبية والفكرية والثقافية، وتحديد موقعه ضمن خارطة النقد الإسلامي المعاصر.
أولًا: المنهج النقدي في الكتاب
1. المنهج التكاملي:
• يجمع الدكتور عبد الدايم بين أدوات النقد العربي القديم (البلاغة، النحو، المعجم، الصوتيات) وبين منجزات النقد الحديث (التحليل النفسي، الجماليات، البنيوية، السياقية).
• يحرص على رصد العمل الأدبي من جوانبه النفسية والتاريخية والفنية والبيئية، مما يمنح الدراسة عمقًا متعدد الأبعاد.
2. التأسيس المنهجي:
• يبدأ الكتاب بتوثيق مصادر النص الشعري، متتبعًا المخطوطات والروايات المختلفة، مما يضفي على الدراسة طابعًا علميًا رصينًا.
• يقدّم ترجمة دقيقة للشاعر كعب بن زهير، ويحلل جذور موهبته ضمن مدرسة “التجويد والتنقيح” التي أسسها والده زهير بن أبي سلمى.
ثانيًا: بنية القصيدة وتحوّلاتها الدلالية
1. التجربة الشعرية:
• يرى المؤلف أن القصيدة ليست مجرد مدح أو اعتذار، بل تجربة وجودية تمثل تحولًا من الجاهلية إلى الإسلام، ومن التيه إلى اليقين.
• يقرأ القصيدة بوصفها نصًا مركبًا من دوائر شعورية:
o دائرة الوهم (سعاد)
o الواقع الجريح والهوية المرفوضة
o الناقة المسافرة في رؤى الفزع
o إيقاع الصمود ولحن البراءة
o موقف الفزع والهيبة والرجاء
o منارة الوصول: محمد رسول الله ﷺ
2. البنية الزمنية:
• يحلل الدكتور عبد الدايم أبعاد الزمن اللغوي والاجتماعي والطبيعي في القصيدة، ويكشف كيف أن كعب يتأرجح بين زمنين: زمن الجاهلية وزمن الإسلام.
• يبرز كيف أن الفعل الشعري نفسه هو فعل مقاومة للزمن الآفل، واستشراف لزمن النور والهداية.
ثالثًا: البعد الجمالي والتشكيل الفني
1. الصورة الشعرية:
• يتعامل مع الصور الشعرية بوصفها لوحات تشكيلية، ويحلل التراكيب من حيث الإيقاع الداخلي، الترصيع، التقسيم، والتقفية.
• يربط بين الشعر وفنون التعبير الأخرى: الرسم، النحت، الموسيقى، مما يعكس وعيًا نقديًا حديثًا بتداخل الفنون.
2. التشكيل الصوتي:
• يبرز كيف أن تكرار الأصوات الشديدة (مثل القاف) في لحظات التوتر يعكس الحالة النفسية للشاعر.
• يربط بين الإيقاع الخارجي والداخلي، ويكشف عن دور البحر الشعري (البسيط) في تجسيد حركة الناقة، وتوتر التجربة.
3. الرمز والتأويل:
• يفسر “سعاد” بوصفها رمزًا للماضي الآفل، والناقة بوصفها وسيلة انتقال بين العالمين.
• يستحضر رموزًا من الطبيعة الحية (الظبي، الحرباء، الأسد، الفيل) لتجسيد مشاعر الفزع، الهيبة، والتحول.
رابعًا: أثر الكتاب في الحقول الفكرية والأدبية
1. في الفكر الإسلامي:
• يعيد الاعتبار للشعر بوصفه أداة دعوية وفكرية، ويؤكد أن المدائح النبوية ليست ترفًا بل تجسيدًا لقيم الإسلام في الفن.
2. في النقد الأدبي:
• يؤسس لمنهج نقدي إسلامي معاصر، يزاوج بين التراث والحداثة، ويقدم نموذجًا تطبيقيًا يمكن البناء عليه في دراسة الشعر الإسلامي.
3. في الثقافة العربية:
• يربط بين الشعر والهوية، ويكشف كيف أن قصيدة “البردة” شكلت ذاكرة ثقافية ممتدة، أثرت في الشعراء والنقاد والمجتمعات.
4. في التعليم والبحث العلمي:
• يمثل الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين في الأدب الإسلامي، ويصلح أن يكون مادة دراسية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
يمثل كتاب “تاج المدائح النبوية” للدكتور صابر عبد الدايم علامة فارقة في النقد الأدبي الإسلامي، إذ يقدّم قراءة عميقة لقصيدة “البردة” بوصفها تجربة إنسانية وإيمانية وجمالية. ومن خلال منهجه التكاملي، يفتح آفاقًا جديدة لفهم الشعر بوصفه نصًا حيًا، متجددًا، قادرًا على التعبير عن التحولات الكبرى في حياة الإنسان والمجتمع.
إن هذا الكتاب لا يشرح قصيدة عظيمة فحسب، بل يعيد تشكيل العلاقة بين الشعر والدين، بين الفن والهوية، بين الماضي والحاضر. وهو بذلك يستحق أن يُدرّس ويُحتفى به، وأن يُعد مرجعًا تأسيسيًا في النقد الإسلامي المعاصر.
4. كتاب: شعراء وتجارب: نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقي
دراسة نقدية في المنهج والرؤية الحضارية
بين الحاجة إلى المنهج والتجربة النقدية
في ظل التعدد المنهجي الذي يشهده النقد الأدبي العربي المعاصر، تتبدّى الحاجة إلى رؤية نقدية تتجاوز التجزيئية وتستوعب خصوصية النص العربي، دون أن تقع في أسر الانطباعية أو الجمود البنيوي. يأتي كتاب “شعراء وتجارب: نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقي” للدكتور صابر عبد الدايم بوصفه محاولة جادة لتأسيس منهج نقدي عربي أصيل، يجمع بين الذائقة الجمالية والوعي الحضاري، ويعيد الاعتبار لوظيفة الأدب في بناء الإنسان والمجتمع.
أولًا: المنهج التكاملي – المفهوم والمرجعية الحضارية
1. تعريف المنهج التكاملي
• المنهج التكاملي كما يطرحه عبد الدايم هو رؤية تحليلية تتجاوز الفصل بين الشكل والمضمون، وتدمج بين البعد الفني، القيمي، والتاريخي.
• لا يقتصر التكامل على جمع المناهج، بل يتأسس على تصور معرفي يرى الأدب بوصفه خطابًا حضاريًا، له وظيفة تربوية وجمالية.
2. المرجعية الإسلامية والعربية
• يستند عبد الدايم إلى مرجعية إسلامية ترى في الأدب وسيلة للتهذيب والتنوير، لا مجرد ترف لغوي.
• يستلهم من التراث النقدي العربي (كالجرجاني وابن طباطبا) مفاهيم البلاغة والتأثير، ويعيد توظيفها في قراءة الشعر الحديث.
3. العلاقة بين النقد والهوية
• يؤمن المؤلف بأن النقد ليس فعلاً تقنيًا فحسب، بل هو ممارسة ثقافية تعكس رؤية حضارية، وتشارك في تشكيل الوعي الجمعي.
• يرفض النزعة التغريبية التي تفصل الأدب عن سياقه القيمي، ويؤكد على ضرورة أن يكون النقد منتمياً إلى بيئته الفكرية.
ثانيًا: التجارب الشعرية – قراءة تطبيقية في ضوء المنهج
1. تنوّع التجارب الشعرية
• يتناول الكتاب نماذج شعرية من أجيال مختلفة، ويحللها في ضوء المنهج التكاملي، كاشفًا عن التفاعل بين الرؤية الشعرية والبنية الفنية.
• يبرز في التحليل اهتمام المؤلف بالبعد الإيماني والوجداني، دون أن يغفل عن التقنيات الشعرية الحديثة.
2. أدوات التحليل
• يستخدم عبد الدايم أدوات متعددة: تحليل الصورة الشعرية، الإيقاع، التناص، البنية الدلالية، مع ربطها بالسياق الحضاري.
• يوازن بين التحليل الفني والتأويل القيمي، مما يمنح قراءاته عمقًا مزدوجًا: جماليًا وفكريًا.
3. نقد مقارن
• يمكن مقارنة منهج عبد الدايم بمنهج صلاح فضل أو عبد العزيز حمودة، حيث يختلف في تأكيده على البعد الرسالي للأدب، بينما يميل الآخرون إلى التحليل البنيوي أو التفكيكي.
• يتفوق المنهج التكاملي في قدرته على استيعاب النص العربي دون تشويهه أو تغريبه.
ثالثًا: اللغة النقدية والأسلوب
• يتميز أسلوب عبد الدايم بالرصانة والوضوح، ويجمع بين العمق الأكاديمي والحميمية الأدبية.
• يستخدم لغة نقدية مشبعة بالإحالات التراثية والمعاصرة، مما يجعل الكتاب صالحًا للباحثين والقراء المثقفين على حد سواء.
• يتجنب التعقيد الاصطلاحي، ويحرص على أن تكون قراءاته ميسّرة دون أن تفقد عمقها.
رابعًا: أثر الكتاب في الحياة الفكرية والأدبية والثقافية
الأثر المجال
ترسيخ فكرة أن النقد فعل حضاري، لا مجرد تحليل تقني الفكر النقدي
تقديم نماذج تطبيقية راقية لتحليل الشعر الحديث الأدب العربي
إعادة الاعتبار لوظيفة الشعر في بناء الوعي الجمعي الثقافة العامة
تطوير المنهج النقدي العربي، وفتح الباب أمام دراسات تكاملية البحث العلمي
• أسهم الكتاب في إعادة صياغة العلاقة بين الأدب والنقد، وبين الفن والرسالة، مما يجعله مرجعًا في الدراسات النقدية ذات البعد الحضاري.
نحو نقد عربي أصيل
يُعد كتاب “شعراء وتجارب” للدكتور صابر عبد الدايم مساهمة نوعية في النقد الأدبي العربي، ليس فقط لأنه يقدم قراءات تطبيقية متميزة، بل لأنه يؤسس لرؤية نقدية تكاملية، تستوعب خصوصية النص العربي، وتربط بين الجمال والرسالة. إن المنهج التكاملي الذي يدعو إليه المؤلف هو دعوة إلى نقد عربي أصيل، منتمٍ إلى بيئته، منفتح على العالم، وقادر على أن يضيء وجدان الأمة ويشارك في بناء وعيها الحضاري.
5. كتاب: “مدائن الفجر”
يُعدّ ديوان “مدائن الفجر” للدكتور صابر عبد الدايم نموذجًا متفرّدًا في الشعر الإسلامي المعاصر، حيث تتداخل فيه الرؤية الروحية مع الهمّ القومي، وتتمازج فيه اللغة التراثية مع التطلعات الحداثية. هذه الدراسة تسعى إلى تحليل البنية الفنية للديوان، واستكشاف أبعاده الفكرية والثقافية، وتقييم أثره على الحياة الأدبية والفكرية في السياق العربي والإسلامي الحديث.
أولا: السياق التاريخي والفكري للديوان
• صدر الديوان عام 1994، في لحظة مفصلية من التاريخ العربي، تزامنت مع تداعيات حرب الخليج، مأساة البوسنة، وتراجع المشروع القومي.
• ينتمي الشاعر إلى تيار الأدب الإسلامي، الذي يسعى إلى استعادة الهوية الحضارية للأمة من خلال الفن.
• الديوان يتفاعل مع قضايا الأمة الكبرى: فلسطين، سراييفو، بغداد، المسجد الأقصى، ويقدّم رؤية شعرية توحيدية تتجاوز الجغرافيا نحو الوجدان.
ثانيا: البنية الفنية والخصائص الأسلوبية
1. اللغة الشعرية
• تتسم بالجزالة والثراء، وتوظف التراكيب القرآنية والبلاغة العربية الكلاسيكية.
• تتداخل فيها مستويات لغوية متعددة: من الخطاب الدعوي إلى الرمز الصوفي إلى التوصيف الواقعي.
2. الإيقاع والوزن
• يعتمد على البحور التقليدية (كالطويل والكامل)، مع تنويعات داخلية تخلق موسيقى شعرية متجددة.
• يبرز التكرار كأداة إيقاعية ودلالية، خاصة في القصائد ذات الطابع الدعوي أو الملحمي.
3. الصورة الشعرية
• تتراوح بين الواقعية والرمزية، وتستند إلى التراث الإسلامي والتاريخ السياسي.
• توظيف مكثف للرموز الدينية (الفجر، السفينة، الطوفان، ليلة القدر) كاستعارات للتحول والخلاص.
ثالثا: الرؤية الفكرية والموضوعية
1. الهوية الإسلامية
• الديوان يؤسس لهوية إيمانية مقاومة، تربط بين الإيمان والحرية، وتستدعي رموزًا من التاريخ الإسلامي.
• يقدّم الإسلام كمنظومة قيمية قادرة على مواجهة الاستلاب الحضاري والغزو الثقافي.
2. الهمّ القومي والإنساني
• يتناول قضايا الأمة من منظور وجداني، ويعيد الاعتبار للإنسان المسلم كفاعل تاريخي.
• يربط بين المقاومة في فلسطين وسراييفو والعراق، في رؤية توحيدية تتجاوز الانقسام السياسي.
3. البعد الوجودي
• يطرح أسئلة وجودية حول الذات، الزمن، والمصير، خاصة في قصائد مثل “أين الطريق إليك” و”الطائر الحبيب”.
• يستدعي الموت كحقيقة وجودية، لكنه يواجهه بالإيمان واليقين، مما يمنح النص بعدًا فلسفيًا.
رابعا: التناص والتوظيف الثقافي
1. التناص القرآني
• يوظف آيات قرآنية وتراكيب مأخوذة من النص المقدس، مما يمنح النص بعدًا روحانيًا ويعزز صدقيته الفكرية.
• مثال: “الله أكبر في الشدائد مدفعي” – توظيف شعاري يعيد إنتاج الخطاب الجهادي في سياق شعري.
2. التناص التاريخي
• يستدعي شخصيات مثل النبي محمد ﷺ، عمر بن الخطاب، صلاح الدين، ليؤسس لرؤية نضالية ذات جذور.
• يعيد إنتاج المعارك الإسلامية الكبرى كرموز للتحرر المعاصر.
3. التناص الأدبي
• يحاور التراث الشعري العربي، من المعلقات إلى شعر المقاومة، ويعيد إنتاجه في سياق إسلامي حديث.
• يبرز تأثير شعر أحمد شوقي، البردوني، ومحمود حسن إسماعيل في بعض التراكيب والصور.
خامسا: أثر الديوان على الحياة الفكرية والأدبية
1. فكريًا
• يقدّم نموذجًا لفكر إسلامي مقاوم، يربط بين الإيمان والتحرر، ويطرح أسئلة حول الهوية والعدالة.
• يعيد الاعتبار للخطاب الديني كأداة للتحليل السياسي والاجتماعي.
2. أدبيًا
• يُعدّ من أبرز نماذج الشعر الإسلامي المعاصر، ويؤسس لمدرسة شعرية تدمج بين العمق الروحي والهمّ السياسي.
• يساهم في تجديد الشعر العمودي من خلال توظيفه لقضايا العصر.
3. ثقافيًا
• يعيد الاعتبار للرموز الإسلامية في الخطاب الثقافي، ويحفّز على استعادة الذاكرة الجمعية للأمة.
• يقدّم نموذجًا للثقافة المقاومة، التي تدمج بين الفن والرسالة.
4. علميًا
• يصلح كنص مرجعي في الدراسات الأدبية والنقدية، خاصة في مجالات التناص، الشعر المقاوم، والشعر الديني.
• يمكن اعتماده في مناهج الأدب الإسلامي، أو في دراسات مقارنة بين الشعر العربي الحديث والشعر الديني.
يمثّل ديوان “مدائن الفجر” تجربة شعرية متكاملة، تتجاوز حدود الفن إلى آفاق الفكر والمقاومة. إنه نصّ يستعيد الذاكرة، ويؤسس للوعي، ويستنهض الأمة من سباتها. في زمن التحديات، يظل الشعر هو الأقدر على التعبير عن الحلم، والوجدان، واليقين. والدكتور صابر عبد الدايم، في هذا الديوان، لا يكتب الشعر فحسب، بل يكتب تاريخًا روحيًا للأمة، بلغة لا تخبو، وصوت لا ينكسر.
ومن شعره قصيدته “مدائن الفجر” التي يقول في مطلعها:
مُعلَّقٌ بينَ تاريخي وأحلامي
وواقعِي خَنجَرٌ في صَدرِ أيَّامي
أخطُو.. فيرتدُّ خَطْوي دُونَ غايتِه
وما بأُفْقي سِوى أنقاضِ أنغامِ
تناثَرَت في شِعابِ الحُلم أورِدَتي
وفي دِمائي نمَت أشجارُ أوهامي
مَدائنُ الفَجرِ لم تُفتَح لقافِلَتي
والخَيلُ واللَّيلُ والبَيداءُ قُدَّامي
والسَّيفُ والرُّمحُ في كَفَّيَّ من زمَنٍ
لكنَّني لم أُغادِر وَقْعَ أقدامي
تحليل أدبي نقدي لقصيدة “مدن الفجر”
بين الحلم والخذلان – مدخل إلى “مدائن الفجر”
في قصيدة “مدائن الفجر”، يفتح الشاعر الدكتور صابر عبد الدايم يونس نافذةً على الذات المتأرجحة بين التاريخ والحلم، بين الإرادة والخذلان، بين امتلاك أدوات البطولة وعجز الخطى عن تجاوز العتبة الأولى. إنها قصيدة تنتمي إلى شعر التجربة، حيث تتداخل الذات الفردية مع الهمّ الجمعي، ويصبح الحلم مرآةً للواقع، والأنقاض بقايا أنغامٍ كانت يومًا وعدًا بالخلاص.
تأتي هذه القصيدة ضمن مشروع شعري أوسع للشاعر، يتسم بالعمق الفلسفي والرمزية التاريخية، ويستدعي تراثًا لغويًا وجماليًا راسخًا، دون أن يغفل عن وجع اللحظة المعاصرة. في هذا السياق، يقدم الدكتور صابر عبد الدايم نصًا يتجاوز البنية التقليدية للقصيدة العمودية، ليغدو تأملًا وجوديًا في معنى التقدم، والانكسار، والانتظار.
التحليل النقدي: تفكيك البنية الشعرية والدلالات الرمزية
1. بنية التوتر بين الأزمنة
البيت الأول يضعنا مباشرة أمام مفارقة وجودية:
مُعلَّقٌ بينَ تاريخي وأحلامي وواقعِي خَنجَرٌ في صَدرِ أيَّامي
هنا، تتجسد الذات في حالة “تعليق” بين الماضي (التاريخ) والمستقبل (الأحلام)، بينما الحاضر يتحول إلى خنجر، أي إلى أداة ألم واغتيال للزمن الشخصي. هذه الصورة تفتح الباب أمام قراءة فلسفية للزمن في القصيدة: الماضي إرث، المستقبل أمل، والحاضر مأساة.
2. جدلية الحركة والجمود
أخطُو.. فيرتدُّ خَطْوي دُونَ غايتِه وما بأُفْقي سِوى أنقاضِ أنغامِ
الخطو هنا فعل إرادة، لكنه يرتد، أي يُحبَط. الأفق لا يحمل وعدًا، بل أنقاضًا، ما يشير إلى انهيار الحلم الجمالي (الأنغام) وتحوله إلى أطلال. هذه الجدلية بين الحركة والجمود، بين الإرادة والخذلان، تتكرر في القصيدة وتُشكّل محورها البنيوي.
3. تشظي الذات وتكاثر الأوهام
تناثَرَت في شِعابِ الحُلم أورِدَتي وفي دِمائي نمَت أشجارُ أوهامي
الذات هنا تتشظى في الحلم، وتتحول الأوردة – رمز الحياة – إلى مسارات ضائعة في الشعاب. أما الدم، فيغدو تربةً لنمو الأوهام، لا للحقائق أو الإنجازات. هذه الصورة تعكس انقلابًا في الوظيفة الحيوية للذات، حيث يصبح الداخل مصدرًا للوهم لا للوعي.
4. رمزية البطولة المجهضة
مَدائنُ الفَجرِ لم تُفتَح لقافِلَتي والخَيلُ واللَّيلُ والبَيداءُ قُدَّامي والسَّيفُ والرُّمحُ في كَفَّيَّ من زمَنٍ لكنَّني لم أُغادِر وَقْعَ أقدامي
هنا تبلغ القصيدة ذروتها الرمزية. “مدائن الفجر” ترمز إلى الخلاص، إلى النصر، إلى الأمل المتحقق. لكنها مغلقة. رغم امتلاك أدوات البطولة (الخيل، الليل، البيداء، السيف، الرمح)، تبقى الذات عاجزة عن تجاوز اللحظة. إنها بطولة معلّقة، زمنٌ من المجد لا يُترجم إلى فعل.
البيت الأخير يختزل المأساة: كل شيء متاح، لكن الذات لم تغادر وقع أقدامها، أي لم تتجاوز حدودها، لم تتحرر من سكونها.
بين الحلم المغلق والبطولة المؤجلة
قصيدة “مدائن الفجر” ليست مجرد تأمل شعري في الانكسار، بل هي مرآة لواقعٍ عربيٍّ مثقلٍ بالأحلام المؤجلة، والبطولات المجهضة، والذوات المعلقة بين إرثٍ ثقيل وأفقٍ غائم. في هذا النص، ينجح الدكتور صابر عبد الدايم في تحويل التجربة الفردية إلى رمز جمعي، وفي استدعاء التراث دون أن يغرق فيه، بل يوظفه ليضيء مأساة الحاضر.
إنها قصيدة تُقرأ كصرخة، وكحلم، وكوقفة تأمل أمام أبواب الفجر المغلقة، حيث لا يكفي امتلاك السيف والرمح، بل يجب أن تُغادر الذات وقع أقدامها، لتصنع خطوتها الأولى نحو الضوء.
خاتمة الفصل الخامس:
ختامًا، يمكن القول إن الأعمال الخمسة التي تناولها هذا الفصل تمثل إضافة نوعية ومهمة في حقل الأدب والنقد الإسلامي المعاصر. فقد نجح الدكتور صابر عبد الدايم يونس من خلالها في تقديم رؤية نقدية متكاملة، تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، وتزاوج بين التراث والحداثة، وتؤكد على دور الأدب في بناء الإنسان والمجتمع.
كما أظهرت الدراسات النقدية لهذه الأعمال قدرتها على إثارة أسئلة جوهرية حول الهوية والمنهج والوظيفة، وإعادة تعريف العلاقة بين الجمال والقيمة، بين الفن والرسالة، بين الذات والآخر.
لا شك أن هذه الأعمال ستظل مراجع أساسية للباحثين والدارسين، ومصدر إلهام للأدباء والنقاد، وعلامة مضيئة في مسيرة الأدب الإسلامي والنقد العربي الأصيل. وهي تدعو، في نهاية المطاف، إلى استئناف المشروع النقدي والحضاري الذي يليق بأمة تحمل رسالةً وتاريخًا وتتطلع إلى مستقبلٍ مشرقٍ يُعيد لها مكانتها بين الأمم.
الخاتمة: تقييم الأثر والإرث الفكري
يمثل الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس نموذجًا نادرًا يجمع بين العمق الأكاديمي والأصالة الإبداعية والالتزام الفكري. يمكن تقييم أثره من خلال عدة مستويات:
• على المستوى الأكاديمي: كان أستاذًا ملهِمًا ومشرفًا دقيقًا، أسهم من خلال عشرات الرسائل التي أشرف عليها في تكوين جيل من الباحثين يحملون رؤيته المنهجية في الربط بين الأدب والقيم.
• على المستوى النقدي: كان أحد أبرز داعمي ومؤسسي تيار “النقد الأدبي الإسلامي”، الذي قدم بديلاً منهجيًا في الساحة النقدية العربية، متحديًا سيطرة المناهج الوافدة، وساعيًا إلى تأصيل نقدي مستمد من الهوية الحضارية الإسلامية.
• على المستوى الثقافي والسياسي: من خلال مشاركاته الإعلامية وعضوياته، كان صوتًا moderating voice (صوتًا معتدلاً) يجمع بين الانفتاح على العصر والتمسك بالثوابت، مساهمًا في الخطاب الثقافي العام من موقع إسلامي مستنير. لقد كان حضوره، عبر صالونه الأدبي ونشاطه، بمثابة قوة للتواصل المجتمعي وبناء consensus (إجماع) ثقافي.
• على المستوى الإبداعي: أثريت المكتبة العربية بدواوينه الشعرية التي قدمت نموذجًا للشعر الهادف الملتزم بجماليات الفن وليس فقط بخطاب المضمون.
خلاصة القول، إن الراحل كان جسرًا بين عوالم متعددة: بين الأصالة والمعاصرة، بين النقد والإبداع، بين المحلية والعالمية الإسلامية، بين الأكاديميا والفضاء العام. لقد غادرنا جسديًا، لكن إرثه من الكتب والأبحاث والطلاب ومدرسته النقدية والشعرية يضمن له الخلود كواحد من أعلام الفكر والأدب في تاريخنا المعاصر.
قصيدة إهداء
إلى روح الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس
بقلم الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي.
يا صـاحبَ الـقـلمِ الـمضيءِ ورائدَ الإلهامْ
يا مَن نسجتَ على الحروفِ حضارةَ الأقلامْ
مضيتَ، لكنَّ في البقايا منك أنفاسًا تُضيء
وتَسكُنُ الأرواحَ، تعطرها بوهجِكَ والسَّلامْ
كنتَ الجسورَ إلى المعاني، كنتَ صوتَ الحقِّ حين
يُخطَفُ في زمنِ التباسٍ نُورُ فكرٍ أو كِلامْ
علَّمتنا أنَّ الأدبَ الإسلامَ في صُوَرِ الجَمالْ
وأنَّ في حروفِنا معنى الرسالةِ والقيامْ
نمْ في ثرى مصرَ الحبيبة، فالهُدى لكَ والدعاءْ
وبكوسوفا صوتُ حبٍّ لا يزولُ ولا ينامْ
إذ كنتَ تهوى شعبَها، تهدي قضاياهُ البهاءْ
واليومَ نُهديكَ الدعاءَ ونظمَ شِعرٍ بانسجامْ
تحليل أدبي نقدي للقصيدة
تأتي هذه القصيدة في مقام الوفاء والتأبين، وقد اختار الشاعر (أ. د. بكر إسماعيل الكوسوفي) أن يبنيها على محورين دلاليين: الذاكرة الأدبية والبعد الإنساني.
1. البنية العاطفية: تنفتح القصيدة بمخاطبة مباشرة “يا صاحب القلم المضيء”، وهو أسلوب نداء يُبرز الحميمية والوفاء، ويحوّل النص إلى حوار روحي مع الغائب.
2. الرموز الأدبية: يرد القلم، الحروف، الحضارة، الجمال، الرسالة؛ وكلها رموز مركزية تعكس منهج الفقيد في الأدب الإسلامي الذي جمع بين الفن والرسالة.
3. البعد الجمالي: النص يعتمد على موسيقى هادئة وإيقاع متوازن (مقاطع شبه عمودية)، بما يوازي روح التأبين، دون انزلاق إلى المباشرة الخطابية، بل بحسّ شعري يمزج الرثاء بالتقدير.
4. البعد الإنساني والحضاري: يربط الشاعر بين مكانة الفقيد في مصر وعمق حبه لقضية كوسوفا، مما يضفي على القصيدة بُعدًا إنسانيًا عالميًا، ويربط الخاص بالعام.
5. الرؤية النقدية: يمكن القول إن القصيدة تمثل نصًّا تذكاريًا – حضاريًا، يترجم تجربة مشتركة بين شاعرين وناقدين جمعتهما رسالة الأدب الإسلامي. وهي تُظهر قدرة اللغة الشعرية على الجمع بين الرثاء والاحتفاء، بين الذاكرة الفردية والإرث الجماعي.
قائمة المراجع (مختارة)
• يونس، صابر عبد الدايم. (1990). الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق. دار الأرقم، الزقازيق.
• يونس، صابر عبد الدايم. (1992). موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور. مكتبة الخانجي، القاهرة.
• حبيب، صادق. (1992). أبعاد التجربة الشعرية في شعر صابر عبد الدايم. دار الأرقم، الزقازيق.
• عدس، صلاح. (تاريخ غير محدد). منظومة الأدب الإسلامي في شعر صابر عبد الدايم.
• محمد، حسين علي. (1992). العصف والريحان: حوارات ومواجهات (يشمل حوارات مع د. يونس).
• ملفات “مجلة الأدب الإسلامي” و”المجلة العلمية لكلية اللغة العربية بالزقازيق”.
• معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.
الكلمات المفتاحية: صابر عبد الدايم، الأدب الإسلامي، النقد الأدبي، الشعر المعاصر، الأزهر الشريف، الرابطة الإسلامية.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
[email protected]