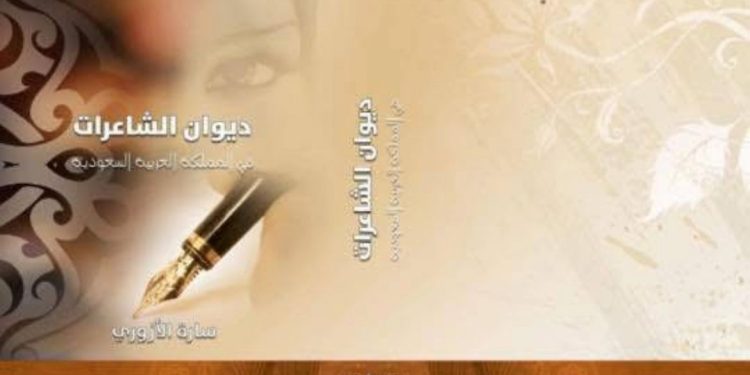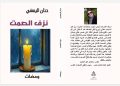سارة الأزوري لأزهار الحرف
إبداع متجدّد، ذاكرة موثَّقة، قضايا إنسانية، والحرية جوهر الأدب______
بين القصة والتوثيق والبحث الأكاديمي والصحافة، تشكّلت تجربة الدكتورة سارة بنت مرزوق الأزوري كصوت متعدد الأبعاد. منذ بداياتها في الصحافة الثقافية وحتى إصدارها لمجموعاتها القصصية، ومن عملها التوثيقي الرائد في معجم الشاعرات السعوديات إلى أطروحتها الأكاديمية حول النصوص السردية والمناهج التعليمية، ظلت الكلمة عندها أفقًا للتعبير وبناء الذاكرة.
هي تجربة تتحرك بين الأدب بوصفه إبداعًا، والتوثيق بوصفه حفظًا للهوية، والبحث الأكاديمي بوصفه أداة للفهم والتحليل.
وللاقتراب أكثر من هذه التجربة الغنية والمتشعبة، كان لـ مجلة أزهار الحرف شرف الحوار معها، حيث نتوقف عند بداياتها الأدبية، ونتاجها البحثي، ورؤيتها لمستقبل الأدب السعودي في ظل التحولات الراهنة.
إن تجربة الدكتورة سارة الأزوري تؤكد أن الكتابة ليست مسارًا واحدًا، بل شبكة من الأصوات والرؤى؛ فهي الأديبة التي آمنت بقدرة القصة القصيرة على اختزال الإنسان، والباحثة التي فتحت أفقًا جديدًا لقراءة النصوص في بيئتنا التعليمية، والصحفية التي مارست التوثيق من قلب الميدان.
ومن خلال هذه الأدوار المتعددة، تمضي بخطى واثقة، مؤمنة أن الأدب السعودي قادر على أن يكون مرآة للذات، وجسرًا إلى الآخر، وأداة لتعزيز الحضور الثقافي للمملكة في المشهد العربي والعالمي.
حاورتها لمجلة أزهار الحرف من السعودية/ نازك الخنيزي
أولًا: حول التجربة الشخصية والكتب.
١-بدأتِ مسيرتك مع القصة القصيرة منذ التسعينيات، ثم خضتِ غمار التوثيق والمعاجم. كيف ترين خيط التواصل بين هذه المسارات المختلفة؟
بدأتُ مع القصة القصيرة لأنها الأقرب إلى صوتي الداخلي، فهي شكل فني يتيح لي تكثيف التجربة الإنسانية في لحظة سردية تحمل كثافة وجدانية وفكرية، وتكشف التفاصيل الصغيرة التي تختزن قضايا كبرى. كنت أكتبها كأنني أحاول أن أوقف الزمن عند مشهد واحد لا يضيع في غبار الأيام. هذا الهاجس نفسه هو الذي قادني لاحقًا إلى التوثيق فأنجزتُ معجم الشاعرات السعوديات بوصفه محاولة لحماية الذاكرة الثقافية النسائية من التلاشي.شعرت أن غياب الأرشفة يهدد هذا الإرث بالاندثار، وأن مسؤولية الكاتب لا تقتصر على الإبداع وحده، بل تمتد إلى حفظ الإرث ومنحه شرعية البقاء. لذلك أرى أن القصة، والمعجم، والدراسة الأكاديمية ليست مسارات متنافرة، بل خطوط متوازية يجمعها خيط واحد: اليقين بأن الكتابة فعل بناء للذاكرة الإنسانية، وحماية لها من الفناء، سواء جاءت بصيغة سرد قصصي أو توثيق تاريخي أو بحث علمي.
2. في مجموعتيك القصصيتين طقس خاص ونصف رجل، أي صورة للمرأة والإنسان أردتِ أن تتركيها في ذهن القارئ؟
في طقس خاص ونصف رجل سعيت إلى تقديم صورة مركّبة للمرأة والإنسان في مواجهة وجودية صريحة. النصوص تناولت الحرية والاعتراف بالآدمية، وبأسئلة الكرامة والاختيار، وواجهت الواقع المأزوم بالسخرية أحيانًا وبالرمز والنهايات المفتوحة أحيانًا أخرى. لم أرسم المرأة كضحية مستسلمة ولا كبطلة مكتملة، بل ككائن حيّ يختبر لحظات ضعف وقوة، خوف ورغبة، حلم ومقاومة. ما أردت أن يبقى في ذهن القارئ هو صورة إنسان يبحث عن كينونته رغم القيود، يجابه وجوده بكرامة، ويحوّل الألم إلى وعي يعكس هشاشة العالم من حوله.
3. أنجزتِ معجم الشاعرات السعوديات، وهو عمل غير مسبوق. ما الذي دفعك لخوض هذا المشروع؟ وما التحديات التي واجهتك أثناء التوثيق؟
كان دافعي إلى إنجاز معجم الشاعرات السعوديات شعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه أصوات نسائية ظلّت متفرقة وهامشية في الذاكرة النقدية والتاريخ الأدبي. كنت أقرأ أسماء لشاعرات ظهرن ثم اختفين دون أن يبقى لهن أثر في المكتبة السعودية، وأدركت أن غياب التوثيق يعني موتًا مضاعفًا: موت النص وموت الاسم. لذلك رغبت أن أمنحهن موقعًا موثقًا لا يمكن تجاوزه، وأن أجمع هذا الإرث الشعري في عمل يضمن بقاءه. التحديات كانت كبيرة: شحّ المصادر، تباين المعلومات والحقائق، صعوبة الوصول إلى النصوص الأولى أو التواصل مع بعض الشاعرات، وغياب أرشفة دقيقة أو وعي كافٍ بأهمية الحفظ. ومع ذلك، كان الإصرار على جمع هذه الذاكرة قوة تدفعني إلى الاستمرار، وإيمانًا بأن كل اسم أو ديوان يُوثَّق هو خطوة في حفظ الهوية الشعرية النسائية ومنحها شرعية البقاء.
4. كيف انعكست تجربتك الصحفية في صحيفة الجزيرة على أسلوبك الأدبي، وما الذي تعلمته من تلك المرحلة؟
كانت الصحافة، ولا سيما تجربتي في صحيفة الجزيرة، مدرسة منحتني الدقة والقدرة على الملاحظة، وعلّمتني الإيجاز في التعبير من دون أن أفقد العمق. هناك تعلمت أن أكتب بسرعة، وأن ألتقط الجوهر من بين ازدحام الأحداث، وأن أنصت لصوت الشارع الثقافي وهموم الناس. هذا منحني يقظة أكبر للتفاصيل الصغيرة وقربًا من نبض الحياة اليومية، وهو ما انعكس لاحقًا على قصصي ونصوصي النقدية، حيث صارت لغتي تجمع بين الإيجاز الصحفي والرهافة الأدبية، وتربط الأدب بالحراك الاجتماعي والثقافي من حولي.
5. بحكم تخصصك الأكاديمي، إلى أي مدى أثّر البحث العلمي في صياغتك للأدب، وهل منحك أدوات إضافية لفهم النصوص؟
البحث الأكاديمي كان مدرسة عقلية أمدّني بأدوات التحليل والتفكيك، وعلّمني أن النص ليس كيانًا بريئًا، بل بنية تحمل دلالات وسياقات اجتماعية وثقافية. هذا الوعي جعل قراءتي للنصوص تتجاوز الحدس الأدبي إلى منهجية ناقدة قادرة على تفكيك البنى والكشف عن طبقات المعنى. ومع ذلك لم يقيد البحث حريتي الإبداعية، بل عززها، لأن النقد يضيء مناطق كانت غامضة ويفتح أمامي مساحات أرحب للتعبير. لذلك أكتب اليوم بعين القاصة وحسّ الباحثة معًا، فأرى في الأدب مادة للبحث، وفي البحث وسيلة لتوسيع أفق الأدب، وهو تداخل منحني توازنًا بين الإبداع والتفكير النقدي، وأغنى تجربتي بعمق إنساني ومعرفي مضاعف.
ثانيًا: حول البحث والمناهج
6. في أطروحتك للدكتوراه، درستِ علاقة الأنماط الإدراكية بالنصوص السردية. ماذا كشفت النتائج عن علاقة الطالب بالنصوص السردية في بيئتنا التعليمية؟
أظهرت نتائج أطروحتي أن الطالب ما زال يتعامل مع النصوص السردية تعاملاً تقليديًا قائمًا على الحفظ أكثر من التفاعل، فيراها مادة مدرسية لا خبرة جمالية. هذا جعله يقرأ بسطحية، بعيدًا عن لذّة القراءة ومجال التأمل، فغابت عنه شراكة التأويل والقدرة على النفاذ إلى عمق النص. المشكلة لا تكمن في الطالب وحده، بل في طريقة تقديم النصوص داخل المناهج، حيث تُطرح غالبًا كوسيلة لتدريب لغوي أو لاستخراج معانٍ سطحية، لا كتجربة وجدانية وفكرية. الدراسة أوضحت أن تفعيل الأنماط الإدراكية بشكل صحيح يمكن أن يحوّل النصوص السردية إلى مدخل لتنمية التفكير النقدي والخيال معًا، بدل أن تظل مجرد أسئلة اختبار تفقد النص روحه وتقطع صلته بالحياة.
7. كيف تقيمين واقع المناهج اليوم من حيث صلتها بالأدب والهوية الثقافية؟
المناهج ما زالت بحاجة إلى إعادة صياغة جذرية تجعل الأدب في قلبها لا على هامشها، فالهوية الثقافية لا تُبنى إلا بالنصوص التي تشبه المجتمع وتعكس روحه. ورغم وجود جهود تطويرية، فإنها غالبًا تظل رهينة نماذج جامدة لا تمنح الأدب مكانته الحقيقية. ما تحقق حتى الآن يظل محدودًا وخجولًا، إذ تُقدَّم الهوية عبر دروس متفرقة، بينما المطلوب رؤية متكاملة تجعل النص الأدبي حاضرًا في وعي الطالب كصوت يعبّر عن مجتمعه ويرتبط بحياته اليومية، فيدرك أن الأدب ليس ميراثًا ماضيًا فقط، بل مرآة لواقعه ووسيلة لتشكيل وعيه.
8. مع التحولات الرقمية، هل ما زالت المناهج أسيرة التلقين أم بدأت تنفتح على أشكال جديدة من القراءة (البصرية، السمعية، الرقمية)؟
التحولات الرقمية فرضت حضورها بقوة، لكن المناهج ما زالت بطيئة في مواكبتها. صحيح أن هناك محاولات لدمج الوسائط البصرية والسمعية والرقمية، غير أنها غالبًا تبقى محدودة أو شكلية لا تتجاوز كونها إضافة خارجية. الطالب اليوم يتلقى عشرات الرسائل عبر الشاشة والصوت يوميًا، بينما تظل النصوص المدرسية جامدة وورقية. المطلوب أن تتحول هذه الوسائط إلى أدوات حقيقية للتعلّم، وأن يُنظر إلى القراءة باعتبارها حدثًا متعدد الأبعاد يمكن أن يتم عبر المقطع المسموع أو الفيلم القصير بالعمق نفسه الذي يقدَّم فيه النص الورقي، حتى يبقى الأدب متصلاً بجيل يعيش بعينه على الشاشة وأذنه على الصوت.
ثالثًا: حول الأدب السعودي والقصة القصيرة
9. رغم هيمنة الرواية، ما زلتِ متمسكة بالقصة القصيرة. ما سر هذا التعلق؟
القصة القصيرة هي عالمي الأول ولغتي الأقرب، فهي تتيح لي التقاط اللحظة الإنسانية الخاطفة بكل ثقلها الوجداني، والقدرة على قول الكثير بالقليل. أجد فيها متعة الإمساك بما يتسرب بين التفاصيل الصغيرة وما يغيّر مصير الإنسان في لحظة واحدة، ولهذا ظللت وفيّة لها رغم هيمنة الرواية وصعودها. الرواية تمنح فضاءً واسعًا، لكن القصة القصيرة تمنحني حرية التكثيف وكثافة التجربة، وتشبه في جوهرها ومضة برق تضيء المشهد للحظة وتترك أثرها العميق.
10. كيف تقرئين مكانة القصة القصيرة اليوم في المشهد السعودي والعربي؟
مكانة القصة القصيرة تراجعت أمام سطوة الرواية في سوق النشر والجوائز، لكنها لم تغب ولم تنقرض. ما زالت حاضرة في المجلات والملتقيات الأدبية، وتشهد اليوم تجارب مبتكرة تعيد إليها بريقها، خاصة عبر الجيل الجديد الذي يوظف أشكالًا وصيغًا مختلفة تناسب روح العصر. ومع أن الرواية طاغية تجاريًا، فإن القصة القصيرة تظل أكثر أجناس السرد ملاءمة لعصر السرعة والتحولات، بل إن وسائل التواصل الاجتماعي منحتها حياة جديدة، لأن القارئ المعاصر يميل إلى النص المكثف.
عربيًا، ما تزال هناك أسماء وتجارب بارزة تثبت أن القصة القصيرة جنس أدبي حيّ ومؤثر، أسّس لمدارس كبرى ويواصل التجدد عبر الأجيال.
11. كيف انعكست قضايا المرأة السعودية على نصوصك الأدبية؟ وهل كان ذلك خيارًا واعيًا أم انعكاسًا طبيعيًا لتجربتك؟
انعكست قضايا المرأة في نصوصي انعكاسًا طبيعيًا لتجربتي كامرأة سعودية، فهي جزء من حياتي وذاتي لا يمكن أن أنفصل عنه. لم يكن حضور هذه القضايا في كتابتي قرارًا واعيًا في البداية، بل تسربًا من الواقع الذي أعيشه وأراه من حولي، ثم صار لاحقًا خيارًا أكثر وعيًا. لم أكتب لأرفع شعارًا أو لأقدّم خطابًا نسويًا مباشرًا، بل لأحكي حياةً عشتها ورأيتها، فجاء صوت المرأة في نصوصي إنسانًا من لحم ودم، لا رمزًا سياسيًا ولا أداة دعائية، وإنما كائن حيّ يبحث عن كينونته ويجابه واقعه بكرامة.
رابعًا: حول المشهد الأدبي والنقدي
12. كيف ترين النقد الأدبي في المملكة؟ وهل يواكب حجم الإبداع والنشر؟
النقد الأدبي في المملكة موجود ويتطور، لكنه لا يزال أقل من حجم الإبداع المتدفق، ويبدو الإيقاع الإبداعي أسرع بكثير من الاستجابة النقدية. النصوص بحاجة إلى قراءات معمقة تكشف بنياتها وسياقاتها الثقافية، لكن هذا العمق ينبغي أن يُقدَّم بلغة واضحة ومبسطة تصل إلى القارئ العام. هناك جهود فردية وأكاديمية أثرت المشهد، لكنها تبقى متفرقة. ما نحتاجه اليوم هو مؤسسات نقدية أكثر حيوية ومناهج قادرة على ملاحقة الحراك الإبداعي، بحيث يجمع النقد بين الجدية العلمية والقدرة على إيصال الأفكار بيسر ووضوح.
13. كيف تقيّمين إنتاج الجيل الجديد من الكتّاب السعوديين مقارنة بجيلكم؟
الجيل الجديد يكتب بجرأة أكبر، ويخوض التجريب بحرية لافتة، فيقترب من موضوعات كانت تُعدّ من التابوهات، ويجرب أشكالًا سردية جديدة بلسان معاصر. هذا يميّزه عن جيلنا الذي كان أكثر تحفظًا والتزامًا بالمعايير الكلاسيكية، وغالبًا ما كتب تحت قيود اجتماعية. غير أن هذه الجرأة ترافقها أحيانًا قلة صبر أو ضعف في الجذور اللغوية والمعرفية، مما يجعل الغزارة تأتي على حساب الجودة. لكل جيل خصوصيته، لكن الأهم هو أن تتحول هذه الحرية إلى نضج أعمق، وأن يتجاوز الكتاب منطق الموضة الأدبية إلى كتابة أكثر رسوخًا. وفي النهاية، كلا الجيلين يكمل الآخر، وهذا التعدد يغني المشهد الأدبي ويجعله أكثر ثراءً وتنوعًا.
14. برأيك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الأدب السعودي في تعزيز القوة الناعمة للمملكة؟
الأدب هو أداة القوة الناعمة الأصدق، لأنه حين يُكتب بوعي وجمال يعكس صورة المملكة كفضاء ثقافي حيّ، ويقدّم للعالم الإنسان السعودي كما هو: متنوع، حالم، منفتح على الحياة. ما يميّز الأدب السعودي أنه يجمع بين الأصالة والتحديث، ويحمل في نصوصه رسائل غير مباشرة عن ثقافتنا وقيمنا وتحولاتنا. وحين يُترجم ويُقدَّم بشكل جيد، يصبح سفيرًا ثقافيًا فاعلًا وجسرًا يصل المملكة بالآخرين على مستوى وجداني وثقافي، فيمنح العالم صورة إنسانية حقيقية عن مجتمع يتغير بسرعة، وهو ما لا تستطيع السياسة وحدها أن تفعله.
15. كيف يُستقبل الأدب السعودي في الخارج من خلال مشاركاتك في الملتقيات العربية؟
في الملتقيات العربية يُستقبل الأدب السعودي بفضول وتقدير لافت، إذ يُنظر إليه كنص جديد يتشكّل بملامح خاصة ويعكس فضاءً مختلفًا. هناك اهتمام كبير بما يكتبه السعوديون، وبخاصة الكاتبات، لأن أصواتهن تمثل بعدًا جديدًا في المشهد العربي. هذا الاستقبال الإيجابي يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لتقديم نصوص تليق بحجم التوقعات، وتؤكد أن الأدب السعودي قادر على أن يكون حاضرًا ومؤثرًا في الساحة العربية.
خامسًا: حول التحديات والرؤية المستقبلية
16. ما أبرز التحديات التي واجهتك كامرأة في بداياتك الأدبية والصحفية؟
أبرز التحديات في بداياتي كانت النظرة الاجتماعية والصورة النمطية عن المرأة الكاتبة، إذ ساد اعتقاد أن ظهورها في الإعلام والثقافة خروج عن المألوف. واجهت نظرات تشكك في قدرتي وصوتًا ذكوريًا يهيمن على المشهد، حتى بدا وكأني أكتب في فضاء لا يعترف بي كامرأة كاتبة. لكنني تجاوزت ذلك بالصبر والإصرار على أن يكون النص هو سلاحي، ومع الدعم الذي وجدته من والدي ثم زوجي رحمها الله وبعض الرموز من حولي، تحوّل هذا التحدي إلى دافع للاستمرار وإثبات أن قيمة الكاتب لا يحددها سوى نصه.
17. كيف استطعتِ التوازن بين أدوارك: باحثة، أديبة، وصحفية؟
التوازن بين الأدوار لم يكن سهلًا في البداية، فقد شعرت أحيانًا أنني ممزقة بينها، لكنني أدركت لاحقًا أنها ليست متناقضة بل متكاملة. الصحافة منحتني يقظة الميدان وصوت الحياة اليومية، البحث العلمي زودني بأدوات التحليل والعمق، والأدب وهبني الحرية والقدرة على التعبير. هكذا صارت هذه الأدوار دوائر تتقاطع في هوية واحدة، أكتب كباحثة بقلم الأديبة، وأمارس الصحافة بعين الناقدة، فأجد في التناغم بينها مصدر قوة لا تعارض.
18. أي محطة من مسيرتك تفخرين بها أكثر؟ وما الذي تطمحين لإنجازه مستقبلًا؟
أفخر بإنجاز معجم الشاعرات السعوديات، لأنه مشروع تأسيسي يحفظ للأدب ذاكرة نسائية كانت مهددة بالتشتت. كما أعتز بمجموعتي القصصية الأولى التي منحتني يقين البدايات وأكدت لي أن الطريق ممكن. أما اليوم فأعمل على مشروع سردي ممتد يستند إلى السيرة الغيرية وذاكرة القرية وتجربة جيل بأكمله مع الأرض والحياة. طموحي أن يبلغ هذا العمل مستوى يضعه في فضاء المنافسة الأدبية الرفيعة، حيث يُقرأ بوصفه نصًا يضيف لا مجرد نص يُضاف.
19. هل لديك مشاريع أدبية أو بحثية جديدة في الطريق؟
نعم، أعمل حاليًا على مشروع سردي طويل يمزج بين السيرة والتخييل، أحاول من خلاله كتابة الذاكرة الشخصية والجماعية في آنٍ واحد. إلى جانب ذلك أنجز أبحاثًا نقدية حول السرد السعودي الجديد، وأتتبع تحولات القصة القصيرة خلال العقدين الأخيرين. كما أنني أعمل على طباعة رسالتي الماجستير والدكتوراه وإخراجهما في صيغة كتب، ليكونا امتدادًا معرفيًا يضيف إلى المكتبة النقدية. هذه المشاريع ليست متوازية فحسب، بل متقاطعة تصب جميعها في إعادة قراءة التجربة الأدبية من زوايا متعددة.
سادسًا: أسئلة ختامية ورؤية عامة
20. مع انتشار المنصات الرقمية، كيف ترين مستقبل القصة القصيرة والشعر في الفضاء الإلكتروني؟
الفضاء الرقمي منح القصة القصيرة والشعر حياة جديدة من حيث الانتشار وسرعة الوصول، وفتح أمامهما أشكالاً تفاعلية مبتكرة كالنص المسموع أو المصوَّر. لكنه في الوقت نفسه يهددهما بالتسطيح والاستهلاك السريع. التحدي الحقيقي هو أن نخلق نصوصًا تستثمر المنصات الرقمية لتوسيع دائرة القارئ، من دون أن تفقد عمقها أو صدقها. المستقبل سيكون لمن يوازن بين لحظة التلقي السريعة في الفضاء الإلكتروني، وبين الأثر العميق الذي يظل في ذاكرة القارئ.
21. لو أردتِ أن تختصري رسالتك الثقافية في جملة واحدة للأجيال الجديدة، ماذا ستقولين؟
رسالتي: اكتبوا كأنكم تمنحون ذاكرتكم حياة ثانية، فالكتابة ليست ترفًا بل عهد مع الذات والأجيال القادمة. اكتبوا لتكونوا أحرارًا، لا لتنالوا إعجابًا، فجوهر الأدب هو الحرية.
22. وأخيرًا، كيف تقيمين الملتقيات الأدبية عبر الواقع الافتراضي؟ وما رأيك بملتقى الشعراء العرب الذي أسسه الشاعر المصري ناصر رمضان عبد الحميد؟
الملتقيات الأدبية الافتراضية كسرت الحواجز الجغرافية وفتحت فضاءات واسعة للتواصل والحوار، خاصة بعد الجائحة. هي لا تعوض سحر اللقاء المباشر، لكنها وسّعت دائرة المشاركة، وسمحت للأصوات الجديدة أن تُسمع. ملتقى الشعراء العرب نموذج واضح على ذلك، إذ جمع أصواتًا متعددة في فضاء مشترك، وأثبت أن الأدب قادر على تجاوز الحدود السياسية والجغرافية ليبقى فضاءً جامعًا يفتح آفاقًا للتفاعل والتبادل الثقافي.