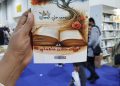بين القيمة والمعيار: جدل المعنى والذائقة في النقد الأدبي من أرسطو إلى الحداثة:
بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.
ليست “القيمة” في النقد الأدبي مجرّد حُكمٍ يُطلقه الناقد، ولا “المعيار” مجرد أداةٍ لقياس الجودة أو الرداءة، بل هما معاً تمظهران لصراعٍ أعمق في الفكر الإنساني بين الثابت والمتحوّل، بين المطلق والجمالي، بين ما يُقاس بالعقل وما يُدرك بالذائقة. منذ أن كتب أرسطو فن الشعر ليضع أولى لبنات القيمة الفنية في البناء والوظيفة والتطهير، ومنذ أن ردّ عليه أفلاطون بنزع القيمة الأخلاقية من الشعر واعتباره محاكاة لظلّ الظلّ، بدأ النقد الأدبي رحلته الطويلة في البحث عن معيارٍ قادرٍ على التوفيق بين الجمال والحقيقة، بين الشكل والمضمون، بين ما يُبدعه الخيال وما يُقرّه المنطق.
في التراث العربي، كان النقاد الأوائل كابن قتيبة والجرجاني والآمدي يدركون أن القيمة لا تُستنبط من خارج النص بل تُستشف من داخله، من نظامه اللغوي والدلالي، ومن انسجام الإيقاع مع الفكرة. فقد رأى عبد القاهر الجرجاني أن سر الإعجاز يكمن في “النظم”، أي في العلاقة بين الكلمة وسياقها، وهو بذلك سبق البنيويين في النظر إلى الأدب كمنظومة داخلية متماسكة. بينما ذهب الآمدي إلى أن المعيار الأدبي لا يُقاس بالمحاكاة أو الزخرف اللغوي، بل بالصدق الفني الذي يجعل النصّ كائناً حيّاً في وجدان القارئ.
غير أن القرن العشرين، ولا سيما في مرحلته البنيوية وما بعدها، شهد انقلاباً جذرياً في مفهوم القيمة والمعيار. إذ لم يعد السؤال: ما النصّ الجيد؟ بل من الذي يحدد جودة النص؟ فتحوّل المعيار من سلطة الناقد إلى لعبة التأويل، ومن يقين الجمال إلى احتمالية المعنى. وهنا تستعيد نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وجماليات التأويل المفتوح عند أمبرتو إيكو أهميتها، حيث تصبح القيمة حدثاً زمنياً يتولّد في لحظة القراءة، لا في بنية النص الثابتة.
أما في الفكر العربي الحديث، فقد اشتدّ الصراع بين دعاة “المعيار الموضوعي” الذين أرادوا للنقد أن يكون علماً تحكمه القوانين، وبين دعاة “القيمة الإنسانية” الذين رأوا أن النصّ لا يُختزل في تقنيات بل في نبضه الوجودي. وقد عبّر أدونيس عن هذا الجدل بقوله: «ليس النصّ ما يقوله، بل ما يُفكّر فيه عبره». وهنا تتجلّى الأزمة بين “الناقد المعياري” الذي يبحث عن الثبات، و”الناقد التأويلي” الذي يحتفي بالاختلاف والانفتاح.
لقد غدت القيمة في النقد المعاصر مرآةً لحركة الفكر الإنساني: من التمركز حول المطلق إلى الاحتفاء بالنسبي، ومن فكرة النموذج الأعلى إلى الاعتراف بتعدّد المعايير الجمالية. فالنقد لم يعد يحاكم النصوص على مقاييس مسبقة، بل يصغي إلى لغتها الداخلية، ويتأمل علاقتها بالعالم وبالذات والآخر.
إن القيمة في نهاية المطاف ليست رقماً نقدياً ولا صفة جاهزة، بل هي فعلُ اكتشافٍ مستمر، يعبّر عن وعي الإنسان بقدرته على إعادة تعريف الجمال. والمعيار ليس سيفاً يُسلّط على النصوص، بل أفقٌ مفتوح تتجدد فيه معاني الإبداع عبر الأزمنة والثقافات. وكما قال مارتن هايدغر: «كل حكمٍ جمالي هو في جوهره انكشافٌ للوجود» — أي أن القيمة هي لحظة وعي الإنسان بجوهر الفن كطريقةٍ في أن يكون.
هكذا يظلّ النقد الأدبي، في كل عصر، ساحةً تتصارع فيها الرؤى حول معنى القيمة، وحول السؤال الأبدي: هل الجمال غاية في ذاته أم طريق إلى الحقيقة؟
وما دام النصّ الإنساني قابلاً للدهشة، فإن المعيار سيظلّ يتبدّل، لتبقى القيمة في جوهرها بحثاً عن الإنسان في اللغة، وعن اللغة في الإنسان.