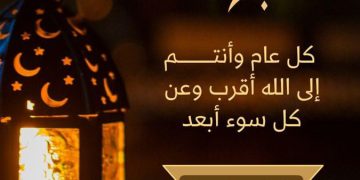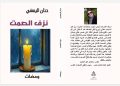الدكتور عبد الله موسى بيلا: شاعرٌ بين الهويات، وناقدٌ بين الحقول
بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي
[email protected]
الملخص
يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة شاملة عن الشاعر والناقد الدكتور عبد الله موسى بيلا، بوصفه نموذجًا فريدًا لتداخل الهويات الثقافية، وتعدد الأدوار الفكرية، وتكامل المسارات الإبداعية والنقدية. ينتمي بيلا إلى بوركينا فاسو، لكنه نشأ وتكوّن علميًا وثقافيًا في مكة المكرمة، مما أضفى على تجربته الشعرية والنقدية طابعًا مركّبًا يجمع بين الروحانية الإسلامية، والوعي الإفريقي، والانفتاح العالمي.
يركز المقال على تحليل سيرته الذاتية، ومسيرته الأكاديمية، وخبراته التعليمية، ونشاطاته الثقافية، وإصداراته الشعرية والنقدية، ومشاركاته في الفعاليات الأدبية والسياسية، مع تقديم قراءة نقدية معمقة لأبرز دواوينه، وقراءة موسعة لقصيدته “كوسوفا الحزينة” بوصفها نموذجًا شعريًا يجمع بين الهم الإنساني والوعي السياسي.
من خلال هذه الدراسة، يسعى المقال إلى إبراز أثر بيلا في الحقول الأدبية والفكرية، وتقديمه بوصفه شاعرًا وناقدًا ومثقفًا عضويًا، يربط بين الفن والموقف، وبين الكلمة والواقع، وبين الهوية والعدالة.
المقدمة
في زمن تتقاطع فيه الهويات، وتتشابك فيه الانتماءات، وتتعاظم فيه الحاجة إلى خطاب شعري ونقدي يتجاوز الحدود القومية واللغوية، تبرز تجربة الدكتور عبد الله موسى بيلا بوصفها نموذجًا فريدًا لهذا التداخل الخلّاق. فهو شاعر إفريقي النشأة، مكيّ التكوين، عالميّ الحضور، استطاع أن يدمج بين الأصالة والحداثة، وبين الشعر والنقد، وبين التعليم والممارسة الثقافية، في مسيرة تتسم بالثراء والتعدد والالتزام.
تُظهر كتاباته الشعرية والنقدية قدرة عالية على التفاعل مع القضايا الإنسانية الكبرى، من الهوية والاغتراب، إلى الحرية والعدالة، إلى الذاكرة والمقاومة. كما أن مشاركاته في الفعاليات الثقافية والسياسية، من مهرجانات الشعر إلى مؤتمرات التسامح، تؤكد أن بيلا لا يكتب من برج عاجي، بل من موقع المثقف العضوي، الذي يرى في الكلمة وسيلة للتغيير، وفي الشعر أداة للوعي، وفي النقد منهجًا للفهم.
ينقسم هذا المقال إلى خمسة فصول رئيسية، تبدأ بالسيرة الذاتية وسياق التكوين الفكري، ثم تنتقل إلى الخبرات التعليمية، والنشاطات الثقافية، والإصدارات الأدبية، قبل أن تصل إلى التحليل النقدي لأربعة دواوين رئيسية، وتنتهي بقراءة موسعة لقصيدته “كوسوفا الحزينة”، التي تُعد ذروة التفاعل بين الشعر والذاكرة السياسية.
من خلال هذا البناء المنهجي، يسعى المقال إلى تقديم بيلا بوصفه شاعرًا لا يُقرأ فقط من خلال قصائده، بل من خلال مسيرته، ومواقفه، وأثره في الحقول الفكرية والأدبية، بما يليق بمكانته، ويُسهم في إدماج تجربته ضمن خارطة الشعر العربي المعاصر، بل وخارطة الأدب العالمي متعدد الهويات.
الفصل الأول: السيرة الذاتية وسياق التكوين الفكري
1. النشأة والجذور: بين الانتماء الإفريقي والتكوين المكي
وُلد الدكتور عبد الله موسى بيلا عام 1981م في مكة المكرمة، المدينة التي تمثل رمزًا روحيًا وثقافيًا في الوعي الإسلامي، لكنه ينتمي من حيث الجنسية إلى بوركينا فاسو، إحدى دول غرب إفريقيا. هذا التداخل بين الجغرافيا الروحية والجنسية الإفريقية منح تجربته الشعرية والنقدية طابعًا مركّبًا، حيث تتجاور في كتاباته عناصر الهوية، والاغتراب، والانتماء، والبحث عن الذات.
إن نشأته في مكة، المدينة التي تحتضن الحجاج من كل بقاع الأرض، جعلت من بيلا شاهدًا حيًا على التعدد الثقافي، والتفاعل الحضاري، والانفتاح على الآخر، وهي عناصر ستتجلى لاحقًا في شعره ونقده، من خلال استدعاء الرموز، وتوظيف الأسطورة، والانتصار للإنسانية.
ملاحظة تحليلية: يمكن اعتبار بيلا شاعرًا “ما بعد قومي”، إذ لا تنحصر تجربته في حدود وطنية ضيقة، بل تتسع لتشمل قضايا الإنسان، والهوية، والعدالة، كما يظهر في قصيدته “كوسوفا الحزينة”.
2. المسار الأكاديمي والعلمي: من علوم الشريعة إلى النقد الفني
بدأ بيلا مسيرته الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس في الكتاب والسنة من دار الحدث الخيرية بمكة عام 2008م، وهو تكوين يمنحه خلفية دينية قوية، تتجلى في توظيفه للرموز القرآنية والحديثية في شعره، وفي اهتمامه بالبلاغة والنظم.
ثم انتقل إلى ماليزيا، حيث حصل على درجة الماجستير في الأدب العربي والنقد الفني من جامعة المدينة العالمية عام 2013م، قبل أن يُكمل الدكتوراه في نفس التخصص والجامعة عام 2018م. هذا الانتقال من الحقل الديني إلى الحقل النقدي يعكس تطورًا فكريًا واضحًا، حيث بدأ بيلا في الجمع بين الروحانية والتقنية، وبين الإلهام والتحليل.
تعليق نقدي: دراسته للدكتوراه بعنوان “بلاغة النظم في صحيح البخاري – كتاب الأدب نموذجًا” تمثل محاولة فريدة لقراءة النصوص الدينية بمنهج نقدي فني، مما يفتح المجال لتوظيف البلاغة الإسلامية في تحليل الشعر الحديث.
3. السياق الثقافي والتكوين الذاتي
لا يمكن فصل تكوين بيلا عن السياق الثقافي الذي نشأ فيه: مكة المكرمة، مدينة النصوص والرموز، وملتقى الثقافات. كما أن انتماءه إلى بوركينا فاسو يمنحه بعدًا إفريقيًا، يظهر في اهتمامه بقضايا الهوية، والعدالة، والحرية، وفي مشاركاته في مهرجانات ومؤتمرات دولية تُعنى بالتسامح والاعتدال.
تعليق تأويلي: بيلا ليس مجرد شاعر عربي، بل هو شاعر عالمي يتكلم بلسان الإنسان، ويكتب من موقع الضمير، ويستدعي في شعره ذاكرة الجماعة، لا مجرد تجربة الذات.
الفصل الثاني: الخبرات العملية في مجال التعليم
1. التعليم العام: ممارسة تربوية تأسيسية
مارس الدكتور عبد الله موسى بيلا التعليم العام في مكة المكرمة لمدة ثماني سنوات، من العام الدراسي 1429هـ/2008م إلى العام 1437هـ/2016م، وهي فترة طويلة نسبياً في السياق التربوي، تُمكّنه من فهم عميق لطبيعة المتعلم، واحتياجاته النفسية والمعرفية، وتحديات التعليم في السياق العربي.
خلال هذه المرحلة، تخصص في تدريس الأدب العربي ومواد الاجتماعيات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وهو ما يعكس اهتمامًا مبكرًا بالبعد الثقافي والتاريخي، ويُظهر قدرة على الربط بين النصوص الأدبية والسياقات الاجتماعية والسياسية التي تُنتجها وتُعيد تشكيلها.
تعليق تحليلي: هذه التجربة التربوية لا تُعد مجرد ممارسة وظيفية، بل هي جزء من تكوينه الثقافي، حيث يظهر في شعره ونقده وعيٌ تربوي واضح، يتجلى في قدرته على مخاطبة فئات عمرية متعددة، وفي اهتمامه بتبسيط المفاهيم دون تفريط في العمق.
2. الأنشطة الصفية وغير الصفية: من التعليم إلى التثقيف
أسهم بيلا في العديد من الأنشطة الصفية وغير الصفية، مما يدل على فهمه للتعليم بوصفه عملية شاملة تتجاوز حدود الكتاب المدرسي. فقد شارك في تنظيم فعاليات ثقافية، وإعداد برامج تربوية، وتوجيه الطلاب نحو القراءة والكتابة الإبداعية، وهو ما يُعد امتدادًا طبيعيًا لاهتمامه بالشعر والنقد.
تعليق تأويلي: هذه الأنشطة تُظهر أن بيلا لا يرى التعليم بوصفه نقلًا للمعلومة، بل بناءً للوعي، وتشكيلًا للذائقة، وتحريرًا للخيال، وهي قيم تتجلى في كتاباته الشعرية والنقدية، خصوصًا تلك الموجهة للأطفال والناشئة.
3. أثر التجربة التعليمية في الكتابة الشعرية والنقدية
يمكن القول إن تجربة بيلا في التعليم العام تركت أثرًا واضحًا في كتاباته، من حيث:
• وضوح اللغة، دون تفريط في الرمزية
• حضور القضايا التربوية والإنسانية في شعره
• اهتمامه بالأدب الموجّه للأطفال
• قدرته على بناء خطاب نقدي تربوي، كما يظهر في دراساته الأكاديمية
ملاحظة منهجية: يمكن في هذا السياق اقتراح دراسة مقارنة بين شعر بيلا الموجّه للأطفال، وشعره الموجّه للكبار، من حيث اللغة، والرمز، والوظيفة، مما يُظهر تعددية في الخطاب، ومرونة في التكوين.
الفصل الثالث: النشاطات الثقافية والإنجازات الأدبية
أولًا: النشاطات الثقافية والمهنية
يمتلك الدكتور عبد الله موسى بيلا سجلًا غنيًا من النشاطات الثقافية والمهنية التي تعكس تعددية اهتماماته، وعمق انخراطه في الحقل الأدبي والفني. فهو لا يكتفي بالكتابة الشعرية، بل يشارك في التحرير، والمراجعة اللغوية، وكتابة المقالات، والخطابات، والأخبار، مما يدل على قدرة لغوية عالية، وحسّ نقدي متطور.
من أبرز نشاطاته:
• تحرير ومراجعة النصوص الشعرية والأدبية، بما في ذلك أخبار مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية (2022م)، وهو ما يعكس ثقة مؤسسات رسمية في قدراته اللغوية.
• كتابة قصص ومسرحيات وأناشيد للأطفال لمجلة “مكي للأطفال”، إلى جانب حضور دورات تدريبية متخصصة، مما يدل على اهتمامه بالتربية الجمالية والنفسية للطفل.
• الإشراف الإلكتروني على منتديات أدبية منذ عام 2004، وهو ما يُظهر وعيًا مبكرًا بأهمية الفضاء الرقمي في نشر الثقافة، وتبادل المعرفة.
• المشاركة في الأعمال الموسمية التطوعية في مكة، خلال رمضان والحج، مما يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا يتجاوز حدود الكتابة.
تعليق تحليلي: هذه النشاطات تُظهر أن بيلا ليس شاعرًا منعزلًا، بل مثقفًا عضويًا، يربط بين الكتابة والمجتمع، وبين الفن والخدمة، ويؤمن بأن الكلمة يجب أن تكون فاعلة في الواقع، لا مجرد ترف لغوي.
ثانيًا: الإصدارات الشعرية والنقدية
يمتلك بيلا أربعة دواوين شعرية تمثل مراحل تطور تجربته الفنية:
السمات البارزة سنة الإصدار الديوان
توظيف الرمز الترابي، استدعاء الجذور، بناء الهوية 2012 تآويل ترابية
مزج الحلم بالواقع، استعادة الذات، لغة شفافة 2015 صباحٌ مرمّمٌ بالنجوم
تفكيك الجسد، الغيرية، التناص مع الأسطورة 2019 سفرٌ إلى الجسد الآخر
تعددية الذاكرة، وحدة القصيدة، التجريب الفني 2022 أربع وعشرون ذاكرة لقصيدة واحدة
كما صدرت له دراستان نقديتان:
• “بردة البوصيري وأثرها في الأدب العربي الحديث”: دراسة في التناص والتأثير، تربط بين التراث والحداثة.
• “بلاغة النظم في صحيح البخاري – كتاب الأدب نموذجًا”: دراسة بلاغية فنية في النصوص الدينية، تُظهر قدرة على التحليل النقدي العميق.
تعليق نقدي: هذه الإصدارات تُظهر أن بيلا يجمع بين الإبداع والتحليل، وبين الشعر والنقد، مما يمنحه موقعًا مركزيًا في المشهد الثقافي العربي المعاصر.
ثالثًا: المشاركات والجوائز
شارك بيلا في عدد كبير من الفعاليات الثقافية، منها:
• أمسيات شعرية في نوادي أدبية سعودية (جدة، الطائف، مكة، تبوك، الباحة، جازان، نجران)
• مهرجان سوق عكاظ الشعري (2018)
• مهرجان الشارقة للشعر العربي (2017)
• مهرجان بيت الشعراء العالمي في إربد (2022)
• مؤتمر التسامح والاعتدال ضد التطرف في موريتانيا (2020)
وحصل على جوائز مرموقة، منها:
• المركز الأول في مسابقة ملتقى جازان الشعري (2012)
• جائزة السنوسي الشعرية (2018)
• المركز الثاني في جائزة “راشد بن حمد الشرقي للإبداع” (2020)
• اختير ضمن أفضل مائة شاعر عربي (2013)
تعليق تأويلي: هذه الجوائز والمشاركات تُظهر أن بيلا ليس فقط شاعرًا مبدعًا، بل أيضًا معترف به من قبل مؤسسات ثقافية رفيعة، مما يعزز من مكانته في الحقل الأدبي العربي والدولي.
الفصل الرابع: القصيدة بوصفها مشروعًا وجوديًا متعدد الأبعاد: قراءة في أربعة دواوين لعبد الله موسى بيلا
يشكّل الشعر عند عبد الله موسى بيلا مشروعًا متكاملًا، لا يُقاس بمنجز نصي منفرد، بل بمنظومة شعرية تتوزع على مستويات متعددة من التأويل، والتمثيل، والتجريب. في هذا الفصل، نقف أمام أربعة دواوين تمثل مراحل متداخلة من هذا المشروع: تأويل ترابية، صباح مرمم بالنجوم، سفرٌ إلى الجسد الآخر، وأربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة. كل ديوان منها ينهض على إشكالية خاصة، لكنه في الوقت ذاته يتقاطع مع الآخر في بناء رؤية شعرية تتسم بالعمق الفلسفي، والانفتاح الرمزي، والتجذر الثقافي.
من تأويل التراب بوصفه مادة وجودية، إلى ترميم الذات عبر النجوم، ومن استكشاف الجسد كفضاء شعري، إلى تحويل القصيدة إلى ذاكرة متعددة، تتشكل لدى بيلا قصيدة لا تكتفي بالقول، بل تسعى إلى إعادة تشكيل العالم. ومن هنا، يسعى هذا الفصل إلى تحليل هذه الدواوين بوصفها حلقات في مشروع شعري واحد، يتداخل فيه التأويلي مع الوجودي، والجسدي مع الثقافي، والذاتي مع الكوني.
1) “تأويل التراب وتفكيك الذات: قراءة تأويلية في ديوان تأويل ترابية للدكتور عبد الله موسى بيلا”
تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على تجربة شعرية فريدة في المشهد العربي المعاصر، حيث يقدّم الدكتور عبد الله موسى بيلا في ديوانه تأويل ترابية نصًا شعريًا يتجاوز الوظيفة الجمالية إلى الوظيفة التأويلية والوجودية. تنطلق القراءة من فرضية أن التراب في هذا الديوان ليس مجرد رمز بل هو بنية تأويلية تتقاطع فيها الذات، الذاكرة، والهوية. وتستند الدراسة إلى منهج تأويلي-تفكيكي، يراعي البنية النصية، السياق الثقافي، والامتدادات الفلسفية للخطاب الشعري.
الإطار النظري والمنهجي
تعتمد الدراسة على:
• المنهج التأويلي : لفهم البنية الرمزية والدلالية للنصوص، خاصة في علاقتها بالتراث والهوية.
• المنهج التفكيكي: لتفكيك الثنائيات الضمنية في النص (الذات/الآخر، الحضور/الغياب، التراب/السماء).
• نظرية التناص : لرصد التداخلات النصية مع التراث العربي والإسلامي، والأدب العالمي.
التحليل النصي
أولًا: التراب كأفق تأويلي
التراب في الديوان ليس مادة جامدة، بل هو كائن شعري حي، يحمل ذاكرة الجماعة، ويؤسس لهوية وجودية. في قصيدة “هذا التراب”، يتحول التراب إلى “وثيقة روحي”، مما يفتح المجال لتأويله كأرشيف للذات، وكمكان للانبعاث والانطفاء.
“هذا الترابُ وثيقةُ روحي / هُوِيّةُ سُنبُلتي الأبديةُ”
التراب هنا يتجاوز رمزيته الدينية (الخلق والموت) ليصبح بنية تأويلية تستوعب الحزن، الغياب، والانتماء.
ثانيًا: الذات المتشظية والآخر الزئبقي
الذات في الديوان ليست مستقرة، بل هي في حالة تشظٍ دائم، تبحث عن خلاصها في الآخر، الذي لا يُمسك ولا يُعرّف. في قصيدة “محاولة للخروج إلي”، يكتب:
“فاحتمِلني أيا آخَرِي .. فكلانا .. كلانا”
هذا الخطاب يعبّر عن أزمة هوية، وعن رغبة في تجاوز الانفصال الداخلي عبر الآخر، الذي هو في الوقت ذاته مرآة وتشويه.
ثالثًا: الزمن ككائن متهاوٍ
الزمن في الديوان لا يسير وفق خطية سردية، بل يتساقط، يتشظى، ويتحول إلى ورق أصفر، كما في قصيدة “تساقط زمن”:
“يتساقطُ الزمنُ الخريفُ على يديْ / وَرَقَاً تكسَّرَ أصفراً كالوهم”
هنا يتحول الزمن إلى وهم بصري، وإلى مادة قابلة للتأويل، مما يفتح المجال لفهم الذاكرة كفعل شعري لا كمجرد استعادة.
رابعًا: الحزن والغياب كحضور شعري
الحزن في الديوان ليس حالة شعورية، بل هو بنية شعرية، تتجلى في قصائد الرثاء، خاصة في “رسالة إلى سيد البيد” و”بعث المنائر”، حيث يتحول الغياب إلى حضور مضاد، وإلى طقس شعري يعيد تشكيل العلاقة مع الموت والذاكرة.
“صحوت .. وغادرتَ أحلامَنا / ونحنُ بأوهامنا .. نحلمٌ”
الرثاء هنا لا يكتفي بالتأبين، بل يعيد إنتاج الغائب في بنية شعرية تستدعيه وتعيد تشكيله.
خامسًا: التناص الثقافي والتداخل النصي
يتداخل الديوان مع التراث العربي الكلاسيكي (الزهد، التصوف، الشعر الجاهلي)، ومع الأدب العالمي (الرمزية الفرنسية، غوته، بودلير). كما يستحضر شخصيات ثقافية عربية معاصرة، مثل سعيد السريحي ومحمد الثبيتي، في سياق تأملي ورثائي، مما يمنح النص بعدًا ثقافيًا متعدد الطبقات.
أثر الديوان في الحقول الفكرية والثقافية
1. في الحقل الأدبي
• يؤسس الديوان لمدرسة شعرية تأويلية، تتجاوز الشكل إلى الجوهر، وتعيد تعريف وظيفة الشعر كأداة للوعي والتأمل.
2. في الحقل الثقافي
• يطرح أسئلة الهوية والانتماء، ويعيد الاعتبار للتراب كرمز ثقافي وروحي، مما يجعله وثيقة ثقافية تتجاوز اللحظة الشعرية إلى الذاكرة الجمعية.
3. في الحقل الفلسفي
• يفتح أفقًا فلسفيًا جديدًا في الشعر العربي، حيث تتداخل مفاهيم الذات، الزمن، والوجود، في بنية شعرية تتطلب قارئًا متأملًا، لا مستهلكًا.
4. في الحقل الأكاديمي
• يُعد الديوان مادة خصبة للدراسات النقدية، والبحوث الأكاديمية في مجالات الأدب المقارن، التأويل، والرمزية الشعرية، خاصة في سياق تحليل العلاقة بين اللغة والهوية.
الخاتمة والتوصيات
ديوان تأويل ترابية هو تجربة شعرية تأويلية عميقة، تعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والتراب، بين الذات والآخر، وبين الحرف والهوية. بأسلوبه المتفرد، ورؤيته الفلسفية، يضع الدكتور عبد الله موسى بيلا بصمته في خارطة الشعر العربي المعاصر، ويمنح القارئ فرصة نادرة للتأمل في معنى أن يكون الإنسان ترابيًا، حالمًا، ومؤولًا.
توصيات:
• إدراج الديوان ضمن مقررات الأدب العربي المعاصر في الجامعات.
• تنظيم ندوات نقدية حول الشعر التأويلي في العالم العربي.
• ترجمة الديوان إلى لغات أخرى لتوسيع أثره الثقافي والفكري عالميًا.
2) الشعر كترميم وجودي بين المحلي والكوني: قراءة في ديوان “صباح مرمم بالنجوم” لعبد الله موسى بيلا
يأتي ديوان صباح مرمم بالنجوم للشاعر عبد الله موسى بيلا بوصفه تجربة شعرية تتجاوز حدود التعبير الجمالي، لتغدو ممارسة معرفية ومقاومة ثقافية. فالشعر هنا لا يُكتب من أجل التجميل أو التأمل فحسب، بل يُستدعى بوصفه أداة لترميم الذات، واستعادة الذاكرة، ومساءلة العالم. العنوان ذاته يشي بعملية مزدوجة: ترميم الصباح، أي الزمن والوعي، عبر استعارة النجوم كأدوات ضوئية في مواجهة العتمة، سواء كانت عتمة داخلية أو تاريخية.
يندرج هذا الديوان ضمن ما يمكن تسميته بـ”الشعر الوجودي المقاوم”، حيث تتقاطع فيه عناصر من شعر ما بعد الحداثة مع مرجعيات تراثية إفريقية وعربية، ليطرح إشكالية مركزية تتعلق بإمكانات الشعر في إعادة بناء الذات، وتشكيل وعي كوني يتجاوز المحلي. من هنا، يعتمد هذا التحليل على مقاربة سيميائية-ثقافية، تستكشف البنية الرمزية، والتمثيلات الوجودية، والوظيفة المعرفية للنص الشعري، مع استحضار أدوات من النقد الثقافي، والفلسفة الوجودية، والدراسات المقارنة.
التحليل النقدي
1. البنية الشعرية واللغوية: من التفكيك إلى التكوين
يعتمد الديوان على قصيدة النثر، متحررًا من القافية والوزن، لكنه مشبع بإيقاع داخلي ناتج عن التكرار، التوازي، والانزياح الدلالي. تتسم اللغة بكثافة رمزية، حيث تتحول المفردات اليومية إلى إشارات فلسفية: “الصباح”، “النجوم”، “الدم”، “التراب”، “غوري”، “غزة”—كلها تحمل طبقات من المعنى تتجاوز المباشر إلى التأويلي.
التراكيب الشعرية تتحدى المألوف، وتخلق مفاجآت لغوية، مثل:
“ينقصك النقص الفائض عن جبروتك” “أنا الشبيه أتيت أبحث عن شبيهي”
هذه الجمل تفتح أفقًا تأويليًا يتجاوز البلاغة إلى التفكيك، حيث تُعاد صياغة المفاهيم عبر مفارقة لغوية تزعزع الثابت وتؤسس للدهشة.
2. الذات والهوية: تمزق وجودي وسؤال الكينونة
يتكرر سؤال “من أنا؟” في أكثر من قصيدة، ويظهر الشاعر ككائن ممزق بين الماضي والحاضر، بين الذات والآخر، بين الحلم والواقع. في قصيدة “نجمة عمياء”، يتماهى الصوت مع الصمت، والذات مع الغياب، في مشهد شعري يعكس قلقًا وجوديًا عميقًا.
هذا التمزق لا يُقدَّم بوصفه ضعفًا، بل بوصفه شرطًا للوعي، حيث تصبح الهوية مشروعًا مفتوحًا، لا جوهرًا ثابتًا.
3. الذاكرة والحنين: الشعر كأرشيف وجداني
في “لذة الخاتمة”، يستحضر الشاعر ذاكرة الطفولة، الأب، الأم، وجيران القرية، ليؤسس سردية وجدانية تتقاطع مع الحنين والغياب. الذاكرة هنا ليست استرجاعًا، بل مقاومة للنسيان، ومحاولة لترميم الذات عبر استدعاء الصور المنسية.
يُوظف الحنين بوصفه أداة معرفية، حيث يتحول الماضي إلى مرآة لفهم الحاضر، وإعادة تشكيله.
4. الدم والموت: إعادة قراءة الأسطورة
الموت ليس نهاية، بل سؤال فلسفي يتكرر في “قابيل يفاوضني عن دمي”، و”مهرجان الموت”، حيث يتحول الدم إلى رمز للهوية، والقتل إلى فعل وجودي. يستحضر الشاعر قابيل وهابيل، ليعيد قراءة الأسطورة من منظور الضحية، ويطرح سؤال العدالة والقدر.
“قابيل يفاوضني عن دمي، وأنا أفاوضه عن موتي المؤجل”
هذا التوظيف يعكس رغبة في تفكيك السرديات الكبرى، وإعادة تأويلها من موقع الهامش، لا المركز.
5. إفريقيا والعدالة التاريخية: من الجرح إلى النهضة
في “شمس تليق بإفريقيا”، يكتب بيلا مرثية سياسية وإنسانية لإفريقيا، مستحضرًا رموزًا مثل “غوري”، “كونتا كونتي”، و”ماني”، ليكشف عن إرث العبودية والاستعمار. تتحول القصيدة إلى وثيقة احتجاج، لكنها أيضًا إلى حلم بالنهضة، حيث “تخرج إفريقيا في تمام التناقض”.
هذا التوظيف يربط بين الشعر والتاريخ، ويؤسس لوعي نقدي يتجاوز الرثاء إلى الفعل.
6. القصيدة كوعي كوني: الشعر بوصفه نجاة
في “القصيدة في تمام الوعي”، يعلن الشاعر أن القصيدة ليست شكلًا، بل حالة وعي، ووسيلة لتجاوز التكرار والرتابة. تتحول القصيدة إلى أداة للنجاة، ولإعادة تشكيل العالم، حيث يصبح الشعر فعلًا كونيًا لا يُحدّ بالزمن أو الجغرافيا.
أثر الديوان في الحقول المعرفية
1. فكريًا
• يطرح أسئلة فلسفية حول الزمن، الهوية، والموت.
• يدمج بين الأسطورة والدين والتاريخ، ليخلق خطابًا معرفيًا متعدد الأبعاد.
2. أدبيًا
• يمثل نقلة نوعية في شعر النثر العربي، من حيث التراكيب، الرمزية، والجرأة في الطرح.
• يفتح أفقًا جديدًا للقصيدة العربية، لتكون أكثر انفتاحًا على القضايا الكونية والإنسانية.
3. ثقافيًا
• يعيد الاعتبار للذاكرة الإفريقية والعربية، ويقاوم النسيان الثقافي عبر استحضار الرموز المنسية.
• يربط بين المحلي والعالمي، ويؤسس لجسر ثقافي بين إفريقيا والعالم العربي.
4. علميًا
• يشكل مادة خصبة للدراسات النقدية، السيميائية، والأنثروبولوجية.
• يثري البحث في الأدب المقارن، خاصة في تقاطع الشعر مع قضايا الهوية والعدالة.
الشعر كترميم للذات والكون
ديوان صباح مرمم بالنجوم ليس مجرد نص يُقرأ، بل تجربة تُعاش. هو مشروع شعري وجودي، ينقلك من الحنين إلى الثورة، ومن الغياب إلى الحضور، ومن الموت إلى الحلم. عبد الله موسى بيلا يكتب بلغة لا تشبه إلا نفسها، ويصوغ قصيدة لا تكتفي بالتأمل، بل تسعى إلى التغيير.
أثر هذا الديوان يتجاوز الأدب، ليصبح مساهمة في الوعي الجمعي، وفي إعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والكون، بين الذات والآخر، بين الحلم والتاريخ. ومن هنا، فإن هذا العمل يستحق أن يُدرَس لا بوصفه ديوانًا شعريًا فحسب، بل بوصفه وثيقة ثقافية وفلسفية، تفتح أفقًا جديدًا للقصيدة العربية المعاصرة.
3) سفرٌ إلى الجسد الآخر: قراءة نقدية في شعرية الجسد والروح عند عبد الله موسى بيلا
يمثل ديوان “سفرٌ إلى الجسد الآخر” للشاعر والأكاديمي عبد الله موسى بيلا تجربة شعرية فريدة تتقاطع فيها الفلسفة، والتصوف، والرمزية، مع حساسية لغوية عالية، وتوتر وجودي عميق. لا يكتفي النص الشعري هنا بأن يكون تعبيرًا عن الذات، بل يتحول إلى فضاء تأويلي يستدعي الأسطورة، ويستجوب التاريخ، ويعيد تشكيل العلاقة بين الجسد والروح، بين الذات والآخر، وبين اللغة والصمت.
تأتي هذه الدراسة لتفكك البنية الشعرية للديوان، وتستجلي أبعاده الجمالية والفكرية، وتقيّم أثره في الحقل الأدبي والثقافي، من خلال منهج نقدي تركيبي يجمع بين التحليل النصي، والمقاربة التأويلية، والقراءة المقارنة.
أولًا: بنية العنوان وتكثيف المفارقة
يشكل عنوان الديوان “سفرٌ إلى الجسد الآخر” مدخلًا تأويليًا غنيًا، إذ يطرح مفارقة وجودية: هل الجسد الآخر هو جسد الذات وقد تحوّل؟ أم جسد الآخر بوصفه مرآةً للذات؟ أم هو الجسد المجازي الذي يتجاوز المادة نحو الروح؟ العنوان يوحي بحركة انتقالية، لا مكانية فحسب، بل معرفية ووجودية، مما يفتح أفقًا شعريًا يتجاوز حدود الجسد الفيزيائي نحو الجسد الرمزي، التاريخي، والميتافيزيقي.
ثانيًا: شعرية الجسد والروح: من التجسيد إلى التجريد
في قصائد مثل “عن جسدي أتخلّى”، و”أعشقُ أحزاني”، و”أُصلبُ في جسدي”، تتجلى ثنائية الجسد والروح بوصفها مركزًا شعريًا. الجسد هنا ليس مجرد وعاء، بل هو ساحة صراع، ومسرح رمزي، وموضوع فلسفي.
“من جثماني أنهضُ في اليوم الثالثِ كالمصلوبِ” هذه الصورة تستدعي التناص المسيحي، لكنها تُوظّف في سياق شعري يعيد تأويل القيامة بوصفها تحوّلًا داخليًا، لا خلاصًا دينيًا.
الروح، في المقابل، تظهر كفضاءٍ للتجاوز، كما في قوله:
“أحمَدُني إذ صرتُ الآن أخفّ بلا جسدٍ / إذ صرتُ رماداً أزلياً” هنا يتحول الفناء إلى خلود، ويتحول الجسد إلى أثر، مما يعكس رؤية صوفية عميقة.
ثالثًا: التناص الديني والأسطوري: تفكيك المقدّس
يحفل الديوان بتناصات متعددة مع النصوص الدينية (القرآن، الإنجيل)، والأسطورية (القيامة، الطوفان، النبوة)، لكنها لا تُستدعى للتعظيم، بل لإعادة مساءلة المعنى. في قصيدة “قمصان التاريخ في الأرض المقدسة”، يستحضر الشاعر رمزية يوسف، لكنه يعيد تشكيلها في سياق دموي، مما يحوّل القميص من رمز للبراءة إلى وثيقة للجرح.
“أنا ربُّ هذا القطيعِ من الإبلِ .. ◌ُدَّ إليَّ قطيعيْ فللبيتِ ربِّ سيحميه إن شاءَ” هنا يُستدعى النص القرآني، لكن يُعاد توظيفه في سياق ساخر، مما يكشف عن موقف نقدي من التوظيف السياسي للدين.
رابعًا: الذات والآخر: من الحزن إلى التوحد
الذات الشعرية في الديوان ليست منغلقة، بل منفتحة على الآخر: الطفل، المرأة، الشهيد، القتيل، مما يمنح النص بعدًا إنسانيًا عميقًا. الحزن يتحول إلى فلسفة وجود، كما في قصيدة “أعشقُ أحزاني”، حيث يُحتفى بالحزن بوصفه طقسًا تطهيريًا، ووسيلة لفهم العالم.
الآخر لا يُقدّم بوصفه نقيضًا، بل بوصفه امتدادًا للذات، مما يخلق شعرية التوحد، لا شعرية الانفصال.
خامسًا: أثر الديوان في الحقول الفكرية والأدبية والثقافية
1. في الحقل الفكري
• يطرح الديوان أسئلة وجودية حول الهوية، والموت، والعدالة، مما يجعله نصًا صالحًا للدراسة الفلسفية، والأنثروبولوجية، والدينية.
2. في الحقل الأدبي
• يمثل الديوان نموذجًا متقدمًا للقصيدة العربية الحديثة، التي تتجاوز الشكل العمودي نحو التجريب، والتكثيف، والتناص، مما يثري المشهد الشعري العربي المعاصر.
3. في الحقل الثقافي
• يعكس الديوان همومًا إنسانية مشتركة، من الحروب إلى الطفولة، ومن الأرض إلى السماء، مما يجعله نصًا عابرًا للثقافات، وقادرًا على إثارة الحوار بين الشعوب.
4. في الحقل العلمي
• يمكن للديوان أن يكون مادة خصبة للبحوث في الأدب المقارن، والدراسات الثقافية، والدراسات الدينية، لما فيه من إشارات متعددة إلى الأسطورة، والتاريخ، والرمز، والهوية.
ديوان “سفرٌ إلى الجسد الآخر” هو نصٌ شعريٌّ مركّب، يتجاوز حدود الشعر ليصبح تأملًا فلسفيًا، وصرخةً وجودية، ومرآةً للذات والآخر. إنه سفرٌ في اللغة، وفي الذاكرة، وفي الجسد، وفي الروح، يكتب فيه عبد الله موسى بيلا قصيدته كما لو كانت صلاةً، أو نبوءةً، أو نشيدًا أخيرًا.
4) القصيدة بوصفها ذاكرة متعددة: قراءة نقدية في ديوان “أربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة” لعبد الله موسى بيلا
يتناول هذا البحث قراءة نقدية موسعة لديوان “أربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة” للشاعر والأكاديمي الدكتور عبد الله موسى بيلا، بوصفه مشروعًا شعريًا يتجاوز البنية التقليدية للقصيدة نحو فضاء تأملي يتقاطع فيه الشعر مع الفلسفة، والهوية، والذاكرة الثقافية. يعتمد البحث على منهج تحليلي تأويلي، يستكشف البنية اللغوية، الرمزية، والتناصية للنصوص، ويقيّم أثر الديوان في الحقول الأدبية والفكرية والثقافية. ويخلص إلى أن الديوان يمثل نموذجًا متقدمًا في الشعر العربي المعاصر، يعيد تعريف القصيدة بوصفها كائنًا حيًا ذا ذاكرة متعددة الأبعاد.
في ظل التحولات الجمالية والفكرية التي يشهدها الشعر العربي المعاصر، يبرز ديوان “أربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة” كعمل شعري يتحدى القوالب الجاهزة، ويعيد تشكيل العلاقة بين القصيدة والذاكرة، بين الذات واللغة، وبين الزمن والهوية. العنوان وحده يفتح أفقًا تأويليًا واسعًا، حيث تتقاطع “الذاكرة” مع “القصيدة” في جدلية الوحدة والتعدد، مما يستدعي قراءة نقدية تتجاوز السطح النصي نحو البنية العميقة للخطاب الشعري.
الإطار النظري والمنهجي:
يعتمد البحث على:
• المنهج التأويلي : لفهم تعددية المعاني داخل النصوص.
• نظرية الذاكرة الثقافية : كما طرحها يان آسمن، لفهم كيف تُستدعى الذاكرة في بناء الهوية الشعرية.
• تحليل الخطاب الشعري: للكشف عن البنية اللغوية والرمزية.
• مقاربة تناصية: لرصد التفاعلات النصية مع التراث العربي والإسلامي والفكر الصوفي.
التحليل النقدي:
1. القصيدة كذاكرة لا كخطاب
• كل “ذاكرة” في الديوان تمثل زاوية جديدة لرؤية القصيدة، مما يجعل النصوص أقرب إلى سرديات شعرية متفرعة من نواة واحدة.
• القصيدة ليست خطابًا موجهًا، بل تجربة داخلية تتشكل عبر استدعاء الذاكرة، مما يمنحها طابعًا وجوديًا.
2. اللغة الشعرية: بين التبسيط والتكثيف
• يوظف الشاعر لغةً تتراوح بين الشفافية والتكثيف الرمزي، مما يخلق توازنًا بين القارئ العام والمتخصص.
• الانزياح اللغوي حاضر بقوة، خاصة في استخدام المفردات ذات الطابع الصوفي والوجودي.
3. الرمزية والتناص
• رموز مثل “الضوء”، “الطين”، “الحرف”، “الظل”، تُستخدم بوصفها أدوات فلسفية لا مجرد صور شعرية.
• التناص مع القرآن الكريم، والشعر الجاهلي، والصوفية، يخلق شبكة دلالية غنية، ويمنح النصوص عمقًا حضاريًا.
4. الزمن الدائري والهوية المتحوّلة
• الزمن في الديوان ليس خطيًا، بل يتخذ شكلًا دائريًا، حيث تعود الذكريات لتعيد تشكيل اللحظة الشعرية.
• الهوية الشعرية ليست ثابتة، بل تتشكل عبر الذاكرة، مما يجعل الذات الشاعرة في حالة تحول دائم.
5. القصيدة بوصفها كائنًا حيًا
• يعامل الشاعر القصيدة ككائن حي له نبض، وذاكرة، وتحولات، مما يضفي على النصوص طابعًا ديناميكيًا.
• هذا التصور يحرر القصيدة من كونها منتجًا لغويًا إلى كونها تجربة وجودية.
الأثر الثقافي والفكري:
• أدبيًا: يعيد الديوان تعريف القصيدة بوصفها تجربة متعددة الأبعاد، مما يفتح أفقًا جديدًا للشعر العربي المعاصر.
• فكريًا: يطرح أسئلة حول العلاقة بين اللغة والهوية، وبين الذاكرة والزمن، مما يجعله نصًا تأمليًا بامتياز.
• ثقافيًا: يدمج بين التراث والحداثة، ويعيد تقديم الرموز الثقافية برؤية جديدة.
• أكاديميًا: يمثل مادة خصبة للدراسات النقدية، خاصة في مجالات تحليل الخطاب، والذاكرة الثقافية، والتناص.
يمثل ديوان “أربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة” تجربة شعرية متقدمة، تتجاوز حدود الشكل والمضمون، لتعيد تشكيل العلاقة بين القصيدة والذاكرة، وبين الذات واللغة. إنه عمل شعري وفكري وثقافي، يستحق أن يُدرّس ويُناقش في المحافل الأكاديمية، ويُقرأ بوصفه نموذجًا لتجديد الشعر العربي من الداخل، عبر أدواته الرمزية، ولغته المتحوّلة، ورؤيته الوجودية.
الخاتمة
تكشف قراءة هذه الدواوين الأربعة عن أن عبد الله موسى بيلا لا يكتب الشعر بوصفه تعبيرًا فرديًا، بل بوصفه ممارسة معرفية وجمالية تسعى إلى مساءلة الذات والعالم. فـتأويل ترابية يعيد بناء العلاقة بين الإنسان والمادة، وصباح مرمم بالنجوم يطرح الشعر كترميم للزمن والوعي، وسفرٌ إلى الجسد الآخر يستكشف الجسد بوصفه نصًا، وأربعٌ وعشرون ذاكرةً لقصيدةٍ واحدة يحوّل القصيدة إلى أرشيف حيّ للذاكرة.
إن هذا التعدد لا يعني التشتت، بل يدل على قدرة الشاعر على بناء مشروع شعري متكامل، تتوزع فيه الوظائف بين التأويل، والمقاومة، والاستذكار، والتجريب. ومن هنا، فإن دواوين بيلا لا تُقرأ منفصلة، بل تُفهم ضمن نسيج شعري واحد، يطمح إلى تأسيس قصيدة عربية معاصرة، قادرة على احتضان التعدد، ومساءلة الثابت، وتوليد المعنى من قلب التناقض.
الفصل الخامس: “تحليل قصيدة ‘كوسوفا الحزينة’: بين الرثاء وتشريح الأزمة
“كوسوفا الحزينة”
كوسوفَا هل من قبلُ أسعدك الدهرُ؟
وهل كنتِ بستاناً يسيل به النهرُ؟
وهل كنت مثل الطفل يفترُّ ضاحكاً
ليبسم في أحشائه الخير والبِشرُ؟
وهل كنتِ قبل اليومِ للشرِّ مرتعاً؟
وهل عاش فيك الضَيْمُ والجَوْر والغدرُ؟
فما كنت إلا روضةً مطمئنةً
فزمجر في آفاقها الصربُ والفقرُ
فماذا جنى الإسلام حتى تواطؤوا
عليه، فما يُخشى وليس له أمرُ
كأني أرى الإسلام يندب حظَّه
ويذكر تاريخاً يزيِّنُهُ النصرُ
ويَلطِمُ وجهاً طالما عزَّ شأنه
وطار له صيتٌ وعانقه الفخرُ
فقلت له: كفكف دموعك … إنَّما
صخور البوادي لا يُحرِّكها النقرُ
فلو كان للإسلام عزٌّ ومنعةٌ
لما هان يوماً أو تمالكه الذُعرُ
فقد كان طوداً شامخاً لا تهزُّه
رياح الأعادي أو تخوِّفه السُّمرُ
وما هان دينُ الله بل هان أهله
وذلُّوا … فما يغني المَقامُ ولا الذِكرُ
فقد عاث فينا الصرب سراً وجهرةً
ومُكِّن منَّا الظُلم والبطشُ والأسرُ
كوسوفَا مهما طال ليلٌ سينجلي
ليَنفُر عَنك العسرُ يطرُدُه اليُسرُ
فويلاه يا ويلاه مِن حالِ أمةٍ
تَشبَّث فيها الخوفُ والذلُ والعَفْرُ
فكيف لنا صبرٌ وفي القلبِ حُرقةٌ
يهون على كتمانها الموت والقبرُ
فمن للثكالى فاضَ دمعُ عيونها
ومن لوليدٍ فاض من عينه الجمرُ
فكيف لهم أن يهتكوا عرضَ غادةٍ
وحوريةٍ حسناء يحسدها البدرُ
مآسٍ يَعِزُّ الصبر عند وقوعها
ويعجز عن وصفٍ لها القولُ والشعرُ
إلى الله نشكو ما ألمَّ بحالنا
ونسأله فتحاً فقد نَفِدَ الصبرُ
وما كنت أرجو أن تحين منيَّتي
وأرضُ بني الإسلام يغصبها الكفرُ
ولكن إذا شاء القدير مشيئةً
فليس لها ردٌّ وليس له قهرُ
سلامٌ على الشهداء في كلِّ مشهَد
يردده التاريخ ينشده الدهرُ
سأنظمه كالطيبِ يغسل روحكم
عليكم سلامُ الله ما انهمر القطْرُ
قصيدة “كوسوفا الحزينة” للشاعر الدكتور عبد الله موسى بيلا هي نموذج بارز للشعر الإسلامي المعاصر الذي يستمد قوته من انزياحه عن الغرض التقليدي إلى فضاءات الهمِّ الإنساني والأمة الجامع. كتبت القصيدة في ذروة المأساة التي عاشها مسلمو كوسوفا على يد القوات الصربية عام 1999م، لتصبح بمثابة وثيقة أدبية تؤرخ للألم، وتستفز الضمير، وتحاول تشريح أسباب السقوط. ليست القصيدة مجرد رثاء، بل هي خطاب نقدي داخلي مرير، وقصيدة دعوية تحمل همَّ الأمة، وتخلط بين الحزن والغضب، والتفجع والتقريع.
التفكيك والتحليل النقدي للأبيات
1. الاستفتاح الاستنكاري (من البيت 1 إلى 3):
يبدأ الشاعر حواراً درامياً مع “كوسوفا”، ليس بوصف مأساتها، بل باستنطاق ماضيها عبر سلسلة من الأسئلة البلاغية الاستنكارية التي تحمل في طياتها جوابها:
كوسوفَا هل من قبلُ أسعدك الدهرُ؟
وهل كنتِ بستاناً يسيل به النهرُ؟
يستخدم الشاعر استعارات مضيئة (بستان، نهر، طفل ضاحك) لرسم صورة جنة مفقودة، وهي صورة تزيد من فداحة الواقع الحالي بالتقابل. هذا الاسترجاع (الفلاش باك) الأدبي يخلق مفارقة مؤلمة ويجذب تعاطف القارئ منذ اللحظة الأولى.
2. تشخيص الجناة والجريمة (البيت 4):
فما كنت إلا روضةً مطمئنةً
فزمجر في آفاقها الصربُ والفقرُ
هنا يقدم الشاعر الجناة: “الصربُ والفقرُ”. إن جمع “الصرب” (كقوة عسكرية) مع “الفقر” (كحالة اقتصادية) يشير إلى أن القمع مزدوج: عسكري واقتصادي. كلمة “زمجر” التي تُنسب عادة للوحوش أو العواصف، تُستخدم هنا لوصف الصرب، مما يؤكد على همجيتهم ووحشية فعلهم.
3. التحول إلى الجوهر النقدي: سؤال الأمة عن نفسها (من البيت 5 إلى 12):
هذا هو القلب النابض في القصيدة، حيث ينتقل الشاعر من رثاء الضحية إلى نقد الذات الإسلامية.
فماذا جنى الإسلام حتى تواطؤوا
عليه، فما يُخشى وليس له أمرُ
يوجه سؤالاً استنكارياً يلامس جوهر الأزمة: لماذا أصبح الإسلام ضعيفاً لا يُخشى؟ ثم يتخيل الشاعر الإسلام كشخصية حزينة تندب حظها وتلطم وجهها، وهي استعارة بالغة القوة تظهر مدى الإهانة والانتكاسة.
فقلت له: كفكف دموعك … إنَّما
صخور البوادي لا يُحرِّكها النقرُ
الحلقة الأكثر إيلاماً هي حوار الشاعر مع “الإسلام” الشخصي. نصحه “بكف الدموع” ليس قسوة، بل إقرار بحقيقة مريرة: أن البكاء لا يفيد أمام قسوة (“صخور”) العالم الذي لا يتحرك إلا للقوة. هذه إدانة ضمنية للضعف والتراجع الحضاري.
فلو كان للإسلام عزٌّ ومنعةٌ
لما هان يوماً أو تمالكه الذُعرُ
…
وما هان دينُ الله بل هان أهله
وذلُّوا … فما يغني المَقامُ ولا الذِكرُ
هذه هي الفكرة المركزية للقصيدة. الشاعر يرفض بشكل قاطع أن يكون الدين نفسه هو سبب الهوان، بل يحمل المسؤولية كاملة لأهله. إنه تشخيص دقيق: المرض ليس في العقيدة، بل في حامليها الذين تخلوا عن شروط التمكين (العز والمنعة) فذلوا. “ما يغني المقام ولا الذكر” هي إشارة لاذعة إلى أن التغني بماضي الأمة المجيد دون فعل حقيقي في الحاضر أصبح عديم الجدوى.
4. العودة إلى الواقع المأساوي (من البيت 13 إلى 20):
يعود الشاعر لوصف الفظائع باستفاضة، ولكن بعد أن زود القارئ بالإطار التحليلي (ضعف الأمة) الذي يجعل هذه الفظائع نتيجة متوقعة وليس حدثاً مفاجئاً.
فقد عاث فينا الصرب سراً وجهرةً
ومُكِّن منَّا الظُلم والبطشُ والأسرُ
كلمة “مُكِّن” ثقيلة الدلالة، فهي تشير إلى أن الصرب لم يفعلوا هذا بقوتهم فقط، بل بضعفنا واستسلامنا الذي مكنهم منا.
يصف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً: الثكالى والأطفال، ثم ينتقل إلى انتهاك العرض، وهو ما يمس شرف الأمة بأسرها.
ومن لوليدٍ فاض من عينه الجمرُ
فكيف لهم أن يهتكوا عرضَ غادةٍ
استخدام “الجمر” بدلاً من “الدمع” استعارة مروعة توضح أن دموع الطفل ليست ماءً بل ناراً وحريقاً، تعبيراً عن الألم الذي يفوق الوصف.
5. الخاتمة: بين اليأس والأمل، والتسليم والقنوت (من البيت 21 إلى النهاية):
يعود الشاعر إلى صوت الجماعة المنكوبة، فيعلن نفاد الصبر ويشكو إلى الله، وهو ملاذ المظلومين عندما تقع الحيلولة البشرية.
إلى الله نشكو ما ألمَّ بحالنا
ونسأله فتحاً فقد نَفِدَ الصبرُ
يختم الشاعر بمزيج من الحزن على ذل الأمة وتسليم الأمر لله، ثم يختتم القصيدة بسلام على الشهداء، معطياً إياهم البعد الخالد في تاريخ الأمة.
سلامٌ على الشهداء في كلِّ مشهَد
يردده التاريخ ينشده الدهرُ
سأنظمه كالطيبِ يغسل روحكم
هنا يتحول الشاعر إلى دور الكاهن الذي يقدم المراثي والصلوات، معبراً عن أن الشعر هو آخر ما يمكن تقديمه في مواجهة المأساة: كطيب يغسل أرواح الشهداء ويكرمهم.
أبرز السمات الأسلوبية
1. الحوار الدرامي: وظف الشاعر الحوار بشكل مكثف: حوار مع كوسوفا، ثم مع الإسلام المُجسَّد، مما جعل القصيدة حية ومؤثرة وكسر حدة المونولوج.
2. الاستفهام الإنكاري: سيل من الأسئلة البلاغية في المطلع لخلق حالة من التأسف والاستنكار واستفزاز المشاعر.
3. التشخيص: شخصّن الإسلام وكوسوفا، مما منح المعاني المجردة بعداً إنسانياً وعاطفياً عميقاً يسهل على القارئ التعاطف معه.
4. المفارقة: المقابلة الصارخة بين ماضي كوسوفا (“روضة مطمئنة”) وحاضرها (“زمجر… الصرب”) لتعظيم أثر المأساة.
5. الاستعارة المكنية والتصريحية: “يهون على كتمانها الموت والقبرُ” (الموت والقبر مُكنى عنهما بشيء يمكن كتمانه)، “فاض من عينه الجمرُ” (استعارة تصريحية حيث حلت “الجمر” محل “الدموع”).
6. الإيقاع والقافية: اعتمد على بحر الطويل ذي الوقع المهيب الذي يناسب رثاء الملاحم والمصائب الكبرى، مع التزام بقافية موحدة (الراء المضمومة) مما أعطى القصيدة انسيابية موسيقية ووحدة عضوية.
الفكرة المركزية
الفكرة المركزية للقصيدة تتجاوز رثاء مأساة كوسوفا إلى تشريح أزمة الضعف والهوان في جسد الأمة الإسلامية. الشاعر يقدم حجته بأن المأساة ليست حدثاً طارئاً بل هي نتيجة حتمية لتراجع المسلمين عن شروط القوة والعزة التي يقدمها دينهم، وأن العدو الخارجي (“الصرب”) ما هو إلا أداة عقاب لمجتمع تقاعس عن واجباته. القصيدة هي نداء استفزازي للأمة لمراجعة نفسها قبل أن تبكي على ضحاياها.
التقييم الأدبي والسياسي
• التأثير الأدبي: تقف القصيدة كواحدة من أبرز القصائد التي تناولت قضية كوسوفا، حيث نجحت في تحويل حدث إخباري إلى خطاب إنساني عميق. لقد تجاوزت حدود “شعر المناسبات” التقليدي إلى فضاء الشعر الحماسي النقدي، الذي يجمع بين حرارة العاطفة وعمق التحليل. إنها قصيدة لا تذكرنا بماضي الأمة المجيد بل تحفر في حاضرها الأليم، مما يجعلها أكثر قسوة وضرورة.
• التأثير السياسي والجماهيري: في وقتها، كانت القصيدة سلاحاً معنوياً قوياً، حيث ساهمت في تعبئة المشاعر الإسلامية في العالم العربي والإسلامي تجاه القضية، ورفع مستوى الوعي بها. كانت جزءاً من خطاب شعبي ضخم ضغط على الحكومات للتحرك. من الناحية السياسية، تعتبر القصيدة تجسيداً لـ “قوة الضعفاء”، حيث يستخدم الشاعر الكلمة كسلاح أخير في معركة خسرتها الأمة بالسلاح. كما أنها سجلت موقفاً أدبياً لا ينسى من إبادة جماعية كادت أن تمر مرور الكرام في الإعلام العالمي.
خاتمة لـ “كوسوفا الحزينة”
“كوسوفا الحزينة” ليست مجرد قصيدة، بل هي صيحة فنية مدوية في وادٍ من الصمت. لقد نجح الدكتور عبد الله موسى بيلا في تحويل الألم الشخصي والجماعي إلى عمل فني خالد، يحمل في طياته مرثية للضحايا، وتقريعاً للأحياء، وتحليلاً لجذور الأزمة، وصلاة للشهداء. القصيدة، برغم حزنها، تظل نابضة بقوة الأمل الذي مصدره الإيمان، وبقوة النقد الذي يُعد الخطوة الأولى لأي أمل في النهوض. إنها نموذج راقٍ للشعر الملتزم الذي يرفض أن يكون ترفاً فكرياً، ويصر على أن يكون صوت الضمير والحقيقة.
الخاتمة العامة
يمثل الدكتور عبد الله موسى بيلا نموذجًا فريدًا في المشهد الثقافي العربي والإفريقي، حيث تتقاطع في تجربته الشعرية والنقدية عناصر الهوية، الذاكرة، الجسد، والمقاومة، ضمن مشروع فكري وجمالي متعدد الحقول. فهو لا يكتب من موقع الانتماء الثابت، بل من فضاء التحوّل، حيث تتحول القصيدة إلى أداة تأويل، والنقد إلى ممارسة معرفية تتجاوز التصنيف.
لقد استطاع بيلا أن يؤسس خطابًا شعريًا يتسم بالعمق الفلسفي والانفتاح الرمزي، وخطابًا نقديًا يتجاوز الحقول التقليدية، ليعيد مساءلة المفاهيم من داخل اللغة والثقافة. ومن هنا، فإن دراسة أعماله ليست مجرد قراءة في نصوص، بل هي دخول إلى مشروع متكامل، يطمح إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الذات والآخر، بين الشعر والمعرفة، وبين الهوية والتعدد.
إن عبد الله موسى بيلا، في تعدده، لا يتشتت، بل يتكامل. وفي عبوره بين الحقول، لا يفقد البوصلة، بل يعيد رسمها. ولذلك، فإن أثره في الحقول الأدبية والفكرية لا يُقاس بعدد النصوص، بل بعمق الأسئلة التي يطرحها، وبالتحولات التي يفتحها في الوعي النقدي والشعري المعاصر.
قصيدة إهداء إلى الشاعر الدكتور عبد الله موسى بيلا
(بقلم الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي)
يا شاعرًا خطَّ الحروفَ مآذنــًا
وسقى القلوبَ بشِعره تبيانــا
أنتَ الذي حملَ الرسالةَ صادقــًا
ورسمتَ كوسوفا جراحًا عانــا
يا ابنَ إفريقيا، يا روحَ مكّـــةَ
فيك التقى العِلمانِ: قدســـًا وإيمانا
كتبتَ عن أرضي دموعَ مآسِهــا
فغدوتَ في تاريخها عنوانــا
فخذْ سلامًا من كوسوفا شاكرًا
عرفانَ قلبٍ بالوفاءِ مدانــا
ولْيعلمِ الدهرُ الذي أنصتْ لهُ
أنَّ الكلمةَ تبني الشعوبَ بُنيانا
التحليل الأدبي النقدي لقصيدة الإهداء
1. البنية الشكلية والإيقاعية
• القصيدة جاءت على نَفَس كلاسيكي، متأثرة بروح القصيدة العمودية، حيث اعتمدت القافية الموحّدة (الألف الممدودة) التي منحت النص وحدة موسيقية متماسكة وانسيابية.
• الوزن العام يميل إلى البحر الكامل أو الطويل (مع بعض الانزياحات العروضية التي تُقبل في شعر الإهداء)، وهو اختيار مناسب؛ لأن قصائد الرثاء والإهداء ذات الطابع الملحمي أو الرسالي تتطلب بحورًا رصينة ذات إيقاع جهوري.
• التوازن بين الشطرين في الأبيات يرسّخ من الإيقاع التقليدي، ويمنح القصيدة وقارًا يتناسب مع مقام المهدى إليه.
2. المستوى الدلالي والرمزي
• القصيدة تُرسِّخ صورة الشاعر عبد الله بيلا كرمز جامع، يجمع بين إفريقيا ومكة، أي بين البُعد الإفريقي والانتماء الروحي الإسلامي، وهو ما يعبّر عن تعدد الهويات الثقافية التي يحملها.
• رمز كوسوفا في النص يمثل بؤرة الالتقاء بين الشاعر المهدى إليه (عبد الله بيلا) والمُهدي (بكر إسماعيل). فالقصيدة تجعل من كوسوفا جسرًا روحيًا وثقافيًا بين الطرفين.
• حضور مفردات مثل المآذن، القلوب، الرسالة، الإيمان، الجراح، العرفان، الكلمة يعكس خطابًا مُحمّلًا بالروح الدينية والوجدانية، وهو ما ينسجم مع طبيعة علاقة الاثنين بالقضايا الإسلامية الكبرى.
3. البنية الخطابية (التواصلية)
• الخطاب يتخذ صيغة المخاطبة المباشرة (أنتَ)، مما يخلق حميمية في العلاقة الشعرية بين المهدي والمهدي إليه.
• هذا الأسلوب يجمع بين الطابع الشخصي (الإهداء لشخص محدد) والطابع الجماعي (الإشارة إلى كوسوفا والأمة).
• يَظهر في النص خطاب الشكر والامتنان بشكل واضح:
o “فخذْ سلامًا من كوسوفا شاكرًا / عرفانَ قلبٍ بالوفاءِ مدانــا”
حيث ينتقل النص من الاعتراف الشخصي إلى الاعتراف الجمعي باسم شعب كوسوفا.
4. المستوى الأسلوبي (البلاغي)
• استعارات وتشخيصات بارزة:
o “خطَّ الحروف مآذنًا” → تحويل الحروف إلى مآذن، أي جعل الشعر نفسه وسيلة دعوية وروحية.
o “رسمتَ كوسوفا جراحًا عانا” → استعارة تجعل الشاعر رسامًا يوثّق الألم.
o “الكلمة تبني الشعوب بُنيانًا” → استعارة نهائية تختتم النص، مؤكدة أن الشعر ليس ترفًا بل قوة بنائية للأمم.
• المقابلة الثنائية:
o بين إفريقيا ومكة → لإبراز ازدواج الهوية.
o بين الجراح والعنوان → لتوضيح كيف يتحول الألم إلى معنى خالد عبر الشعر.
5. المستوى السياقي (التاريخي والثقافي)
• القصيدة كُتبت في سياق علاقة أكاديمية وثقافية متينة بين الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل والشاعر الدكتور عبد الله بيلا.
• تكتسب قيمتها من كونها نصًّا تكريميًا يُضاف إلى رصيد “التناص الحواري” بين مثقف من كوسوفا وشاعر من بوركينا فاسو/مكة، مما يعكس البعد العابر للحدود الذي يجمع بين الأدب والقضايا الإنسانية.
• وجود كوسوفا كرمز محوري يجعل القصيدة جزءًا من الأدب المقاوم، ويمنحها بعدًا يتجاوز الشخصي إلى السياسي-الإنساني.
6. الرؤية الفكرية (الرسالة)
• النص لا يكتفي بالامتنان، بل يطرح رؤية حول دور الكلمة والشعر في بناء الوعي الجمعي للأمم.
• الشعر عند بكر إسماعيل – في هذه القصيدة – ليس مجرد خطاب عاطفي، بل وسيلة اعتراف ووفاء وإعادة كتابة للتاريخ عبر التقدير المتبادل.
• الرسالة النهائية: الشعر قادر على أن يكون أداة توثيق، ومقاومة، وجسرًا للتواصل الحضاري.
الخلاصة
القصيدة الإهدائية من الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي إلى الشاعر الدكتور عبد الله بيلا ليست مجرد أبيات تقدير، بل هي نص تكريمي رمزي يُبرز ثلاثة مستويات:
1. المستوى الشخصي: وفاءٌ لصداقة أكاديمية وثقافية.
2. المستوى الجمعي: اعتراف بدور بيلا في نصرة قضية كوسوفا.
3. المستوى الإنساني: إعلاء شأن الكلمة بوصفها قوة بنّاءة عابرة للحدود.
ومن الناحية النقدية، فإن النص يلتزم بخصائص الشعر الكلاسيكي الإهدائي (الوحدة، القافية، الخطاب المباشر)، لكنه يتجاوزها عبر توظيف رموز كبرى (كوسوفا، مكة، إفريقيا) ليؤسس لنصٍّ مُركب يجمع بين الوفاء والرسالة الفكرية.
كاتب الدراسة:
السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية
عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر
عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر
[email protected]