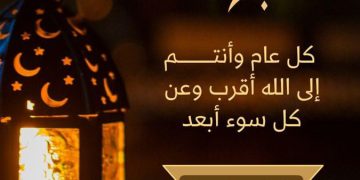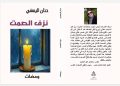الرواية بين جبرية الحياة وحضور جبرية الموت: قراءة هيرمينوطيقية فلسفية ونقدية:
بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.
تظلّ الرواية، في عمقها الأبعد، مرآةً للجدل الوجودي الذي يخوضه الإنسان مع ثنائيته الكبرى: جبرية الحياة بما تحمله من صراع الضرورات، وجبرية الموت بما تفرضه من حضور سرمدي يحاصر الوعي واللاوعي معاً. وإذا كانت الرواية الغربية قد استطاعت، منذ دوستويفسكي وكافكا مروراً ببيكيت وكامو وصولاً إلى كونديرا وماركيز، أن تُخضع النص السردي لحواريةٍ مفتوحة بين العبث والمعنى، بين الحرية والضرورة، فإن الرواية العربية كثيراً ما ظلت مشدودة إلى نزعة قدرية تستبطن الفناء وتعيد إنتاج الاستسلام بدل أن تولّد الأفق الإبداعي للحياة.
إن قراءة الرواية العربية في ضوء الهيرمينوطيقا التأويلية – النفسية والفلسفية تكشف عن مكبوتاتٍ تاريخية وأيديولوجية تراكمت بفعل الجغرافيا السياسية والاجتماعية. فالذهنية العربية، كما وصفها ابن خلدون في المقدمة، متأرجحة بين العصبية والانهزام، مما يجعل النص الروائي محكوماً بعقدة الانقياد للضرورة، أكثر مما هو متّجه إلى تفجير الحرية في وجه المصائر. وهنا يظهر التفاوت الجذري بين ما نجده عند سارتر في الغثيان أو ألبير كامو في الطاعون من نزوعٍ إلى الرفض والتمرّد، وبين ما يتكرر في كثير من النصوص العربية من حضور للموت كقدرٍ مطلق لا فكاك منه.
لقد التقط نجيب محفوظ، في ثلاثيته الشهيرة، شيئاً من هذا الوعي المتصدّع، حيث الموت لا يغيب عن تفاصيل الحياة اليومية، بل يطلّ كهاجس يُحيل حتى الفرح إلى قلق وجودي. وفي المقابل، نجد عند الطاهر بن جلون في ليلة القدر مثلاً، أن الجبرية الاجتماعية – الدينية تتحوّل إلى سلطة تعيد إنتاج الاستسلام للموت الرمزي قبل الموت الفيزيائي. بينما في الأدب الغربي، يقول ميلان كونديرا: الرواية فن اكتشاف ما لم يقله الفكر الفلسفي؛ أي إنها تتحوّل إلى أداة لفضح الحتميات لا للانصياع لها.
_ من زاوية فلسفية، يذكّرنا مارتن هايدغر في الوجود والزمان أن الوجود الإنساني هو “وجود-نحو-الموت”، لكنه ليس استسلاماً بل وعيٌ يفتح أفق الحرية. بينما يعلّمنا نيتشه في هكذا تكلم زرادشت أن تجاوز الموت لا يكون بإنكاره، بل بترسيخ إرادة الحياة في وجهه. أما عند الرواية العربية، فإن هذا الجدل لا يزال مقموعاً؛ فالموت غالباً يُستدعى كخاتمة قدريّة، لا كأفقٍ لصوغ المعنى.
هنا يطلّ السؤال النقدي: هل الرواية العربية قادرة على أن تتحوّل من خطاب استسلاميّ يكرّس جبرية الموت إلى خطاب مقاوم يستحضر حوارية الحياة؟ إن الإجابة لا تتعلق بجمالية اللغة فحسب، بل بالبنية الذهنية التي تنتج النص. فالأدب الغربي الذي تشكّل في رحم ثورات فلسفية كبرى – من ديكارت إلى هيغل ومن كانط إلى فرويد – أنتج نصوصاً تتقاطع مع الوعي النقدي والفلسفي، بينما الرواية العربية لا تزال في كثير من الأحيان حبيسة منظومات ثقافية تُعيد إنتاج الاستلاب التاريخي والقدرية المستبطنة.
ومع ذلك، ثمة محاولات مضيئة: عبد الرحمن منيف في مدن الملح مثلاً، يفضح جبرية التاريخ والاقتصاد والنفط، ويحوّل الموت من قدرٍ فردي إلى مصيرٍ جماعي يتقاطع مع بنية الاستبداد. وإبراهيم الكوني في نزيف الحجر يدمج بين أسطورة الصحراء وجبرية الموت في بعدها الكوني، محاولاً أن يصوغ منها خطاباً ميتافيزيقياً يفتح المجال للتأويل الفلسفي.
إن ما نحتاجه في النقد الروائي العربي اليوم هو توسيع الهيرمينوطيقا بحيث لا تكتفي بالكشف عن الرموز والدلالات النصيّة، بل تتوغّل في البنى النفسية والتاريخية التي تجعل الرواية العربية أسيرة حضور الموت أكثر من احتفائها بالحياة. فالرواية ليست مجرد حكاية، بل هي – كما يقول باختين – فضاء حواري للذوات واللغات والآفاق، وإذا ما تحررت من أسر الجبرية القاتلة، فإنها يمكن أن تتحوّل إلى أفق يفتح للحياة معناها، لا مجرد مرآة تعكس حتمياتها.
_ خاتمة:
إن الرواية، في جوهرها، هي التوتر الأبدي بين الحياة والموت، بين الحرية والقدر، بين أن نكتب لنحيا أو أن نكتب لنعلن استسلامنا للفناء. الرواية العربية ما زالت في مفترق الطرق: إما أن تظل أسيرة جبرية الموت، أو أن تفتح أفقها على هيرمينوطيقا الحياة، حيث الموت ليس نهاية بل أفقٌ للمعنى، وحيث الأدب يصبح مقاومة ضد الاستلاب، وإعلاناً عن كرامة الوجود الإنساني في مواجهة قدره.